|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
مجلس رقم 23 "وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا" «عسى» بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق، فإن كانت من الخالق فهي للوقوع، فقول الله تبارك وتعالى" إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا "النساء: 98 ـ 99 ، نقول: عسى هنا واقعة، وقال الله عزّ وجل"إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ *"التوبة: 18 . أما من الإنسان فهي للرجاء، كقوله: "وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي"هذه للرجاء. "أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي" أي يدلني إلى الطريق، ولهذا قال "لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا" أي هداية وتوفيقاً، وقد فعل الله، فهداه في شأن أصحاب الكهف للرشد. تفسير العثيمين يَسبِق إلى أفهام كثيرٍ من النَّاس أن الله - سبحانه وتعالى - اختَصَّ عبادَه بالهداية، وحرَم آخَرين حقًّا من حُقوقِهم، ولو أراد الله أن يهدِيَهم لهداهم، بل يحتَجُّون بالقدر لما يصدر عنهم من كفر أو معصية أو تقصير، زاعِمين أن مَشِيئة الله نافذة وغالبة، بل يحتَجُّون على تَواكُلهم وتَقصِيرهم عن الواجب وتغيير ما بأنفسهم بآيات من القرآن الكريم يقطعونها من سياقها ولا يفهمون معناها؛ من ذلك قول الله - تعالى "مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا"الكهف: 17،"وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا" السجدة: 13، وهذا مصدر خطأ كبير في فَهْمِ مسألة سبْق القضاء بالهداية والضَّلاَل، والقرآن يُوضِّح لنا ما في هذه القضيَّة من لبس حين نَعرِف أنَّ الهداية الوارِدَة في القرآن الكريم على أنواع. وهذه المسألة - مسألة الهُدَى والضَّلال - هي قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدره الله للعبد هو الهُدَى؛ فهو من أعظم النِّعَم، وأعظم ما يبتَلِيه به ويقدره عليه هو الضَّلال، وقد اتَّفقَتْ رسل الله جميعًا وكذلك كتبه المنزلة على أن الله يُضِلُّ مَن يشاء ويهدي مَن يشاء، فالهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، أمَّا طلب الهداية والسعي إليها من طلب العبد وكسبه.لذلك كان من الضروري ذكر مَراتِب الهداية كما وردَتْ في القرآن الكريم، وتتلخَّص في أربع مَراتِب، هي:1- الهداية العامَّة.2 - هداية الدلالة والبيان، والإرشاد والتعليم.3 - هداية التوفيق والمعونة. 4 - الهداية إلى الجنَّة والنَّار يوم القيامة. المرتبة الأولى: الهداية العامَّة:وهي هداية عامَّة لجميع الكائنات، فالله قد هَدَى كلَّ نفس إلى ما يُصلِح شأنها ومعاشها، وفطَرَها على جلب النافع، ودفع الضارِّ عنها، وهذه أعمُّ مَراتِب الهداية.والله - عزَّ وجلَّ - يقول:"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى" الأعلى: 1 - 3، وفيها ذَكَرَ الله أربعة أمور عامَّة وهي: الخلق، والتسوِيَة، والتقدير، والهداية، وجعَلَ التسوِيَة من تَمام الخلق، والهداية من تَمام التقدير، وبذلك تَكُون التسوِيَة والهداية كمالَيْن للخلق والتقدير؛ "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ" السجدة: 7.فالخلق والتسوِيَة يشمَل الإنسان وغيره؛"ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" البقرة: 29، "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا" الشمس: 7، ومن أمثلة ومعاني الهداية العامَّة الخاصَّة بالتسوِيَة والتقدير للمخلوقات عامَّة: الإنسان والحيوان، والطير والدوابُّ، فإن الله قد خَلَقَ الذكر والأنثى، فهَدَى الذكر للأُنثَى كيف يأتِيها، واختِلاف ذُكران الحيوان لإناثه مُختَلِف لاختِلاف الصور والخلق والهيئات، فلولا أنه - سبحانه - جعَلَ كلَّ ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى جِنسِه لما اهتَدَى لذلك، أو هَداه لِمَعاشِه ومَرعَاه، وكذلك تقديره - سبحانه - للجَنِين في الرَّحِم ثم هَداه للخُروج. وأنواع الهداية كثيرةٌ لا يُحصِيها إلا الله؛ مثل: هداية النحل إلى سلوك السُّبُل التي فيها مَراعِيها على تبايُنِها واختلافها، ثم عودها إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم؛ "وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ" النحل: 68، وكذلك هدايته - سبحانه - للنملة كيف تخرج من بيتها وتطلُب قُوتَها من هنا وهناك، وكيف خاطبَتْ أصحابها، وأمرَتْهم بأن يدخلوا مساكنهم؛ "قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ" النمل: 18.وهذه الحقيقة الكُبرَى ماثِلَة في كلِّ شيء في هذا الوجود يشهَد لها كلُّ شيء في الوجود من الكبير إلى الصغير، كلُّ شيء مُسَوى في صنعته، كامل في خلقته، مُعَدٌّ لأداء وظيفته، مُقَدَّر له غايته ووجوده، وهو مُيَسَّر لتَحقِيق هذه الغايَة من أيسر طريق، وجميع الأشياء مُجتَمِعة كاملة التناسُق مُيَسَّرة لكي تُؤَدِّي في تجمُّعها دورها الجماعي مثلما هي مُيَسَّرة فُرادَى لكي تُؤَدِّي دورها الفردي، وهذا واضح في الكون المشهود في الذرَّة المفردة والمجموعة الشمسية، كذلك بين الخلية الواحدة وأعطى الكائنات الحيَّة درجات من التنظيمات والتركيبات تدلُّ على الكمال الخلقي والتدبير والتقدير.هذه الحقيقة العميقة الشاملة لكلِّ ما في الوجود يُدرِكها الإنسان ببَصَرِه وبَصِيرته، وبعلمه وملاحظته وتجربته، ويستَطِيع البشر من خِلال العالَم المشهود أن يَتَعرَّف على تسوِيَة الله وهدايته من خلال عالَم النبات والحشرات والطيور والحيوان"مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ" الملك: 3، لكن إن وُجِدَ شيءٌ من التفاوُت وعدم التسوِيَة كالصَّمَم والعَمَى، والخرس والبكم، فهذا يَرجِع إلى عدم إرادة الخالق لهذه التسوِيَة؛ لأن التسوِيَة أمر وجودي مخلوق يَرتَبِط بمشيئة الله وإرادته مُتَعلِّق بالتأثير والإبداع.ومن هذه الآية يَتَّخِذ بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار (ت: 415هـ) دليلاً على أن الله لم يخلق الباطل لأنه مُتفاوِت، وكذلك لم يخلق الكفر والظلم؛ لأن هذا يَتَنافَى مع حُسْنِ الصنعة والإتقان، والله - تعالى - يقول "وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ" النمل: 88.وللإجابة عن هذا الفَهْمِ يتلخَّص في الآتي:1 - أنَّ القاضي عبدالجبار قد اقتَطَع الآية من سِياقها، وأخذ جزءًا منها ليستدلَّ بها على مذهبه، وغفل عن بقية الآية.2- أنَّ الآيات التي استدلَّ بها من الواضِح أنها نزلَتْ في غير أفعال العِباد، وأنَّ المقصود نفي التفاوُت عن خلق السموات السبع؛ "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا" الملك: 3، وأن الآية الأخرى - آية النمل - إنما تتحدَّث عن إتقان الجبال لا خلق الأفعال.3 - أنَّ القاضي قد ترك آيات كثيرة صريحة ومُحكَمة تدلُّ على خِلاف مذهبه؛ مثل قوله"وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ" الصافات: 96،"اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ" الزمر: 62.ومن أثر هذه الهداية الفطرية أنها قادَتْ كلَّ كائن إلى الاعتِراف برَبِّه وذكره؛ قال - تعالى - :"تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا" الإسراء: 44.وهذا النوع من الهداية - العامَّة الفطريَّة - مُقتَرِنة بالخلق في الدلالة على الربِّ - تبارَك وتعالى - وأسمائه وصفاته وتوحيده؛"قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى" طه: 50، وهذا نظير قوله: "قَدَّرَ فَهَدَى"، وهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية والوحدانية، ومن المُلاحَظ أنَّ الجمع بين الخلق والهداية العامَّة قد جاء في القرآن كثيرًا."اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"العلق: 1 - 5، "الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" الرحمن: 1 - 4، "أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ * فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ" البلد: 8 - 11،"أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ" النمل: 63.فالخلق إعطاء الوجود العيني الخارجي، والهُدَى إعطاء الوجود العلمي الذهني، فهذا خلَقَه وهذا هَدَاه وعلّمه، وكلها عامَّة فيما خلَقَه الله.المرتبة الثانية: هداية الدلالة والبيان والإرشاد:وهذا النوع هو وظيفة الرسل والكتب المنزلة من السماء، وهو خاصٌّ بالمكلَّفين، وهذه الهداية هي التي أثبَتَها لرسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم – بقوله"وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" الشورى: 52، كما أنَّ هذا النوع من الهداية أخصُّ من التي قبلها، فهي مصدر التكليف ومَناطُه، وبها تقوم حُجَّة الله على عِباده؛ فإن الله - تعالى - لا يُدخِل أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسل الذين يُبيِّنون للناس طريق الغيِّ من الرشاد: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً"الإسراء: 15، "أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" الزمر: 57، "رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا" النساء: 165، يقول ابن كثير: "أي: إنه - تعالى - أنزَلَ كتبه وأرسَلَ رسله بالبشارة والنذارة، وبيَّن ما يحبُّه ويَرضاه ممَّا يكرهه ويأباه؛ لئلاَّ يبقى لمُعتَذِر عذر؛ "وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى" طه: 134].وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - " لا أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك بعَثَ النبيِّين مُبَشِّرين ومُنذِرين".والله - تعالى - لم يمنع أحدًا هذه الهداية، ولم يَحُلْ بين أحدٍ من خلقه وبين هذه الهداية، بل خلَّى بينهم وبينها، ومَنَحَهم من الوَسائل والأدوات التي تُساعِدهم على تقبُّلها والاستِفادة بها؛ كالعقل والفطرة، وأقام لهم بذلك أسباب الهداية ظاهرة وباطنة، ومَن حرَمَه من خلقه بعضًا من هذه الأدوات والوسائل؛ كزوال العقل أو الصِّغَر أو المرض - فقد حطَّ عنه من التكاليف بحسب ما حرَمَه من ذلك؛ قال - تعالى "لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ" النور: 61، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((رُفِع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستَيقِظ، وعن الصبي حتى يَبلُغ، وعن المجنون حتى يفيق))، "رُفِعَ القلَمُ عن ثَلاثٍ ، عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكْبرَ ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقلَ أو يُفيقَ" الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3432-خلاصة حكم المحدث: صحيح.الدرر كما اتَّفق رِجال الأصول على أنه: "إذا أخَذَ ما وهب انقَطَع ما وجب".وهذه الهداية لا تستَلزِم حُصُول التوفيق واتِّباع الحقِّ من العِباد؛ بدليل أنَّ بعض الناس آمَن بدعوة الرسل وبعضهم كفر بها، ولكنَّها سبب في حصول الاهتِداء، والسبب هنا قد اكتَمَل بإرسال الرسل ووصول دعوة وبلاغ الرسل إلى أُمَمِهم، فلا نقص إذًا في السبب، إنما النقص يرجع إلى العبد الذي لم يَقبَل ولم يَنتَفِع بما جاءَتْ به الرسل بسب فساد الفطرة وطغيان المادة؛ قال - تعالى "وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" فصلت: 17، "هديناهم"؛ أي: بَيَنَّا لهم ودعوناهم، فاستحبُّوا العَمَى على الهدى؛ أي: بصَّرناهم وبيَّنَّا ووضَّحنا لهم الحقَّ على لسان نبيِّهم صالح، فخالَفُوه وكذَّبُوه وعَقَروا ناقة الله - تعالى - التي هي برهان على صدق نبيِّهم، فعدم الاهتِدَاء واقِعٌ بسبب القُصُور الحادِث في المحلِّ القابِل للأثر وهو الإنسان، وليس في قُصُور السبب، فكانت النتيجة أنْ أضلَّهم الله عقوبة على ترْك الاهتِداء وعدم الاستِجابة لما جاءَتْ به الرسل.وهذا شأن الله في كلِّ نعمة أنعَمَ بها على عباده إذا كفروا؛ فإنه يسلبها منهم بعد أن كانَتْ حظًّا لهم: "ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" الأنفال: 53، والقرآن الكريم قد قصَّ علينا ما كان من الأُمَم التي أرسل الله إليها رسلاً فلم تستَفِد بهَديِهم؛ فقال يصف حالهم في نار جهنم": كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ كَبِيرٍ" الملك: 8 - 9، فالذي حدث من الله هو الهداية، وكان من العبد التكذيب والضلال، رغم أنه كان في مَقدُورِه أن يَتَّبِع الرسول ويُؤمِن بما جاء به، وليس ذلك شيئًا خارجًا عن قدرته أو فوق طاقته، ففي مثل هذه الحالة فإن الله يُخلِّي بين العبد ونفسه، والنفس بطبعها أمَّارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا وُكِل الإنسان إلى نفسه قادَتْه إلى الهلاك، وهو بذلك يكون قد قُطِع عنه تَوفِيقُه، ولم يُرِد الله أن يُعِينَه على نفسه ليُقبِل العبد بقلبه إلى الله، وهو - سبحانه - إذا فعَل ذلك بأحدٍ من خلقه فليس ظالمًا؛ لأنه لم يسلبه حقًّا له، ولم يمنعه من الدلالة أو البيان، وهذا في مَقدُور العبد فعله، ولكنَّه حرَمَه التوفيق والسداد عدلاً منه في خلقه.المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام والمعونة:وهذه المرتبة أخصُّ من التي قبلها، فهي هداية خاصَّة تأتي بعد هداية البيان؛ تحقيقًا لقوله - تعالى "وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى" مريم: 76، فلا تكون لملك مُقرَّب ولا نبي مُرسَل، إنما هي خاصَّة بالله وحدَه، فلا يقدر عليها إلا هو، ولا يُعطِيها إلا لِمَن حقَّق شروطها واستَوفَى أسبابها."قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" المائدة: 15 - 16.وهذا النوع من الهداية هو الذي نَفَاه الله عن نبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - "إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" القصص: 56، "إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ" النحل: 37.وهذا النوع من الهداية يستَلزِم أمرَيْن:أحدهما: فعل الربِّ - تعالى - وهو الهدى بخلق الداعية إلى الفعل والمشيئة له.الثاني: فعل العبد، وهو الاهتِداء وهو نتيجة للفعل الأول "الهدى"؛ قال - تعالى - : "قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ" آل عمران: 73، "مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا" الكهف: 17، ولا سبيل إلى وجود الأثر الذي هو الاهتِداء من العبد إلا بعد وجود المؤثِّر الذي هو الهداية من الله، فإذا لم يحصل فعل الله لم يحصل فعل العبد، وهذا النَّوْعُ من الهداية لا يقدر عليه أحدٌ إلا الله - سبحانه - قال أهل الجنة: "الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله".كما أنَّ هذا النوع من الهداية هو الذي نَفَاه القرآن عن الظالمين والفاسقين والكاذبين والمسرف المرتاب، وكلُّ آية في القرآن وردَتْ في نفي الهُدَى فيجب حملها على هذا النوع؛ لأن هذا فضله يختصُّ به مَن يشاء من عباده، ولا حرج في ذلك.المرتبة الرابعة: مرتبة الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة:وهذه المرتبة - وهي آخِر مَراتِب الهداية - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط المُوصِل إليها، فمَن هُدِي في هذه الدار الدنيا إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هُدِي يوم القيامة إلى الصراط المستقيم، المُوصِل إلى جنَّته ودار ثوابه، وعلى قدر ثُبُوت قدم العبد وسَيْرِه على هذا الصراط الذي نصَبَه الله لعباده في هذه الدار الدنيا، يكون ثُبُوت قدمه وسيره على الصراط المنصوب على متْن جهنم؛ قال - تعالى "احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ"الصافات: 22 - 23، "وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ * وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ" محمد: 4- 6، فهذه هداية بعد قتلهم؛ "سَيَهْدِيهِمْ"؛ أي: إلى الجنة، وذلك يفسِّره قوله: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" يونس: 9، "وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ"؛ أي: أمرَهم وحالَهم ويَعصِمهم أيَّام حياتهم في الدنيا، "وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ"؛ أي: عرَّفهم بها وهداهم إليها.هذا، والله الموفِّق والهادي إلى سَواء السبيل، وآخِر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين. هنا هنا هنا
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
مجلس رقم 24 "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا" (25) (الكهف)لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب*, في شأن أهل الكهف - لعدم علمهم بذلك, وكان الله, عالم الغيب والشهادة, العالم بكل شيء - أخبره الله بمدة لبثهم, وأن علم ذلك, عنده وحده, فإنه من غيب السماوات والأرض, وغيبها مختص به. فما أخبر به عنها على ألسنة رسله, فهو الحق اليقين, الذي لا شك فيه. وما لا يطلع رسله عليه, فإن أحدا من الخلق, لا يعلمه. تفسير السعدي *"فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا "(22) (الكهف " فَلَا تُمَارِ " تجادل وتحاج فيهم " إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا " أي: مبنيا على العلم واليقين, ويكون أيضا فيه فائدة. تفسير السعدي "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا *". قوله تعالى" لَبِثُواْ " يعني أصحاب الكهف" فِي كَهْفِهِمْ" الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه. "ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ" تكتب اصطلاحًا ثلاثمائة مربوطة: ثلاث مربوطة بمائة، وتكتب مائة بالألف، لكن هذه الألف لا يُنطَق بها، وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدها، وهذه قاعدة صحيحة. وقوله"ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ" "ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ" بالتنوين و "ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ" تمييز مبين لثلاث مائة لأنه لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل ثلاث مائة يوم أو ثلاث مائة أسبوع أو ثلاث مائة سنة؟، فلما قال"ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ" بيَّن ذلك. "وَازْدَادُوا تِسْعًا" ازدادوا على الثلاث مائة تسع سنين فكان مكثُهم ثلاث مائة وتسع سنين، قد يقول قائل «لماذا لم يقل ثلاث مائة وتسع سنين؟». فالجواب: هذا بمعنى هذا، لكن القرآن العظيم أبلغ كتاب، فمن أجل تناسب رؤوس الآيات قال"ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا" ، وليس كما قال بعضهم بأن السنين الثلاثمائة بالشمسية وازدادوا تسعاً بالقمرية، فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا، من الذي يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى؟ حتى لو وافق أن ثلاث مائة سنين شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنين بالقمرية فلا يمكن أن نشهد على الله بهذا، لأن الحساب عند الله تعالى واحد، وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله؟ الجواب: هي الأهلَّة، ولهذا نقول: إن القول بأن «ثلاث مائة سنين» شمسية، «وازدادوا تسعًا» قمرية قول ضعيف. أولاً: لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا. ثانياً: أن عدة الشهور والسنوات عند الله بالأهلة، قال تعالى"هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ"البقرة: 189. وقال تعالى"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ" تفسير العثيمين ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيتات في الإسلام بالأهلة، ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت الشمسي في طقس واحد لا يتغير، فإنْ جاء الحج في الشتاء يظل هكذا في كل عام، وكم في هذا من مشقة على مَنْ لا يناسبهم الحج في فصل الشتاء. والأمر كذلك في الصيام. أما في التوقيت القمري فإن هذه العبادات تدور بمدار العام، فتأتي هذه العبادات مرة في الصيف، ومرة في الخريف، ومرة في الشتاء، ومرة في الربيع، فيؤدي كل إنسان هذه العبادة في الوقت الذي يناسبه؛ لذلك قالوا: يا زمن وفيك كل الزمن. والمتأمل في ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيراً من الآيات والعجائب، فلو تتبعتَ مثلاً الأذان للصلاة في ظل هذه الدورة لوجدت أن كلمة " الله أكبر " نداء دائم لا ينقطع في ليل أو نهار من مُلْك الله تعالى، وفي الوقت الذي تنادي فيه " الله أكبر " يُنادي آخر " أشهد ألا إله إلا الله " وينادي آخر " أشهد أن محمداً رسول الله " وهكذا دواليك في منظومة لا تتوقف. وكذلك في الصلاة، ففي الوقت الذي تصلي أنت الظهر، هناك آخرون يُصلّون العصر، وآخرون يُصلُّون المغرب، وآخرون يُصلّون العشاء، فلا يخلو كَوْنُ الله في لحظة من اللحظات من قائم أو راكع أو ساجد. إذن: فلفظ الأذان وأفعال الصلاة شائعة في كُلِّ أوقات الزمن، وبكُلّ ألوان العبادة.
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
مجلس رقم 25 وقوله: " أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ " تعجب من كل سمعه وبصره, وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات, بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة, فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون, الولي لعباده المؤمنين, يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى, ويجنبهم العسرى, ولهذا قال: " مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ " . أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف, بلطفه وكرمه, ولم يكلهم إلى أحد من الخلق. " وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا " وهذا يشمل الحكم الكوني القدري, والحكم الشرعي الديني, فإنه الحاكم في خلقه, قضاء وقدرا, وخلقا وتدبيرا والحاكم فيهم, بأمره ونهيه, وثوابه وعقابه.تفسير السعدي قوله تعالى"قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا" أي قل يا محمد"اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا" ، وهذه الجملة تمسك بها من يقول: إنَّ قوله: "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ"الكهف: 25. هي من قول الذين يتحدثون عن مكث أهل الكهف بالكهف وهم اليهود الذين يَدَّعون أن التوراة تدل على هذا، وعلى هذا القول يكون قوله"وَلَبِثُو" مفعولاً لقول محذوف والتقدير: «وقالوا: لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً»، ثم قال: "قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا" ولكن هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فالصواب خلافه وأن قوله"وَلَبِثُوا" من قول الله، ويكون قوله"اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا" من باب التوكيد أي: توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً، والمعنى"قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا"وقد أعلَمَنا أنهم لبثوا "ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا" وما دام الله أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. قال الله عزّ وجل"قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا *" أي له ما غاب في السموات والأرض، أو له علم غيب السموات والأرض، وكلا المعنيين حق، والسموات جمع سماء وهي سبع كما هو معروف، والأرض هي أيضاً سبع أرَضين-15، فلا يعلم الغيب ـ علم غيب السموات والأرض ـ إلاَّ الله، فلهذا من ادعى علم الغيب فهو كافر، والمراد بالغيب المستقبل، أما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمهما فليس بكافر؛ لأن هذا الشيء قد حصل وعلمه من علمه من الناس، لكن غيب المستقبل لا يكون إلاَّ لله وحده، ولهذا من أتى كاهناً يخبره عن المستقبل وصدَّقه فهو كافر بالله عزّ وجل؛ لأنه مكذب لقوله تعالى" قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ"النمل: 65 ، أما ما كان واقعًا؛ فإنه من المعلوم أنه غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين. "أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ" هذا يسميه النحويون فعل تعَجُّب. "أَبْصِرْ بِهِ" بمعنى ما أبصره. "وَأَسْمِعْ" بمعنى ما أسمعه، وهو أعلى ما يكون من الوصف، والله تبارك وتعالى يبصر كل شيء، يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، ويبصر ما لا تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق، وكذلك في السمع، يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر ويعلم الجهر "وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى *" طه: 7 . تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها زوجها، وجاءت تشتكي إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم وكانت عائشة في الحجرة، والحجرة صغيرة كما هو معروف، وكان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم يحاور المرأة وعائشة يخفى عليها بعض الحديث، والله عزّ وجل يقول"قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ"المجادلة: 1 . تقول عائشة رضي الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفى عليَّ بعض حديثها»، "الحمدُ للَّهِ الَّذي وسِعَ سمعُهُ الأصواتَ ، لقد جاءَت خَولةُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، تشكو زوجَها ، فَكانَ يَخفَى عليَّ كلامُها فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ " قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا الآيةَ" الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3460-خلاصة حكم المحدث: صحيح الدرر السنية والله عزّ وجل فوق كل شيء، ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها للرسول صلّى الله عليه وسلّم، وفيه الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء ، والإيمان بذلك يقتضي للإنسان ألا يُري ربَّه ما يكرهه ولا يُسمعه ما يكرهه؛ لأنك إن عملت أي عمل رآه وإن قلت أي قول سمعه، وهذا يوجب أن تخشى الله عزّ وجل وألا تفعل فعلاً يكرهه ولا تقول قولاً يكرهه الله عزّ وجل، لكن الإيمان ضعيف، فتجد الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل؛ لا يخطر بباله أن الله يسمعه أو يراه إلاَّ إذا نُبِّه، والغفلة كثيرة، فيجب علينا جميعاً أن ننتبه لهذه القضية العظيمة. "مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ" قوله"مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ" هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو على من هم في السموات والأرض؟ الجواب: الثاني هو المتعين، يعني ليس لأحد ولي من دون الله، حتى الكفار وليهم الله عزّ وجل وحتى المؤمنون وليهم الله عزّ وجل قال الله تعالى" وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ * ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ "الأنعام: 61 ـ 62 . والله ولي كُلِّ أحد، وهذه هي الولاية العامة ، أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر لهم ما في السموات والأرض، وسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار؟! هذه ولاية، ويتولى المؤمنين أيضاً بذلك؛ لكن هذه ولاية عامة. أما الولاية الخاصة، فهي للمؤمنين. قال تعالى"اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ"البقرة: 257 ، والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، أن الله يسدد العبد فيفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح، ولهذا قال"يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ". يخرجهم بالعلم، فيعلمهم أولاً ويخرجهم ثانياً بالتوفيق. إعراب الجملة هذه"مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ" نافية، و "مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ" خبر مقدم، و "مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ" مبتدأ مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجر الزائد لأنك لو حذفت "مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ" وقلت: «ما لهم من دونه وليٌّ» لاستقام الكلام، لكن جاءت "مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ" من أجل التوكيد والتنصيص على العموم، يعني: لا يمكن أن يوجد لأهل السموات والأرض ولي سوى الله. قوله"وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا" هذه كقوله تعالى"إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ"الأنعام: 57 ، وقال"وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ"الشورى: 10 ، والحكم كوني وشرعي، فالخلق والتدبير حكم كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي حكم شرعي، وقوله"وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا" يشمل النوعين. فلا أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا الشرعي، وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرعي، وأنه ليس لنا أن نُشَرِّع في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات، وأما من قال: إن لنا أن نُشَرِّع في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل: لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه الكسب ولو كان باطلا، فالشرع صالح في كل زمان ومكان ولن يُصلحَ آخر هذه الأمة إلاَّ ما أصلح أولها -17، الحكم الكوني لا أحد يُشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذا، هل يستطيع أحد أن يُنَزِّل الغيث؟! وهل يستطيع أحد أن يُمسك السموات والأرض أن تزولا؟! ولكن الحكم الشرعي هو محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب. تفسير العثيمين
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
"مَنْ أَتَى كاهِنًا فصدَّقَهُ بما يَقولُ فقدْ كفرَ بما أُنزِلَ علَى محمَّدٍ"
الراوي: أبو هريرة - المحدث: الألباني - المصدر: النصيحة - الصفحة أو الرقم: 164-خلاصة حكم المحدث: صحيح الدرر السنية "من أخذ من الأرضِ شيئًا بغيرِ حقِّه ، خُسِفَ به يومَ القيامةِ إلى سبعِ أرضين" الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2454-خلاصة حكم المحدث: صحيح. الدرر السنية حديثٌ إِنَّ زينبَ بنتَ جحشٍ كانتْ تفخرُ على أزواجِ النبيِّ تقولُ : زوَّجَكُنَّ أهاليكُنَّ ، وزوَّجَنِي اللهُ من فوقِ سبعِ سماواتٍ . وفي لفظٍ : كانتْ تقولُ : إِنَّ اللهَ أنكَحَني في السماءِ الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: مختصر العلو - الصفحة أو الرقم: 6-خلاصة حكم المحدث: صحيح "نزلَت هذهِ الآيةُ في زينبَ بنتِ جحشٍ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا قالَ فَكانت تفخَرُ علَى أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تقولُ زوجُكُنَّ أهْلوكُنَّ وزوَّجَنيَ اللَّهُ من فوقِ سبعِ سماواتٍ" الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3213-خلاصة حكم المحدث: صحيح الدرر السنية الحمدُ للَّهِ الَّذي وسِعَ سمعُهُ الأصواتَ ، لقد جاءتِ المُجادِلةُ إلَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، وأَنا في ناحيةِ البَيتِ ، تَشكُو زوجَها ، وما أسمَعُ ما تَقولُ ، فأُنزِلَ اللَّهُ : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 156 -خلاصة حكم المحدث: صحيح الحمدُ للَّهِ الَّذي وسِعَ سمعُهُ الأصواتَ ، لقد جاءَت خَولةُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، تشكو زوجَها ، فَكانَ يَخفَى عليَّ كلامُها فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا الآيةَ الراوي: - عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3460-خلاصة حكم المحدث: صحيح الدرر السنية
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
الولي .أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) (الشورى) "وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ج وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) (الشورى) وَهُوَ الْوَلِيّ الْحَمِيد " أَيْ هُوَ الْمُتَصَرِّف لِخَلْقِهِ بِمَا يَنْفَعهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَهُوَ الْمَحْمُود الْعَاقِبَة فِي جَمِيع مَا يُقَدِّرهُ وَيَفْعَلهُ.تفسير ابن كثير *"ألا أُحدِّثُكم إلا ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ حدَّثنا به ويأمُرنا أن نقولَ اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ والجبنِ والبخلِ والهَرَمِ وعذابِ القبرِ اللَّهمَّ آتِ نفسي تقواها وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها أنت وَلِيُّها ومولاها ، اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من نفسٍ لا تشبعُ ، ومن قلبٍ لا يخشعُ ، ومن علمٍ لا ينفعُ ، ودعوةٍ لا تُستجابُ" الراوي: زيد بن أرقم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 5553-خلاصة حكم المحدث: صحيحالدرر السنية "لَقِينا المشركين يومئذٍ ، وأجلَسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم جيشًا مِن الرماةِ ، وأمَّرَ عليهم عبدُ الله ، وقال : لا تَبرَحوا ، إن رأيتمونا ظهرَنا عليهم فلا تَبرَحوا ، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينونا . فلما لَقِيناهم هربوا حتى رأيتُ النساءَ يَشتَدِدْنَ في الجبلِ ، رفعْنَ عن سُوقِهنَّ ، قد بدَتْ خلاخلُهنَّ ، فأخذوا يقولون : الغنيمةَ الغنيمةَ .فقال عبدُ اللهِ : عَهِدَ إلىَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم -أن لا تَبرَحوا . فأبوا ، فلما أبَوْا صُرِفَتْ وجوهُم ، فأُصِيبَ سبعون قتيلًا ، وأَشَرَفَ أبو سفيانَ، فقال : أفي القومِ محمدٌ ؟ فقال : لا تجيبوه . فقال : أفي القومِ ابنُ أبي قُحافَةَ ؟ قال : لا تجيبوه . فقال : أفي القوم ابنُ الخطابِ ؟ فقال إن هؤلاء قتلوا ، فلو كانوا أحياءَ لأجابوا ، فلم يَملِكْ عمرُ نفسَه ، فقال : كذبتُ يا عدوَّ اللهِ ، أبقى اللهُ عليك ما يُخْزِيك . قال أبو سفيإن : اعْلُ هُبَلُ ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : أجيبوه . قالوا : ما نقولُ ؟ قال : قولوا : اللهُ أعلى وأجلُّ . قال أبو سفيانَ: لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم . قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أجيبوه . قالوا : ما نقولُ ؟ قال : قولوا : اللهُ مولانا ولا مولى لكم . قال أبو سفيان : يومٌ بيومِ بدرٍ ، والحربُ سِجَالٌ ، وتجدون مُثْلَةً ، لم آمرْ بها ولم تَسؤْني ". الراوي: البراء بن عازب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4043خلاصة حكم المحدث: صحيح. والمولى سبحانه هو من يركن إليه الموحدون ويعتمد عليه المؤمنون في الشدة والرخاء والسراء والضراء ولذلك خص الولاية هنا بالمؤمنين، قال تعالى" ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ "محمد:11، وقال تعالى: " وَإِنْ تَوَلوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ"الأنفال:40، وقال" قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ " التوبة:51، والله جعل ولايته للموحدين مشروطة بالاستجابة لأمره، والعمل في طاعته وقربه، والسعي إلى مرضاته وحبه، فمن حديث أَبِي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ التِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ التِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. اسم الله المولى يدل على ذات الله وعلى صفة الولاية الخاصة بدلالة المطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، فالولاية التي دل عليها اسمه المولى تكون لبعض خلقه دون بعض كما قال تعالى" الله وَلِيُّ الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "البقرة:257.واسم الله المولى يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والعدل والحكمة والعزة والرحمة والسيادة والأحدية والغنى والصمدية، وغير ذلك من أوصاف الكمال، هنا فالولي في اللغة ضد العدو، ومعناه في أَسماء الله تعالى: الناصِرُ، وقيل: المُتَوَلِّي لأُمور العالم والخلائق القائمُ بها، الذي ينصر أولياءه ويليهم بإحسانه وفضله، جاء في شرح أسماء الله الحسنى: وولاية الله لعباده تعني قربه منهم، فهو أقرب إليهم من حبل الوريد، وهي الولاية العامة التي تقتضي العناية والتدبير وتصريف الأمور والمقادير.. أما الولاية الخاصة: فهي ولايته للمؤمنين وقربه منهم، وهي ولاية حفظ ومحبة ونصرة.. قال تعالى: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ "سورة يونس، الآية: 63. وقد ورد اسم الولي ـ مطلقا غير معرف ب أل ـ في كثير من نصوص الوحي من القرآن والسنة، وورد بالتعريف ـ ب أل ـ في القرآن الكريم مرتين فقط في سورة الشورى، وهما قول لله تعالى: فالله هو الولي "وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير" سورة الشورى الآية:9. وقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته "وهو الولي الحميد" "سورة الشورى الآية: 28. هنا
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
"وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا" 27 الكهف.
ولما أخبر أنه تعالى, له غيب السماوات والأرض, فليس لمخلوق إليها طريق, إلا عن الطريق التي يخبِـر بها عباده, ولماكان هذا القرآن, قد اشتمل على كثير من الغيوب, أمر تعالى بالإقبال عليه فقال: " واتل " إلى قوله " ملتحد " . التلاوة, هي الاتباع أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها, وتصديق أخباره, وامتثال أوامره ونواهيه, فإنه الكتاب الجليل, الذي لا مبدل لكلماته, أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها, وبلوغها من الحسن, فوق كل غاية "وَتَمَّت، كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ " .سورة الأنعام رقم الآية 115 فلكمالها, استحال عليها التغيير والتبديل. فلو كانت ناقصة, لعرض لها ذلك, أو شيء منه. وفي هذا, تعظيم للقرآن, في ضمنه, الترغيب على الإقبال عليه. " وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا " أي: لن تجد من دون ربك, ملجأ تلجأ إليه, ولا معاذا تعوذ به. فإذا تعين أنه وحده, الملجأ في كل الأمور, تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه, في السراء والضراء, المفتقر إليه في جميع الأحوال, المسئول في جميع المطالب. تفسير السعدي قوله تعالى"وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ" هذا كالنتيجة لقوله"وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا" يعني إذا كان لا يشرك في حكمه أحداً فاتْلُ"وَاتْلُ". فقوله"وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ" يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية، أمّا التلاوة اللفظية فظاهر، تقول: «فلان تلا علي سورة الفاتحة»، والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت به فقد تلوتَه أي تَبعتَه، ولهذا نقول في قوله تعالى"إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ"فاطر: 29 ، يشمل التلاوة اللفظية والحكمية، والخطاب في قوله"وَاتْلُ" للرسول صلّى الله عليه وسلّم، ولكن اعلم أن الخطاب للرسول صلّى الله عليه وسلّم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما دلَّ الدليل على أنه خاص به، فهو خاص به. الثاني: ما دلَّ الدليل أنه للعموم، فهو للعموم. الثالث: ما يحتمل الأمرين، فقيل: إنه عام، وقيل: إنه خاص، وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب، ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها. فمثال الأول الذي دلَّ الدليل على أنه خاص به، قوله تبارك وتعالى"أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *"الشرح: 1. فهذا لا شك أنه خاص به، وكذلك قوله تعالى" أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى "الضحى: 6 ، فهو خاص به صلّى الله عليه وسلّم. ومثال الثاني الذي دلَّ الدليل على أنه عام، قوله تعالى: "يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ"الطلاق: 1 ، فقوله"طَلَّقْتُمُ" للجماعة؛ وهم الأمة، لكن الله سبحانه وتعالى نادى زعيمها ورسولها لأنهم تابعون له فقال"يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ"، إذاً الخطاب يشمل النبي صلّى الله عليه وسلّم وجميع الأمة، ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية"وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ"، لكن قد يقول قائل: إن هذه الآية فيها قرينة قد تدل على أنه خاص به كما سنذكره إن شاء الله، ولكن الأمثلة على هذا كثيرة، والصواب أن الخطاب للأمة ولكن وُجِّه لزعيمها وأسوتها؛ لأن الخطابات إنما توجه للرؤساء والمتبوعين. وقوله"مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ" هو القرآن، وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به. وقوله"وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا" يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته، لا الكونية ولا الشرعية، أما الكونية فواضح، لا أحد يستطيع أن يُبَدِّلها، فإذا قال الله تعالى"كُنْ" في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله، أما الشرعية فلا أحد يستطيع شرعاً أن يبدلها. والنفي هنا ليس نفياً للوجود، ولكن النفي هنا للإمكان الشرعي، فلا أحد يستطيع شرعًا أن يبدل كلمات الله الشرعية، فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله، فلو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فإن الله أشار إلى هذا في قوله في الأعراب، قال تعالى"يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ"الفتح: 15 . قلنا: هذا تبديل شرعي، والتبديل الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مواضعه، ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله، ومن ذلك جميع المعطِّلة لصفات الله عزّ وجل، أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. "وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا" يعني لن تجد أيها النبي من دون الله عزّ وجل ملتحداً، أي أحداً تميل إليه أو تلجأ إليه لأن الالتحاد من اللحد وهو الميل، يعني لو أرادك أحد بسوء ما وجدت أحداً يمنعك دون الله عزّ وجل، إذاً عندما يصيب الإنسان شيء يتضرر به أو يخاف منه، يلتجئ إلى من؟ إلى الله، ونظير هذه الآية قوله تعالى" قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا "الجن: 21، 22 . تفسير العثيمين التلاوة: هي الاتباع، أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها، وتصديق أخباره، وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل، الذي لا مبدل لكلماته، أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها، وبلوغها من الحسن فوق كل غاية {وَتَمَّت، كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ " .سورة الأنعام رقم الآية 115 . فلتمامها، استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة، لعرض لها ذلك أو شيء منه، وفي هذا تعظيم للقرآن، في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه. " وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا " أي: لن تجد من دون ربك، ملجأ تلجأ إليه، ولا معاذا تعوذ به، فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه، في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسئول في جميع المطالب هنا
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
"وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا *".28 الكهف
يأمر تعالى نبيه محمدا, صلى الله عليه وسلم, وغيره أسوته, في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين " الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ " أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها. ففيها الأمر, بصحبة الأخيار, ومجاهدة النفس على صحبتهم, ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد, ما لا يحصى. " وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ " أي: لا تجاوزهم بصرك, وترفع عنهم نظرك. " تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " فإن هذا ضار غير نافع, وقاطع عن المصالح الدينية. فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا, فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب, الرغبة في الآخرة, فإن زينة الدنيا, تروق للناظر, وتسحر القلب, فيغفل القلب عن ذكر الله, ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته, وينفرط أمره, فيخسر الخسارة الأبدية, والندامة السرمدية ولهذا قال: " وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا " غفل عن الله, فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. " وَاتَّبَعَ هَوَاهُ " أي: صار تبعا لهواه, حيث ما اشتهت نفسه فعله, وسعى في إدراكه, ولو كان فيه هلاكه وخسرانه, فهو قد اتخذ إلهه هواه كما قال تعالى: " أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم " الآية. " وَكَانَ أَمْرُهُ " أي: مصالح دينه ودنياه " فُرُطًا " أي: ضائعة معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته, لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به, ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية, على أن الذي ينبغي أن يطاع, ويكون إماما للناس, من امتلأ قلبه بمحبة الله, وفاض ذلك على لسانه, فلهج بذكر الله, واتبع مراضي ربه, فقدمها على هواه, فحفظ بذلك ما حظ من وقته, وصلحت أحواله, واستقامت أفعاله, ودعا الناس إلى ما من الله به عليه. فحقيق بذلك, أن يتبع ويجعل إمامًا. والصبر, المذكور في هذه الآية, هو الصبر على طاعة الله, الذي هو أعلى أنواع الصبر, وبتمامه يتم باقي الأقسام. وفي الآية, استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار, لأن الله مدحهم بفعله. وكل فعل مدح الله فاعله, دل ذلك على أن الله يحبه, وإذا كان يحبه فإنه يأمر به, ويرغب فيه. تفسير السعدي قوله تعالى" وَاصْبِرْ نَفْسَكَ " أي احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة، اجلس إليهم وقوِّ عزائمهم. وقوله" بِالْغَدَاةِ " أي أول النهار. وقوله"وَالْعَشِيِّ" آخر النهار. قوله"يُرِيدُونَ وَجْهَهُ" مخلصين لله عزّ وجل يريدون وجهه ولا يريدون شيئاً من الدنيا، يعني أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحدٍ سواه. وفي الآية إثبات الوجه لله تعالى ، وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، قال الله تعالى"وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ *"الرحمن: 27 . وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أعوذ بوجهك» [*]، وأجمع سلف الأمة وأئمتُها على ثبوت الوجه لله عزّ وجل. * لما نزلت هذه الآيةُ "قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ" . قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " أعوذُ بوجهِكَ " . فقال"أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ " . فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" أعوذُ بوجهِكَ " . قال " أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا " . فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هذا أيْسَرُ . الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7406- خلاصة حكم المحدث: صحيح. الدرر السنية "قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ" الأنعام 65 ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلاً لأوجه المخلوقين؟ الجواب: لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلاً لأوجه المخلوقين لقوله تعالى"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" الشورى: 11 . وقوله تعالى"رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا " مريم: 65 ، أي شبيهًا ونظيرًا، وقال الله تبارك وتعالى "فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"البقرة: 22 . وهكذا كل ما وصف الله به نَفْسَهُ فالواجب علينا أن نجريه على ظاهره، ولكن بدون تمثيل، فإن قال قائل: إذا أثبتّ لله وجهًا لزم من ذلك التمثيل، ونحمل قوله"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"الشورى: 11 ، يعني إلاَّ في ما أثبته كالوجه واليدين؟ فالجواب: أن هذا مكابرة؛ لأننا نعلم حساً وعقلاً أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء، أليس للإنسان وجه، وللجَمَلِ وجه، وللحصان وجه وللفيل وجه؟ بلى، وهل هذه الأوجه متماثلة؟ لا؛ أبداً! بل تناسب ما أضيفت إليه، بل إن الوقت والزمن له وجه، كما في قوله تعالى: "آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ"آل عمران: 72 ، فأثبت أن للزمن وجهاً، فهل يمكن لأحد أن يقول: إن وجه النهار مثل وجه الإنسان؟. الجواب: لا يمكن، إذاً ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا يمكن أن يكون مماثلاً لأوجه المخلوقين؛ لأن كل صفة تناسب الموصوف . فإن قال قائل: إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته» 19، فما الجواب؟ فالجواب: من أحد وجهين: الوجه الأول: إما أن يقال: لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلاً له، والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أخبر بأن أوَّل زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 20، ونحن نعلم أنه ليس هناك مماثلة بين هؤلاء والقمر، لكن على صورة القمر من حيث العموم إضاءةً وابتهاجاً ونورًا. الوجه الثاني: أن يقال: «على صورته» أي على الصورة التي اختارها الله عزّ وجل، فإضافة صورة الآدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم كما في قوله تعالى"وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ"البقرة: 114 ، ومن المعلوم أن الله ليس يصلي في المساجد، لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم وعلى أنها إنما بنيت لطاعة الله، وكقول صالح عليه السلام لقومه"نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا"الشمس: 13] ، ومن المعلوم أن هذه الناقة ليست لله كما تكون للآدمي يركبها؛ لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، فيكون «خلق آدم على صورته» أو «على صورة الرحمن»21 ، يعني على الصورة التي اختارها من بين سائر المخلوقات، قال الله تعالى في سورة الانفطار: " يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ "الانفطار: 6، 7 ، أي الذي جعلك جعلا كهذا وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة، ففهمنا الآن والحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين . وقوله"يُرِيدُونَ وَجْهَهُ" إشارة للإخلاص، فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل. وقوله"وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" يعني لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة الدنيا، بل اجعل نظرك إليهم دائماً وصحبتك لهم دائماً، وفي قوله"تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" إشارة إلى أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم لو فارقهم لمصلحة دينية لم يدخل هذا في النهي. قال تعالى"وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا" يعني عن ذكره إيَّانا أو عن الذكر الذي أنزلناه، فعلى الأول يكون المراد الإنسان الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه، وعلى الثاني يكون المراد الرجل الذي أغفل الله قلبه عن القرآن، فلم يرفع به رأسًا ولم ير في مخالفته بأسًا. قوله تعالى"وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا" أي ما تهواه نفسه. "وَكَانَ أَمْرُهُ" أي شأنه "فُرُطًا" أي منفرطًا عليه، ضائعًا، تمضي الأيام والليالي ولا ينتفع بشيء، وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنْزَع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فُرطا عليه ، تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئًا، ولكن لو كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. تفسير العثيمين
__________________
|
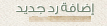 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 11:51 PM





 العرض المتطور
العرض المتطور
