|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
المجلس السابع دورة تيسير القواعد الفقهية 11 ـ النِّيةُ شَرْطٌ لِسَائرِ العَمَلْ * بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ هذه هي القاعدة الأولى ،وهي أُولَى القواعد الخمس الكبرى. النِّيةُ في اللغة: القصد. وفي الاصطلاح هي: قصد العمل ابتغاء وجه الله عز وجل - أي الإخلاص-. فالنِّيةُ مرادفة للإخلاص ؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق. فالنِّيةُ : أعم مطلقًا من الإخلاص ، فتشمل نية الرياء والشرك والإخلاص وغير ذلك . والإخلاص : أخص من النية لأن معناه إخلاص النية من شوائب الشرك والرياء ، وإفراد الله بالقصد والإرادة . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 34 / بتصرف . والنِّيةُ كما قال أهل العلم : تَشْرُدُ ، فالإنسان يحتاج إلى معاهدتِها ، وعلى مجاهدة النفس من أجل تصحيحها وتنقيتها وتجريدها لله عز وجل . القواعد الفقهية ... / شرح : خالد الصقعبي / ص : 19 . وبدأ الناظم بما يتعلق فالنِّيةُ تنبيهًا للقارئ إلى استحضارِهَا وتخليصِهَا قبل البِدء بهذه القواعد .ولا شك أن التذكير بالنية لابد أن يكون في البداية لأنها شرط لقبول العمل. وقد استحب جماعة من السلف بدء المصنفات بحديث النيات لهذا المعنى ، كما فعله الإمام البخاري في صحيحه . شواهد وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدًا في الكتاب والسنة : · أما من الكتاب :فقوله تعالى " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ " .سورة البينة / آية : 5 . و قول الله عز وجل" لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ" النساء:114. فهذه الآيات ونحوها تدل على وجوب النية في جميع الأعمال ، وأن المرءَ مؤاخذٌ بما قصد قلبه . · وأما من السنة : * قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبُها أو إلى امرأةٍ ينكحُهَا فهجرته إلى ما هاجر إليه " صحيح البخاري / 1 ـ كتاب : بدء الوحي / 1 ـ باب : كيف كان بدء الوحي إلى ... / حديث رقم : 1 / ص : 9 . ويكفي أن نعلم أن هذه القاعدة بُنِيَتْ على هذا الحديث ، فمكانتها ـ أي القاعدة ، بمكانة هذا الحديث،فهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة.القواعد الفقهية ... / للسعدي / شرح خالد الصقعبي . * عن نافع بن جُبَيرِ بنِ مُطْعِم قال : حدثتني عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسَفُ بأولِهم وآخرِهم " . قالت :قلتُ : يا رسول الله كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقُهم ومَن ليس منهم ؟ . قال" يُخسفُ بأولهم وآخرِهم ثم يبعثون على نياتِهم " . صحيح البخاري . / 34 ـ كتاب : البيوع / 49 ـ باب : ما ذُكر في الأسواق / حديث رقم : 2118 / ص : 239 . شروط النية : النية يشترط لها شروط: الشرط الأول: التمييز، فالتمييز شرط لصحة النية-.فالصبي غير المميِّز لا يتمحض له قصد صحيح ، وحينئذ لا يصح اعتبار النية منه- ، والصبي الذي لم يميز لا تصح عباداته؛ لا يصح وضوءه، ولا صلاته، ولا صيامه؛ لأنه لا يعقل النية، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإنهما يصحان من الصبي الذي لم يميز وينوي عنهما وليه. الشرط الثاني: العقل، وعلى هذا فالمجنون لا تصح نيته.لأن غير العاقل لا يتمحض له قصد صحيح- الشرط الثالث: العلم بالمنوي، فلا بد أن يعرف ويعلم المنوي. الشرط الرابع : الإسلام، فالكافر لا تصح نيته- كعبادة. شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - للشيخ : خالد بن علي المشيقح - هنا- بتصرف يسير بهذا اللون. . * الشرط الخامس : ألا يأتي بمنافٍ للنية ، والمنافي للنية أمران : أ ـ القطع : يعني أن ينوي قطع العبادة ، فعلى هذا من قام يصلي ثم نوى قطع الصلاة انقطعت صلاته ، لكن من تردد في النية هل يقطع أو لا يقطع ؟ الصحيح أنها لا تنقطع ، لأن أصل النية موجود . ب ـ الرِّدة عنِ الإسلام ِ، على قول من اشترط الإسلام لصحة النية . القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . ـ محل النية والقصد : اتفق العلماء على أن القلب محل النية وموضعها . ـ وقت النية : النية المُقَارِنة ركن في العبادة ، فالأصل فيها أن تكون مُقارنة للفعلِ المَنوِيّ ، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل ، مثال ذلك : أن الشريعة جاءت بأن من نوى الصيام في الليل صح صيامه ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام .القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 23 . * فعن حفصة ؛ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا صيام لمن لم يؤرِّضْهُ من الليل " سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام / 26 ـ باب :ما جاء في فرض الصوم من الليل ، والخيار في الصوم / حديث رقم : 1700 / ص : 297 / صحيح . هذا في الفريضة،أما صيام النفل فلا يلزم فيه النية بالليل. * عن عائشة -رضي الله عنها؛ قالت : دخل عَليَّ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال " هل عندكم شيء " ؟ . فنقول : لا ، فيقول : " إني صائم " . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 71 ـ كتاب : الصيام / 26 ـ باب :ما جاء في ... / حديث رقم : 1701 / ص : 297 / حسن . فالأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته حكمًا لا حقيقة ، أما الحقيقة فظاهرًا . وأما الحكم فمثاله : كأن ينوي المكلَّف صلاة العصر ، وهو يتوضأ وضوء صلاة ولم يُحْدِث بعد هذا الوضوء ما ينافي جنس الصلاة ، ثم شرع في صلاة العصر دون حضور الذهن لنية ،فإنه ناوٍ حكمًا مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 39 . وقال الشيخ : خالد بن علي المشيقح: فوقت النية يختلف باختلاف العبادات، وفي الجملة العلماء يقولون: للنية وقتان: الوقت الأول: وقت استحباب، وذلك أن يكون مقارنًا لبدء فعل العبادة، فمثلاً إذا أردت أن تصلي الفريضة فعند تكبيرة الإحرام تنوي. الوقت الثاني: وقت الجواز، ويكون قبل العبادة بزمن يسير. وهل يشترط دخول الوقت أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط دخول الوقت، فإذا كان قبل العبادة بزمن يسير فإن هذا لا يضر. شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - للشيخ : خالد بن علي المشيقح - هنا- = فوائد النية: الفائدة الأولى: التمييز بين العبادات بعضها من بعض، يدخل أحد المسجد ويصلي ركعتين، فقد ينوي بهما تحية المسجد، وقد ينوي بهما الفريضة، أو السنة الراتبة إذا دخل قبل صلاة الفجر، فلا بد من النية حتى تميز العبادات بعضها عن بعض. الفائدة الثانية: أنها تميز العبادات عن العادات، فقد يعمم بدنه بالماء ويقصد بذلك رفع الحدث الأكبر، وقد يقصد مجرد التنظف. الفائدة الثالثة: ما يتعلق بالإخلاص، هذا يصلي ركعتين يكون مخلصًا فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعمله صحيح، وهذا يرائي في عمله.. إلى آخره، ولهذا قال لك المؤلف: بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ. الفائدة الرابعة: ما يتعلق بتداخل العبادات، هذا يصلي ركعتين عن ثلاث صلوات- نية الوضوء،وتحية المسجد،ونافلة-، وهذا يصلي ركعتين عن صلاة واحدة فقط، وكل هذا راجع إلى النية، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتداخل العبادات.شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - للشيخ : خالد بن علي المشيقح - هنا- مثاله : الطهارة شرط في صحة الصلاة ، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة ولا عدمها ،فقد يتطهر ولا يكون وقت صلاة . ويلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة . فالنية شرط . وقيل ركنٌ ، علمًا بأن كلاً من الشرط والركن فرض، لكن الشرط يكون خارجًا عن المشروط، كالطهارة شرط للصلاة خارجة عن الصلاة،والركن يكون جزءًا داخلاً في العبادة ، قال ابنُ نُجَيْم في الأشباه والنظائر: ص55 :النية شرط عندنا في كل العبادات باتفاق الأصحاب -أي الحنفية-، لا ركن، وإنما الاختلاف بينهم وقع في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل: بركنيتها. وكذلك قال الحنابلة والمالكية: النية شرط في العبادة لاركن ولو داخلها. القوانين الفقهية: ص 57، غاية المنتهى: 115/1 . وقال السيوطي في :الأشباه والنظائر: ص38 :اختلف الأصحاب - أصحاب الشافعي- هل النية ركن في العبادات أو شرط؟ فاختار الأكثرون أنها ركن؛ لأنها داخل العبادات، وذلك شأن الأركان، والشرط ما يتقدم عليها، ويجب استمراره فيها.مقتبس من الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ- أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ- هنا- والشرط والركن : يجتمعان : في انعدام صحة العمل عند عدمها . ويفترقان : في أن الركن جزءٌ من حقيقة الفعل وماهيته ، كالركوع في الصلاة . وأما الشرط فإنه خارج عن حقيقة الفعل وماهيته ، كاستقبال القبلة أثناء الصلاة . قال بعض العلماء : الركنُ ما في ذات الشيء ولجا* والشرط عن ماهيته خرجا لكن كلاهما إذا ما انعدما * انعدمت حقيقةٌ معهما . وقوله: سائر العمل: يشمل العمل القلبي والعمل البدني والقولي، فالعمل يشمل كل ما يصدر عن الإنسان، وكل ما يتحرك به ظاهرًا أو باطنًا، فكل العمل تشترط له النية، لا بد له من النية. *لِسَائرِ العَمَلْ :، النيةُ شرطٌ لكل الأعمال ؛يشمل العمل القلبي والعمل البدني والقولي، فالعمل يشمل كل ما يصدر عن الإنسان، وكل ما يتحرك به ظاهرًا أو باطنًا، فكل العمل تشترط له النية، لا بد له من النية.، وبها يُحكمُ على العمل بالصلاح أو الفساد . ويستثنى من هذا العموم أمران : * الأول : التُّرُوك ، كترك الزنا ، وترك القتل ، وترك سائر المعاصي ، فهذه التروك داخلة في الأعمال من جهة اللفظ ، لأن الترك نوع من أنواع الفعل كما قال تعالى : " كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " . سورة المائدة / آية : 79 . فسمى عدم تنهاهيم فِعْلًا . فالنية ليست شرطًا في صحة التروك ، فكل من ترك المعاصي ،فذمته بريئة من الإثم ، ولكن لا ثواب له على الترك إلا بنية الامتثال ـ أي الترك امتثالاً للنهي ـ . * الثاني : الأعمال الدنيوية المحضة : التي يحصل المقصود منها بمجرد الفعل ، ولا يتوقف على النية ، كرد المغصوبات ، والديون والأمانات إلى أهلها ، فإن المقصود هو رجوع المال إلى صاحبه ، وهذا يحصل بمجرد الردِّ ، ولا يتوقف على النية . وهذا حاصلٌ بمجرد الفعل دون توقف على نية الامتثال . يعني: إذا رد الدين حياءً أو خوفًا، فحينئذ نقول: هذا قطعًا أنه لم ينوِ الامتثال، فحينئذ إذا قيل: لم ينوِ الامتثال هل نقول بأنه لا يجزئ؟ إذًا: أعِدْ قضاء الدين مرة أخرى؟ نقول: لا. ليس هذا هو المراد، وإنما نقول: لا ثواب إلا بنية، فالعمل حينئذ مجزئ وسقط به الطلب. إذًا: الواجب قسمان: -واجب لا يصح ولا يعتد به إلا بنية، وهذه العبادات المحضة. -واجب يصح ويعتد به بدون نية لكن لا ثواب فيه إلا بنية. كتاب: شرح مختصر التحرير للفتوحي-هنا- * فعن الزهري قال : حدثني عامرُ بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، أنه أخبره أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرتَ عليها ، حتى ما تجعل في فم امرأتِك " . صحيح البخاري . متون / (2) ـ كتاب : الإيمان / (41) ـ باب : ما جاء إن الأعمال بالنية ... / حديث رقم : 56 / ص : 17 . *بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ: والناظم في هذا البيت يشير إلى القاعدة الكلية الكبرى " الأمور بمقاصدها " ، بمعنى أن تصرفات المكلَّفِ تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص ونيته فيها . مثال ذلك : من وجد مالاً مفقودًا ، فإن أخذَه بنية التملك لنفسه يكون غاصبًا ، ويلزمه الضمان عند التلف . وأما من أخذه بنية الحفظ ، وقصد التعريف ، ـ لُقَطَة ـ ، فإنه يكون أمينًا ، ولا يضمن المال عند التلف إلا بالتفريط . منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . * ثلاثة أشخاص قتلوا ثلاثة أشخاص : الأول : قتل شخصًا عمدًا وعدوانًا ، فهذا يُقتل . الثاني : شبه العمد أي أراد إيذاء المقتول لا قتله ، أو خطأ : كمن أراد يرمي صيدًا فقتل إنسانًا ، فهذا عليه كفارة . الثالث : أمر بقتل فلان من الناس حدًّا -أي أقام على شخص حد من حدود الله بالقتل ، فهذا لا شيء عليه . فالأول قَتَلَ عمدًا ؛ والثاني شبه عمد أو خطأ ؛ والثالث مأذون له في ذلك ، فصورة العمل واحدة كلها قتل ؛ لكن النتيجة والتبعية اختلفت لاختلاف النية . منظومة القواعد ... / شرح : خالد إبراهيم الصقعبي . o تنبيه : .صور التشريك في النية :ـ يجب التنبيه هنا على خطأٍ شائع بين المسلمين ، عندما تخاطب أحدهم وتأمره بعمل من أعمال الجوارح المأمور بها ، يقول " إنما الأعمال بالنيات"المهم ما وقر في القلب ! ! . وهذا فهم خاطئ للحديث ، فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل " إنما النيات بالنية " ، ولكن قال : إنما الأعمالُ بالنيات. إذًا لابد من العمل الصالح ثم النية التي تجعل العمل خالصًا لوجه الله . مثال ذلك : نهى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الصلاة في أوقات معينة وتسمى أوقات الكراهة ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوقات لعدم التشبه بغير المسلمين في عقيدتهم ، رغم عدم الشك في نيته صلى الله عليه وسلم ونية أصحابه ، فلا يصلي أحد في هذه الأوقات ويقول ليس في نيتي عقيدة هؤلاء ، فنيتي صالحة ، لا . النية لا تخرجه عن النهي السابق . فلابد أن يكون العمل صالحًا ـ أي على الكتاب والسنة ـ ، والنية صالحة وخالصة لوجه الله . نسأل الله أن يصلح أعمالنا . * الصورة الأولى : أن يدخل مع العبادة ما ليس بعبادة أصلاً . وهذه الصورة نوعين : النوع الأول : أن يدخل مع العبادة ما لا يصح إدخاله ، كالذبح لله وللولي فلان ، فهذا يُبطل العبادة . النوع الثاني : أن يُدْخِل مع العبادة ما يصح إدخاله ، كما لو اغتسل بنية الجمعة والتَّبَرّد . * الصورة الثانية : أن ينوي مع العبادة عبادة أخرى ، وهذا له أنواع : النوع الأول : أن يدخل الفريضة على فريضة ، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط ،في الحج في القِران ، أي يدخل الحج على العمرة ، فيقول " اللهم لبيك عمرة وحجًا" ، فهنا أدخل الحج على العمرة وقرنهما بنية واحدة النوع الثاني : أن ينوي مع الفريضة سنة ، هذا يجوز في بعض الصور دون بعض . وسيأتي تفصيل ذلك في قاعدة 42 : وإِنْ تَسَاوى العَمَلانِ اجْتَمَعَا** وَفُعلَ أَحَدُهمَا فَاسْتَمِعَا مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 39 .
= قلب النية: العلماء يقولون: قلب النية ينقسم إلى أقسام: القسم الأول: أن يقلب النية من معين إلى معين فهذا لا يصح، وحينئذ يبطل الأول ولا ينعقد الثاني، مثال ذلك: رجل يصلي راتبة الفجر، وهذه صلاة معينة، ثم قلبها للفريضة، هذا لا يصح، فتبطل الأولى؛ لأنه قطع نيتها الراتبة، ولم تنعقد الثانية؛ لأنه لا بد أن تكون النية من أول الصلاة، وهو ما نوى أول الصلاة بل نوى في أثنائها. القسم الثاني: أن يقلب عبادته من عبادة معينة إلى عبادة مطلقة، وهذا يصح؛ لأن العبادة المعينة اشتملت على نيتين: اشتملت على نية التعيين، ونية الإطلاق، وأبطل الآن نية التعيين، فبقيت نية الإطلاق، فمثلاً: لو كان يصلي سنةً راتبة أو فريضة، ثم قلبها إلى صلاة نفل مطلق فنقول: يصح ذلك؛ لأن هذه الصلاة اشتملت على نية التعيين ونية الإطلاق، فأبطل نية التعيين وبقيت نية الإطلاق. القسم الثالث: أن ينتقل من مطلق إلى معين، وهذا لا يصح، فلو أنه شرع في نافلة مطلقة ثم انتقل إلى نافلة معينة كسنة راتبة، نقول بأنه لا يصح.شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - للشيخ : خالد بن علي المشيقح - هنا- |
|
#2
|
||||
|
||||
|
المجلس الثامن 12 ـ الدِّينُ مَبْنيُّ على المَصَالحِ في جَلْبِهَا والدَّرْءِ للقَبَائِحِدورة تيسير القواعد الفقهية هذه القاعدة الثانية من القواعد الفقهية . الدِّينُ: الطاعة والجزاء .يطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به الجزاء والحساب. فأي المعنيين المراد هنا؟ المراد العمل؛ أي العمل العبادي في هذه الشريعة . فمن الأول ـ أي : " الطاعة " ـ : قول الشاعر : أَبَا هِنْدٍ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْنا ** وَأَنْظِرْنا نُخَبِّرْكَ الْيَقِينا أيامٍ لنا غرٍّ طوالٍ ** عصينا الملكَ فيها أن نَدِينا بأَنَّا نُورِدُ الرَّايَاتِ بِيضًا ** وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْرًا قَدْ رَوِينا لطيفة في معنى أبيات معلقة عمرو بن كلثوم : كان عمرو بن هند-ملك الحيرة- كان طاغية متجبرًا ، فقال لمن حوله : ينادي عمرو ابن كلثوم على ملك الهِند بنداء متصف بالعزة ويهدده بألا يتعجل في نظرته حتى يعلم من يخاطب ومن يوجه لهم الكلام ، ويهدد عمرو بن كلثوم بأن قبيلته قوية فهي إذا ذهبت إلى معركة تذهب الأعلام والرايات بيضاء من كثرة القتل في الأعداء ترجع حمراء ، ويخبره بأن لهم أيام مشهورة وطويلة تنبه الجميع بأننا لا نخاف أي ملك ولا ندين لأي أحد أي لانطيع أي أحد .ا.هـ .هنا=وهنا=وهنا=أتعلمون من تأنف أمه من خدمة أمي ؟ فقالوا: لا نعلم إلا ليلى بنت مُهَلْهِل ، فإن أباها مُهَلْهِلٌ بن ربيعة ، وعمها كُلَيْب ، وزوجها كلثوم ابن عَتَّابٍ فارس العرب ، وابنها عمرو بن كلثوم.فأرسل الملك إلى عمرٍو وأمِهِ يدعوهما إلى زيارتِه ، وأوعز ملك الحيرة إلى أن تستخدم أم عمرو بن هند لإذلالها. وفي أثناء الحفل طلبت أم عمرو بن هند من لَيْلَى بِنْت مُهَلْهِلِ بْنِ رَبِيعَةَ أن تناولها الإناء ، فقالت لها : لتقم صاحبة الحاجة لقضاء حاجاتها.فلما ألحت عليها صرخت وقالت واذُلَّااااااااااه !! فسمعها ابنُها عمرو بن كلثوم فثار وتناول سيفه وقتل الملك-عمرو بن هند- ،وعاد إلى الجزيرة " فالدين بهذا المعنى مأخوذ من الفعل : " دان " بمعنى : أطاع ، فمن دان لغيره ، وأطاعه فإنه قد سلَّم الدِينَ له ، ولما كان أهلُ الإيمانِ يطيعون اللهَ ـ عز وجل ـ سُميت شريعةُ اللهِ " الدينَ " . القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / ص : 24 . ومن الثاني ـ أي : " الجزاء " : قولهم : " كما تَدِين تُدانُ " ، ومنه " يومُ الدينِ " أي : يوم الجزاء وأُطلق على الشريعةِ لفظُ الدِّين لقيامها على معنى الطاعة والجزاء . منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . مَبْنيُّ على المَصَالحِ : المَصَالحِ : جمع مصلحة ، وهي المنفعة وزنًا ومعنى ،واحدها " مصلحة " . المقصود من المَصَالحِ عند الفقهاء؛ هو حفظ مقصود الشارع بالحفاظ على الكليات الخمس ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل أو العِرض ، والمال ، فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه الكليات الخمس . فإن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئنًا يعمل لدنياه وآخرتِهِ. "حفظ الدين " هو مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقات الناس بعضهم ببعض..حيث قصد الشارع بتلك الأحكام إقامة الدين وتثبيته في النفوس..وذلك باتباع أحكام شرعَهَا.. واجتناب أفعال أو أقوال نهى عنها..وبالحفاظ على الدين تتوازن أمور الدنيا والآخرة. ففرضت الصلاة كزاد يومي لحفظ الدين ، وصلاة الجمعة أطول، ففيها خطبة هي شحنة أسبوعية، والصيام شحنة ثلاثين يومًا، والحج فيه سفر، وفيه تفرغ، وفيه مناسك، وفيه إنفاق مال، والحج شحنة العمر.هنا = فكما أن العبادات من أجل حفظ الدين.كذلك حرم الشرع ونهى عما يضر نهى عن الزنا والسرقة والقتل العدوان و.... وجعل لها عقوبات رادعة . " حفظ النفس " قد عُنيت الشريعة بحفظ الأنفس المعصومة بالإسلام أو بالعهد؛ وذلك بتحريم الاعتداء عليها، وضمان ما أتلفه على سبيل الخطأ، وتجنب كل ما من شأنه إيقاع الضرر على الغير، ورد العدوان بما يناسب من وسائل الدفاع عن النفس- الألوكة "حفظ العقل "للعقل في الإسلام أهمية كبرى فهو مناط المسؤولية والتكليف ، وبه كرم الإنسان و فُضل على سائر المخلوقات، وتهيأ للقيام بالخلافة في الأرض وحمل الأمانة فلأنه مناط التكليف، حرم كل ما من شأنه إدخال الخلل عليه؛ كالخمور والمخدرات، وكالتفكير الفاسد الذي تروجه المذاهب الهدامة والنِّحَل الباطلة. الألوكة. "حفظ النسل " اختلف الأصوليون في تسميته بالنسب أو النسل ...و شرع لإيجاده الزواج؛ للتوالد والتناسل، وشرع لحفظه وحمايته حد الزنا وحد القذف،فحفظ النسل يتضمن المحافظة على الفروج والأعراض وصحة الأنساب. " حفظ المال"كما هو شأن الإسلام دائمًا مع النزعات الفطرية للإنسان حيث يبيح إشباعها ويلبي مطالبها ضمن الحدود المعقولة، مع التهذيب والترشيد حتى تستقيم وتحقق الخير للإنسان ولا تعود عليه بالشر، كان هذا شأنه مع نزعة حب التملك الأصلية في الإنسان، فقد أباح الملكية الفردية، وشرع في ذات الوقت من النظم و التدابير ما يتدارك الآثار الضارة التي قد تنجم عن طغيان هذه النزعة من فقدان للتوازن الاجتماعي، وتداول للمال بين فئة قليلة من المجتمع، ومن النظم التي وضعها لأجل ذلك نظم الزكاة و الإرث و الضمان الاجتماعي، وتحريم التعاملات الربوية، ومن ثم اعتبر الإسلام المال ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية. وأوجب للحفاظ على المال؛ السعي في طلب الرزق الطيب، وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة..وللحفاظ عليه حرم السرقة والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وعاقب على ذلك. وعدم تبذير الأموال . في جَلْبِهَا: أي في تحصيلها . والدَّرْءِ: أي الدفع . للقَبَائِحِ: أي المفاسد. وملخّص هذه القاعدة: أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، هذا من جانب، وإعدام المفاسد وتقليلها.. وهذه قاعدة من القواعد الكلية التي تدخل في كثير من أبواب الفقه؛ بل هي من القواعد الكبرى التي لا يسلم منها باب من الأبواب، فهي داخلة في جميع أبواب الفقه. فبعض العلماء ، مثل العز بن عبد السلام ـ أرجَع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي :
جلب المصالح ودرء المفاسد . وقال ابنُ السبكي : بل يرجع الفقه كله إلى الجزء الأول من القاعدة، وهي : جلب المصالح " ، لأن درء المفاسد نوع من جلب المصالح . القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .بتصرف. فهذا الأصل العظيم ، والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله ، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة ، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة . ما أمر الله بشيءٍ إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف ، وما نهى عن شيءٍ إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف . قال تعالى " وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ" سورة الأعراف / آية : 157 . ومن أعظم المصالح التي أمر اللهُ بها التوحيد ، الذي هو : إفراد الله بالعبادة ، وهو مشتمل على صلاح القلوب ، وسعتها ، ونورها ، وانشراحها ، وزوال أدرانها ، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة . المَصَالحُ: مرتبتان: الإيجاد والتكثير. القَبَائِحِ : المفاسد وهي مرتبتان: الأولى الإعدام، فإذا لم يتمكن من الإعدام فالتقليل. فالشريعة في جميع ما جاءت به دائرة على هذين المعنيين: إيجاد المصالح وتكثيرها، وتقليل المفاسد وإعدامها. فالشريعة ضبطت مصالح الناس، وحصّلت مصالح الناس في معاشهم ومعادِهم، فليس فقط المصلحة التي تحصلها الشريعة هي مصلحة الآخرة. وهذه مسألة مهمة ، فإن الشريعة جاءت بما يصلح به أمر الدنيا وأمر الآخرة، فمهما بلغ الناس في تحصيل مصالح الدنيا، لا يستطيعون تحصيلها كما حصلتها الشريعة. وأما مصالح الآخرة فلا سبيل إلى تحصيلها إلا من طريق هذه الشريعة المباركة. الشيخ خالد المصلح .هنا= وأعظم ما نهى الله عنه : الشرك في عبادته ، الذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان ، والدنيا والآخرة . فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد . ومما أمر الله به : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج : الذي من فوائد هذا انشراح الصدر ونوره ، وزوال همومه وغمومه ، ونشاط البدن وخفته ، ونور الوجه ، وسعة الرزق ، والمحبة في قلوب المؤمنين ، وفي الزكاة والصدقة ، ووجوه الإحسان : زكاة النفس وتطهيرها ، وزوال الدرن عنها ، ودفع حاجة أخيه المسلم ، وزيادة بركةُ مالِه ونماؤه ، مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه ، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيءٍ ، وزوال سخطه . وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك . وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع ، كالصلوات الخمس ، والجمعة ، والأعياد ، ومشاعر الحج ، والعلم النافع ، لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل ، وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير ، وحصول التنافس في الخيرات ، واقتداء بعضهم ببعض ، وتعليم بعضهم بعضًا ، وتعلم بعضهم من بعض ، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد ، إلى غير ذلك من الحِكَم . وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة ، لما فيها من العدل ، ولحاجة الناس إليها . وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة ، لما فيها من الظلم والفساد ، وأباح الطيبات من المآكل والمشارب ، والملابس ، والمناكح ، لما فيها من مصالح الخلق ، ولحاجة الناس إليها ، ولعدم المفسدة فيها . وحرم الخبائث من : المآكل ، والمشارب ، والملابس ، والمناكح ، لما فيها من الخبث والمضرة ، عاجلاً وآجلاً ، فتحريمها حماية لعباده ، وصيانة لهم ، لا بخلاً عليهم ، بل رحمة منه بهم ، فكما أن عطاءَه رحمة ، فمنعه رحمة ، مثال ذلك : أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد : رحمة منه تعالى ، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة . لذا شرع لنا عند زيادة المطر إلى درجة نخشى منها الضر ، الدعاء بهذا " ... اللهم حوالينا ولا علينا ... " . صحيح البخاري . متون / ( 15 ) ـ كتاب : الاستقساء / ( 6 ) ـ باب : الاستقساء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة / حديث رقم : 1014 / ص : 117 . وبالجملة ، فإن أوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها ، ونواهيه داء القلوب وَكُلُومهَا ، وكذلك المواريث ، والأوقاف ، والوصايا ، وما في معناها : اشتملت كلها على غاية المصلحة والمحاسن ، فالدِين مُقام على جلب المصالح ودرء المفاسد . رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 14 / بتصرف . دليل هذه القاعدة : العموم والاستقراء . أما العموم : فمنه قوله تعالى -وذلك بدلالة اللزوم- " إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحشاءِ والمنكرِ وَالْبَغيِ " .سورة النحل / آية : 90 . وقوله سبحانه (1) " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةً لِّلْعالَمِينَ " . سورة الأنبياء / آية : 107 . فمقتضى كون هذه الشريعة رحمة أن تكون جالبة للمصلحة دافعة للمفسدة (1) . وفي تعاليل الأحكام نجد أن الشريعة عللت كثيرًا من أحكامها بمصالح الخلق كما قال ـ جل وعلا ـ" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ ". سورة البقرة / آية : 179 . فقوله : حَيَاةٌ ، هذا تعليل لهذا الحكم وهو القصاص لمصلحة الخلق ـ [ حتى لا تكون فوضى ويعم الفساد ، فإذا عُلم أن هناك قصاص ارتدع المعتدي (2) ] ـ . (2)ما بين المعكوفتين [ ] تصرف وأما الاستقراء : ـ وهو تتبُّعُ الجزئيات للوصول إلى حكم كلِّيٍّ ـ : وتتبع الأحكام والنظر في عللها وحِكَمِهَا ، دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق . منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . ـ بعد أن ذكر الناظم القاعدة الكلية في المصلحة ، بل هي من القواعد الخمس الكبرى ، بعدها انتقل إلى تفريع مبني على تلك القاعدة ، وهو تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد . وهي القواعد التالية لهذا . منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري . القواعد الفقهية ... / شرح : الشيخ خالد المصلح / بتصرف . |
|
#3
|
||||
|
||||

المجلس التاسع دورة تيسير القواعد الفقهية 13ـ فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المَصَالِحِ * يُقدَّمُ الأَعلى مِنَ المَصَالِحِ 14 ـ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ* يُرتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ أولاً ما معنى التزاحم؟ معنى التزاحم أنه يتعين فعل أحد الأمرين: لا بد من فعل أحد الأمرين، وفعل أحدهما يفوت الآخر، فتزاحم المصالح هو أن يكون عندك أمران كلاهما مصلحة؛ لكن لا يمكنك الجمع بينهما، فإذا فعلت هذا فاتك هذا، وإذا فعلت هذا فاتك هذا، أما إذا كان يمكن الجمع فهنا لا تزاحم. يقول رحمه الله: فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المَصَالِحِ : عَدَدُ : مجموعة، اثنان فأكثر، من المصالح، فما الذي يقدم؟ يقدم الأعلى من المصالح.الشيخ خالد المصلح = هنا= = أي إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، رُوعي أكبر المصلحتين وأعلاهما فَفُعِلَتْ . * فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سُنَّة ، قُدِّمَ الواجبُ على السنة لأن مصلحته أعظم . ودليل ذلك : * عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله قال :"مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ" صحيح البخاري . متون / ( 81 ) ـ كتاب : الرقاق / ( 38 ) ـ باب : التواضع / حديث رقم : 6503 / ص : 760 . وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه :فأول وأوجب ما يقدّم عند التزاحم: ما فرضه الله علينا. ـ وتطبيق هذه القاعدة :إذا أُقيمت صلاة الفريضة ، لم يجز ابتداءُ التطوع . * لحديث أبي هريرة ، فعن أبي هريرة ، عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " إذا أقيمتِ الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة " صحيح مسلم . متون / 6 ـ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها / 9 ـ باب : كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن / حديث رقم : 63 ـ 710 / ص : 171 . وكذا إذا ضاق الوقت : مثال ذلك : إذا بقي على طلوع الشمس ما يكفيك لصلاة ركعة واحدة ، فلا يجوز أن تصلي السنة القبلية وذلك لضيق الوقت ، فالمصلحة الأعلى هنا إدراك صلاة الفريضة ، في وقتها . . ـ وكذلك إذا تعارض صيام النفل للمرأة مع طاعة الزوج ، قُدمتْ طاعةُ الزوجِ ، لأنها واجبة . * فعن همَّام بن مُنَبه . قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمدٍ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فذكر أحاديث منها . وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهد إلا بإذنه ... " . صحيح مسلم . متون / 12 ـ كتاب : الزكاة / 26 ـ باب : ما أنفق العبد من مال مولاه / حديث رقم : 84 ـ 1026 / ص : 243 . = وإذا تزاحم عنده في هذا المال إما أن يتصدق به، وإما أن يقضي الدَّينَ الذي عليه، فنقول: يقضي الدَّيْنَ؛ لأن الدَّيْنَ واجب.هنا = شرح القواعد الفقهية للشيخ خالد بن علي المشيقح = * إن كانت المصلحتان واجبتين ولم يمكن الإتيان بهما ، قُدّم أوجبُهما ، فيقدم صلاة الفرض ،على صلاة النذر ، وكالنفقة اللازمة للزوجات ، والأقارب ، يقدم الأقرب فالأقرب . - وكالزوجة إذا تعارض في حقها أمر زوجها وأمر أبويها ، فتعمل بأمر الزوج 1 ، لأن طاعته آكدُ وأوجبُ - . منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . 1 هذه الطاعة للزوج مقيدة بألاّ تؤدي طاعته إلى عقوق الوالدين ، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكل هذا بمعايير الشرع المنضبطة . منظومة القواعد ... / شرح : حسين عبد العزيز آل الشيخ . مثاله أيضًا: شخص عنده دراهم، إما أن يشتري طعامًا يأكله فيحفظ نفسه، وإما أن يقضي الدَّين الذي عليه، وكل منهما واجب، لكن حفظ النفسِ أوجب من قضاء الدين، فنقول: يقدم حفظ النفس.هنا = شرح القواعد الفقهية للشيخ خالد بن علي المشيقح = * وإن كانت المصلحتان مسنونتين ، قُدم أفضلُهما ، فتقدم الراتبة -الراتبة: التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ما يدل على أنها راتبة يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، مثل سنة: الظهر والمغرب والعشاء والفجر، هذه يقال لها: رواتب؛ وسنة الجمعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها،عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ " . رواه الترمذي رقم 380 - وهو في صحيح الجامع 6362 ؛ - تقدم الراتبة على السنة :وليس لصلاة العصر سنّة راتبة ولكنّ صلاة أربع ركعات قبل فريضتها مستحبّة ولكنها دون منزلة السنن الرواتب وهذه الأربع هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا . " رواه الترمذي رقم 395 -وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 3493-. وتقدَّم السنة على النفل المطلق : وهو الذي لم يُحَدُّ بوقت محدد ولا سبب معين في الشريعة ، ويقدم ما فيه نفع متعدٍّ ، كالتعليم وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ونحوها ؛ على ما نفعه قاصر ، كصلاة النافلة ، والذكر ، ونحوهما . وتقدم الصدقة ، والبرّ للقريب على غيره . "إنَّ الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ ،وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ " الراوي : سلمان بن عامر الضبي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 2581 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية- الشرح: "الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ" أي: لها أجْرُ التَّصدُّقِ عليه، "وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ" أي: لها أجْرُ صِلَةِ الرَّحمِ وأجْرُ التَّصدُّقِ عليه، والمقصودُ بـ:ذي الرَّحمِ: الأقاربُ الفُقراءُ، ذُكورًا وإناثًا، أمَّا الأغنياءُ منهم فصِلتُهم تكونُ بالهدايا والتَّزاورِ وبَشاشةِ الوجهِ والنُّصحِ للجَميعِ، وإطلاقُ لفظِ "الصَّدقةِ" يشمَلُ الفرْضَ مِن الزَّكاةِ لِمَن لا تجِبُ عليه النَّفقةُ، والمُستحبَّ من مُطلقِ الصَّدقاتِ. وقيل: هذا إذا لم يَقْتضِ الحالُ العَكسَ؛ بأنْ يكونَ غيرُ القريبِ أشدَّ حاجةً، وتضرُّرًا مِن القريبِ، فيكونُ التَّصدُّقُ عليه أَولى. وفي الحديثِ: الحثُّ على الاستكثارِ مِن الخيرِ بين الأقاربِ بكلِّ أوجُهِ الخيرِ. وفيه: الحثُّ على الاهتمامِ بذوي الأرحامِ، وأنَّ التَّصدُّقَ عليهم أفضلُ مِن التَّصدُّقِ على غيرِهم - إذا تساووا في درجة الحاجة- .- الدرر السنية- منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . * وإن تعارضت مصلحتان عامة وخاصةٌ ، فتقدَّم المصلحة العامة ، لأنها آكدُ . ـ ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له ، وهو أنه قد يَعْرِض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل ، بسبب اقتران ما يوجب التفضيل . ومن الأسباب الموجبة للتفضيل : * أن يكون العمل المفضول مأمورًا به بخصوص هذا الموطن ، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها ، والأذكار بعدها ، والأذكار الموظفة بأوقاتها ، تكون أفضل من قراءة القرآن في هذه المواطن . * ومن الأسباب الموجبة للتفضيل : أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا تكون في الفاضل ، كحصول تأليف قلوب به أو نفع متعدٍّ لا يحصل بالفاضل ، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل . * فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال لها : " يا عائشة لولا أن قومَكِ حديثُو عهدٍ بجاهلية ، لأمرتُ بالبيت فهُدِم فأدخلتُ فيه ما أُخرِجَ منه ، وألزقته بالأرضِ ، وجعلتُ له بابين ، بابا شرقيًا وَبابًا غربيًّا فبلغتُ به أساسَ إبراهيم " . صحيح البخاري . متون / 25 ـ كتاب : الحج / 42 ـ باب : فضل مكة وبنيانها /حديث رقم : 1586 / ص : 181 . دار ابن الهيثم . فهنا ترك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأفضل ـ وهو هدم الكعبة ، وبناؤها مرة أخرى على أساس إبراهيم ـ عليه السلام ـ ، لأن الأفضل معه مفسدة . فالناس ألِفُوا صورة الكعبة هكذا ، ولو تغيرت قد يخرج بعضهم من الإسلام ، فهم مازالوا ضعاف الإيمان لأنهم حديثو عهد بالجاهلية ؛ أي خرجوا من الجاهلية منذ وقت قريب ـ . فترك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم دفعًا لمفسدة راجحة . ـ وهذا أمر مركوزٌ عند العقلاء ، كما قيل : إن اللبيبَ إذا بدا من جسمِهِ مرضانِ مختلفانِ داوَى الأخطرَا. * ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل ، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لمّا سُئل عن بعض الأعمال " انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله " فهذه الأسباب تصيِّر العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به . رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 17 / بتصرف °قال الشيخ خالد المصلح: *الإشكال يقع فيما إذا تزاحمت النوافل، أو تزاحمت الفرائض، إذا اتفقت في الجنس، كيف يفعل؟ هنا يطول الكلام ويحتاج الإنسان إلى فقه مراتب الأعمال.الشيخ خالد المصلح = هنا= فمثلاً إنسان تزاحم عنده الآن طلب العلم وقيام الليل، ماذا يقدم؟ هل يقدم طلب العلم على قيام الليل؟ كلامنا في طلب العلم غير الواجب، غير المتعين، أما طلب العلم المتعين فخارج عن الكلام، كلامنا في طلب العلم الذي هو في دائرة النفل، وليس في دائرة فرض العين. أيهما يقدم؟ هل يقدم طلب العلم على قيام الليل؟ هنا لا فرق، فكيف يقدم؟ هنا لا بد من النظر إلى مراتب الأعمال وإلى ثمرة العمل، فإن الأعمال تتفاوت في الأجر والمرتبة والفضيلة والمنزلة بنتائجها وعواقبها وأجرها، وهذه قاعدة في جميع الأعمال الواجبة والمستحبة: المفاضلة بين الأعمال هو في نتائجها وعواقبها وأجرها، فأيهما يقدم؛ طلب العلم أو قيام الليل؟ عندنا الآن من يرى تقديم طلب العلم مطلقًا، ورأي من يقدم قيام الليل مطلقًا، ورأي يقدم الأصلح لقلبه، ورأي يفصل باختلاف أحوال الناس. وكل هذه الآراء قد قيل بها عند أهل العلم، وهذا الذي يجعل الموازنة بين المصالح من الأمور التي يحتاج فيها إلى فقه دقيق ونظر عميق حتى يتوصل الإنسان إلى الراجح من هذه الأقوال. الإمام أحمد رحمه الله مال إلى تقديم العلم على قيام الليل؛ وذلك أن قيام الليل نفعه لازم، وأما طلب العلم فنفعه متعدٍّ، وما كان نفعه متعديًا يقدم على النفع اللازم. وفي قول آخر في مسألة أخرى سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيهما أفضل؟ فقال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، فجعل المرجع في تحديد ما يقدم ويؤخر ما يحصل به زكاء القلب وصلاحه. لأن هذا مقصود للشارع، فالأعمال العبادية على اختلاف أنواعها وصورها إنما يراد بها صلاح القلب واستقامته وزكاؤه وصلاحه. " انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله " فهذه الأسباب تصيِّر العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به . إذًا في مثل هذه الأمور يحتاج الإنسان إلى أن يُنعم النظر ويدقق، وليس هناك جواب ينظم جميع الصور ويصلح لكل أحد. ولذلك لما سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أيهما أفضل: المجاورة في مكة أو في المدينة؟ قال: الأفضل في المجاورة ما يحصل به لك التقوى، حيثما كنت في مكة أو في المدينة أو على رأس جبل، أو في أي مكان، ليس السبق فيما يتعلق بفضل المكان، إنما السبق فيما يتعلق بما يحصل به المقصود للقلب من الزكاء والصلاح والاستقامة. فهذه الأمور تحتاج إلى بسط، وإلى نظر إلى جوانب عديدة، وهي راجعة إلى ما قدمنا به الحديث، وهو معرفة وفقه مراتب الأعمال، وهذا فقه دقيق.الشيخ خالد المصلح = هنا= 14 ـ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ* يُرتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ وضد القاعدة السابقة ؛ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ : المقصود هنا عند وجود مفسدتينِ محققتينِ ، لابد من وقوع واحدة منهما ، ولا مفر من تجنب إحداهما ، في هذه الحالة تُتَّقَى المفسدة العظمى بالمفسدة الدنيا ، لكن إذا كان يمكن تجنب المفسدتين فلا تطبق هذه القاعدة في هذه الحالة . المفاسد : إما محرمات ، أو مكروهات ، كما أن المصالح : إما واجبات أو مستحبات ، فإذا تزاحمت المفاسد ، بأن اضطرّ الإنسانُ إلى فعلِ إحداها ، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى ، بل يفعل الصغرى ، ارتكابًا لأهون الشرينِ ، لدفع أعلاهما . فإن كانت إحدى المفسدتين حرامًا والأخرى مكروهة ، قَدَّمَ المكروهَ على الحرامِ ، فيُقَدَّم الأكلَ منَ المشتبهِ على الحرامِ الخالصِ ، وكذلك يقدم سائرَ المكروهات على المحرمات . وإن كانت المفسدتانِ مُحَرَّمَتَيْنِِ : قدَّمَ أخفهما تحريمًا ، وكذا إذا كانتا مكروهتَيْنِ ، قدَّمَ أهونَهُمَا . ـ وهذه القاعدة يدور عليها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمِيَّة . فقد تحاول إزالة منكر وتُصر على ذلك ، فتتسبب في عشرات من المنكرات بسبب إزالتك لهذا النكر ، وقد تأمر بالمعروف فتتسبب في إزالة عشرات من المعروف . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . شرط النهي عن المنكر: ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. قال النووي: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته، أو ولده، أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف .اهـ.إسلام ويب- *قال ابن القيم رحمه الله :فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ: الْأُولَى: أَنْ يَزُولَ وَيَخْلُفَهُ ضِدُّهُ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقِلَّ وَإِنْ لم يَزُلْ بِجُمْلَتِهِ. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَخْلُفَهُ ما هو مِثْلُهُ. الرَّابِعَة: ُ أَنْ يَخْلُفَهُ ما هو شَرٌّ منه. فَالدَّرَجَتَانِ الْأُولَيَانِ مَشْرُوعَتَانِ وَالثَّالِثَةُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ وَالرَّابِعَةُ مُحَرَّمَةٌ. ...إذا رَأَيْت الْفُسَّاقَ قد اجْتَمَعُوا على لَهْوٍ وَلَعِبٍ أو سَمَاعِ مُكَاء وَتَصْدِيَةٍ، فَإِنْ نَقَلْتَهُمْ عنه إلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُرَادُ، وَإِلَّا كان تَرْكُهُمْ على ذلك خَيْرًا من أَنْ تُفْرِغَهُمْ لِمَا هو أَعْظَمُ من ذلك، فَكَانَ ما هُمْ فيه شَاغِلًا لهم عن ذلك. وَكَمَا إذَا كان الرَّجُلُ مُشْتَغِلًا بِكُتُبِ الْمُجُونِ وَنَحْوِهَا وَخِفْت من نَقْلِهِ عنها انْتِقَالَهُ إلَى كُتُبِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالسِّحْرِ فَدَعْهُ وَكُتُبَهُ الْأُولَى. وذكر أنه َسَمِعَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ بن تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ يقول: مَرَرْت أنا وَبَعْضُ أَصْحَابِي في زَمَنِ التَّتَارِ بِقَوْمٍ منهم يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَأَنْكَرَ عليهم من كان مَعِي فَأَنْكَرْت عليه وَقُلْت له إنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَصُدُّ عن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ وَهَؤُلَاءِ يَصُدُّهُمْ الْخَمْرُ عن قَتْلِ النُّفُوسِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ فَدَعْهُمْ. أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم، دار الجيل - بيروت - 1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ج3/ص4 - 5، وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيت728هـ، دار ابن حزم - بيروت -1424هـ -2004م، الطبعة الأولى، ص253-254.=الألوكة = ـ من تطبيقات هذه القاعدة : * خرق الخضر للسفينة : قال تعالى على لسانِ موسى " قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شيْئًا إِمْرًا" . سورة الكهف / آية : 71 . فبيَّنَ الخَضِرُ أن هذه السفينة لو بقيت صالحة لأخذها الملك الظالم ، فكان خَرْقُها فسادًا وضررًا ، لكن يُدْفَع به ما هو أضر وهو أخذ السفينة بكاملها . * وكون الإنسان بين اختيارَيْنِ : طلب العلم في موضع يرى فيها المنكر ويسكت ، أو ترك ذلك والبقاء على الجهل والأمية . فالأول مُقدَّم في الاختيار إذا أُمِنَتِ الفتنةُ ، فإن طلب العلم من ضرورة حفظ الدين ، والسكوت عن إنكار المنكر فيه رخصة في أحوال . -وتفصيل ذلك يقدم القوي الذي لا يخشى عليه الفتنة ليتعلم ثم ينشر علمه بلا مفاسد- ومنها جوازالكذب للإصلاح بين الزوجين . "ما سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرخصُ في شيءٍ من الكذبِ إلا في ثلاثٍ كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ" لا أعدُّه كاذبًا الرجلُ يصلحُ بين الناسِ يقولُ القولَ ولا يريدُ به إلا الإصلاحَ ، والرجلُ يقولُ في الحربِ ، والرجلُ يحدثُ امرأتَه ، والمرأةُ تحدثُ زوجَها". الراوي : أم كلثوم بنت عقبة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4921 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر- رغم أن الكذب مفسدة ،لكن نلجأ إليه لدرء مفسدة أعظم وهي التفريق بين الزوجين ، وإفساد ذات البين .... * عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا ، أن أُناسًا من عبد القيسِ قَدِموا على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقالوا : يا نبي الله ! إنا حَيّ من ربيعةَ . وبينا وبينك كفار مُضَرَ . ولا نقدرُ(1) عليك إلا في أَشهرِ الْحُرُمِ . فَمُرْنا بأمرٍ نأمرُ به مَنْ وراءنا ، وندخلُ به الجنةَ ، إذا نحن أخذنا به .فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " آمرُكُم بأربعٍ (2) . وأنهاكم عن أربعٍ . اعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا . وأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاةَ . وصوموا رمضان . وأَعطوا الخُمُسَ من الغنائمِ . وأنهاكم عن أربعٍ . عن الدُّباء (3) . والْحَنْتَم (4) . والمُزَفَتِ(5) . والنَّقِيرِ(6) " . قالوا : يا نبي الله ! ما عِلْمُكَ بالنقير ؟ . قال : " بلى . جذعٌ تنقرونه . فتقذفونَ فيه من القُطَيْعَاءِ " . - قال سعيد : أو قال من التمر ـ " ثم تصُبُّون فيه من الماء . حتى إذا سكن غليانه شربتموه . حتى إنَّ أحدكم - أو إنَّ أحدهم -ليضربُ ابنَ عمه بالسيف " . قال : وفي القوم رجل أصابته جِرَاحةٌ " كذلك . قال : وكنتُ أَخْبَأُها حياءً من رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ . فقلتُ : ففيم نشربُ يا رسول الله . قال " في أسقية الأَدَمِ ، التي يُلاثُ على أفوَاهِهَا " . قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا كثيرةُ الجِرْذانِ . ولا تبقَى بها أسقيةُ الأَدمِ . فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : وإن أكلتها الجِرْذانُ . وإن أكلتها الجِرذان . وإن أكلتها الجرذان " . وقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأشَجِّ عبدِ القيسِ " إن فيك لخصلتان يحبها اللهُ الحلمُ والأناةُ " . صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 6 ) ـ باب : الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... / حديث رقم : 26 ـ ( 18 ) / ص : 19 . ( 1 ) لا نقدر عليك : أي لا نقدر على الوصول إليك . ( 2 ) آمرُكُم بأربعٍ : قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمركم بأربع ثم ذكر خمس . اختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال ، أظهرها ما قاله الإمام ابن بَطَّال ـ رحمه الله ـ ، قال : أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ، ثم زادهم خامسة ، يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مُضَر ، فكانوا أهل جهاد وغنائم . ا . هـ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ( 3 ) الدُّباء: وهو القرع اليابس أي الوعاء منه . - وفيه : تُقطع القرعة نصفين وينزع منها البذور ثم تجفف وتستعمل كوعاء . ويطلق اسم الدُّّباء على القرع ، وعلى الكوسة - .شرح صحيح مسلم . ( 4 ) الحَنْتَم : جِرار ـ مفردها ـ الْجَرَّة . ( 5 ) المُزَفَت : ما طُلي بالزفت . ( 6 ) النَّقِيرِ : أصل النخلة يُنقر فيتخذ منه وعاء . ومعنى النهي عن هذه الأوعية الأربع : أنه نهى عن الانتباذ فيها ـ أي : النقع ـ ، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويُشرب . وإنما خُصت هذه ـ الأوعية ـ بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها ـ أي تتخمر سريعًا ـ . فنهى عنه ، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأَدم ، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المُسْكِر ، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا بخلاف هذه الأوعية المذكورة وغيرها من الأوعية الكثيفة ، فإنه قد يصير فيها مسكرًا ولا يُعلم . ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نُسخ بحديث بُرَيْدة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء . فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مُسكرًا " . صحيح مسلم / ( 11 ) ـ كتاب : الجنائز / ( 36 ) ـ باب : استئذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في ... / حديث رقم : 977 / ص : 231 صحيح مسلم شرح ... النووي / المنهاج / ج : 1 / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 8 ) ـ باب : الأمر بقتال ... / ص : 136 ، 137 / بتصرف . وعون المعبود / المجلد الخامس / كتاب العلم / 8 ـ باب / ص : 115 . · تطبيق القاعدة الفقهية على هذا الحديث : يوجد بالحديث مفسدتان : الأولى : قضية انتشار الخمور ، وأن هذه الأواني المنهي عنها يسرع إليها تخمر النبيذ- أي النقيع ، سواء كان نقيع تمر أو غيره - ، وخوفًا من أن يصير مُسْكِرًا ولا يُعْلَم به لكثافتها فيتلف ماليته ، وربما شربه المسلم ظانًا أنه لم يُصَرْ مُسْكِرًا فيصير شاربًا للْمُسْكِر ، وكان العهد قريبًا بإباحة المُسكر . الثانية : لتجنب ذلك ، أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستخدام أواني الجد ، لتجنب هذه المفسدة ، ولكن مع ذلك توجد مفسدة أخرى وهي : أن أواني الجلد هذه ـ أسقية الأدم ـ سريعة التلف نظرًا لانتشار الفئران في هذه المناطق وقرضها لهذه الأوعية . نعم هذه مضرة ، لكن في المقابل سنتقي مضرة أكبر منها وهي مضرة شرب الخمر . لذا لما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات ، وتقرر ذلك في نفوسهم ، نُسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا . عون المعبود / المجلد الخامس / كتاب : العلم / 8 ـ باب / ص : 116 / بتصرف .وشرح صحيح مسلم . بتصرف . · ومن هنا يتبين أن تلازم الأحكام وتزاحمها يحتاج إلى أمرين لكي يُبَتّ في ذلك ، نص عليهما شيخ الإسلام في " المجموع " : الأول : معرفة واقع الواقعة . الثاني : العلم بمراتب الحسنات والسيئات ، ومقاصد الشريعة . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 48 . ومما يتفرع على هاتين القاعدتين : ـ درء المفاسدِ مُقدم على جلب المصالح ـ درء المفاسد الراجحة مُقدم على جلب المصالح المرجوحة ـ تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة هذه القواعد نظير ما سبق ، والمراد : * أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، وتساويا ، فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة . وذلك لأن وجود المفسدة يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على تحصيل المنفعة ، لذا قالوا " التخلية قبل التحلية " ، أي إزالة العقبات من طريق جلب المصلحة أو المنفعة . ودفع المفسدة مُقدم على جلب المنفعة لحكمة أخرى حاصلها : أن المفسدة إذا لم تُدفع في أول أمرها ربما تتفاقم وتنتشر وتجر إلى مفاسد أخرى ، وتحُول بين جلب المنافع الدنيوية والأخروية . القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 107 / بتصرف . فإذا تساوت المصلحة والمفسدة ، ولم ترجح إحداهما ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن عناية الشارع بترك المنهيات آكد من عنايته بفعل المأمورات . * فعن أبي هريرة ، قال خطب رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الناس فقال " ... ، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " . سنن النسائي تحقيق الشيخ الألباني / 24 ـ كتاب : مناسك الحج / 1 ـ باب : وجوب الحج / حديث رقم : 2619 / ص : 409 / صحيح . فالمأمورات قال فيها صلى الله عليه وسلم " فخذوا به ما استطعتم " ، فعلقها على الاستطاعة ، وذلك باستفراغ الجهد . أما المنهيات فقال فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فاجتنبوه " . أي ابتعدوا عن المنهيات تمامًا . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . مثال ذلك : يمنع الشخص من الترف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا ؛ لأن درء المفاسد عن جاره ـ مقدم ـ وأولى من جلب المنافع لنفسه . الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية ... / جمعة صالح محمد / ص : 47 * أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، وكانت المفسدة أعظم من المصلحة ، وجب تقديم دفع المفسدة ، وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، كما سبق توضيحه عاليه . ومن شواهد هذه القاعدة : قوله تعالى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافعُ لِلناسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبرُ من نَّفْعِهِما " . سورة البقرة / آية : 219 . فحرم الله الخمر والميسر ، لأن مفسدتهما أعظم من مصلحتهما . قال الحافظ ابن كثير : " أما إِثمهما فهو في الدين ، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام ، وإخراج الفضلات ، ولذة الشدة التي فيها ، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها ، وما كان يقمِّشة بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ، ولهذا قال تعالى : " وَإِثْمُهُمَا أَكْبرُ من نَّفْعِهِمَا " . القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم / ص : 339 / بتصرف . * أما إذا دار الفعل بين مصلحة ومفسدة ، وكانت المصلحة أرجح من المفسدة ، حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة . وهذا مُفاد القاعدة التالية : تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ومن دلائل هذه القاعدة : ـ قول الله عز وجل " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" .سورة البقرة / آية : 179 . * قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : " ... فلولا القصاص لفسد العالَم ، وأهلك الناس بعضهم بعضًا استبداءً واتيفاءً ، فكان القصاص دفعًا لمفسدة التَّجَرِّي على الدماء بالجناية أو بالاستيفاء ، وقد قالت العرب في جاهليتها : " القتال أنفع للقتل " ، وبسفك الدماء تُحقن الدماء " . ا . هـ . ( 2 / 91 ) . القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم / ص : 343 وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية : " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ " . أي : تنحقن بذلك الدماء ، وتنقمع به الأشقياء ، لأن من عَرف أنه مقتول إذا قَتل ، لا يكاد يصدر منه القتل ، وإذا رؤي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر ، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل ، لم يحصل انكفاف الشر ، الذي يحصل بالقتل ، وهكذا سائر الحدود الشرعية ، فيها من النكاية والانزجار ، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ، ونكَّر سبحانه ـ أي جعلها نكرة ـ " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير . ولما كان هذا الحكم ، لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة ، والألباب الثقيلة ، خصهم بالخطاب دون غيرهم ، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم ، في تدبر ما في أحكامه ، من الحِكَم ، والمصالح الدالة على كماله ، وكمال حكمته وحمده ، وعدله ورحمته الواسعة ، وأن من كان بهذه المثابة ، فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب ، وناداهم رب الأرباب ، وكفى بذلك فضلاً وشرفًا لقوم يعقلون .ا . هـ . ومن دلائل هذه القاعدة أيضًا : ـ ما ترجم له البخاري بـ : باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب : ..... أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخبرته قالت : استأذن رجل على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقال : " ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة " . فلما دخل ألان له الكلام . قالت ـ قلتُ : يا رسول الله قلتَ الذي قلتَ ثم ألنت له الكلام ؟ قال " أي عائشةُ إن شر الناس من تركَهُ الناسُ أو ودعه الناس اتقاء فُحْشِهِ " . صحيح البخاري . متون / ( 78 ) ـ كتاب : الأدب / ( 48 ) ـ باب : ما يجوزمن اغتياب أهل الفساد والريب / حديث رقم : 6054 / ص : 714 . ووجه الدلالة منه : أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ترك الكلام في وجه الرجل لمصلحة التأليف ، ولئلاَّ ينفر عن الإسلام ، ورجاء إسلام قومه ؛ لأنه كان سيدَهم . ويستفاد منه أيضًا جواز غيبة الفسَّاق (1) للمصلحة الراجحة من نصح الناس وتحذيرهم من شرهم . ويدخل في هذا جرح الرواة لمصلحة حفظ السنة من الوضع . ( 1 ) جواز غيبة الفساق ... : هذا يكون في حق أولى الأمر ، وأهل العلم حقًا ، وليس من حق المتعالمين ، وإلا أصبحت فوضى وفتن لا آخر لها . o فائدة مستخلصة : ــــــــ ما حرمه الشارع فإنما حَرَّمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة ، فإن كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه ألْبتة . |
|
#4
|
||||
|
||||

المجلس العاشر دورة تيسير القواعد الفقهية 15 ـ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ * في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ الشَّرِيعَةِ: الشريعة تطلق في اللغة على مورد الماء، ومنبع الماء، ومصدر الماء، كما تطلق الشريعة على الملة، والدين، والطريقة، والمنهاج، والسنة. فيُقال: الشريعة والشرع والشرعة وكلها بمعنى واحد. لماذا أطلقت كلمة الشريعة على منبع الماء؟ لأنه مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات. فإذًا الشريعة إذا أردنا أن نستلهم من اللغة، هي مصدر حياة النفوس، ومصدر صلاح القلوب، ومصدر استقامة الأحوال، هذا المنبع الذي لا غنى عنه للسعادة في الدنيا والآخرة.موقع الشيح محمد صالح المنجد = هنا = التَّيْسِيرُ: مأخوذ من اليُسْر ، وهو السهولة والليونة . في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ: أي في كل أمر اعترض له وعارضه ونزل به . تَعْسِيرُ : مأخوذ من العُسر وهو الشدة وعدم الليونة . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري . = والمعنى الإجمالي للقاعدة : هو أن المشقةَ والعَنَتَ إذا طرآ على المكلَّفِ كانا سببًا في المجيء باليسر له في العمل المطروء عليه تلك المشقة ، فالشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 49 / بتصرف . المشقة هي : العُسر والعناء الخارجين عن حد العادة والاحتمال . القواعد ... / ... الصقعبي ـ وورد برسالة : الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية : ليس كل مشقة تكون سببًا للرخصة ؛ كمشقة الوضوء والغسل في البرد ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشقة ألم الحد ، ورجم الزناة ، وقتل الجناة ، وقتل البغاة ، فهذا القسم من المشاق لا أثر له في إسقاط العبادات ، وبالتالي فلا تشمله هذه القاعدة " المشقة تجلب التيسير " . وإنما المراد بالمشقة التي تؤدي إلى هلاك المكلَّف ، أو مرضه ، أو انقطاعه عن العمل .ا . هـ . ونماذج هذا في الشرع الحكيم كثيرة، فالمرض مشقة اقتضت تيسيرًا -للصائم والمصلي ...- ، والسفر مشقة اقتضت تيسيرًا، والخوف مشقة اقتضت تيسيرًا. الشيخ خالد المصلح = هنا = فشُرِعَ القصر والجمع والصلاة على حاله؛ جالسًا أو على جَنْب .... *قال الشيخ عثمان السبت :ليست كل مشقة تجلب التيسير، المشقة أنواع: = هناك مشقة خارجة عن طوق المكلَّف، والله -عز وجل- قال"لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" البقرة: 286، لم يكلفنا مالا نطيق ابتداءً، بمعنى لا يوجد في تكليف الشريعة أشياء لا يطيقها الإنسان، الإنسان ما كُلف بأن يطير في الهواء مثلاً . = وهناك تكليف بما لا يطاق على آحاد المكلفين لقيام العارض، مثلاً إنسان مُقعَد نقول: يجب أن تقوم في الصلاة، كيف يجب أن تقوم في الصلاة؟ "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" البقرة:286، فهذا تكليف ما لا يطاق على آحاد المكلفين، لماذا؟ لقيام العارض، وهو أن هذا الإنسان مُقعَد، وإلا فالأصل أن الإنسان يستطيع القيام. القسم الثالث: لا يستطاع إلا بكلفة كبيرة، ومشقة عظيمة، تؤدي به إما إلى الهلاك، أو إلى زيادة المرض، أو إلى تأخير البُرْء، أو إلى طول المرض، بحيث إن هذا الإنسان يحصل له ضرر معتبر، هذا الإنسان يعاني من مرض في رجليه، نقول له: صلِّ قائمًا، يقول: أنا أستطيع أن أصلي قائمًا، لكنني أجد من العناء والعنت والألم ما لا يُتَصَور، فماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له: "المشقة تجلب التيسير"، صلِّ قاعدًا، مع أنه يستطيع أن يصلي قائمًا. هذا الإنسان أجرى عملية في عينه، وقال له الطبيب: لا تسجد، ولا تركع، وإنما بالإيماء، هل هذا الإنسان يعجز حقيقة عن السجود والركوع؟ لا يعجز، يستطيع أن يسجد ويحصل الذي يحصل؛ لكنه يؤدي إلى زيادة المرض، أو تأخير البُرْء، أو عطب العضو، ذهاب البصر مثلاً، فماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول: "المشقة تجلب التيسير" تسجد وتركع إيماءً. و ستأتي قاعدة أخرى "مَن عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها"، ليس معناها: أنه يصلي على كرسي، قلنا: إنك لا تستطيع أن تركع وتسجد، لكن القيام ما شأنه وهو ركن؟ لماذا لا تقوم في الصلاة؟ فإذن المشقة التي يكون فيها الفعل مقدورًا للمكلف لكن مع عناء شديد، وحصول ضرر معتبر بأحد هذه الأشياء التي ذكرناها، فنقول "المشقة تجلب التيسير". الشيخ خالد عثمان السبت = هنا= *ففي هذه القاعدة أمران: الأمر الأول: الأصل، والأمر الثاني: القاعدة. الأمر الأول:الأصل أن الشريعة بناؤها على الْيُسر، دليل ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم« إنَّ الدينَ يسرٌ» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشيخ خالد المصلح = هنا = "إن الدينَ يُسرٌ ، ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَه ، فسدِّدوا وقاربوا ، وأبشروا ، واستعينوا بالغدوَةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ من الدُّلْجَةِ ". الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 39 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر السنية = الأمر الثاني: القاعدة :إذا طرأ على هذا الأصل وهو اليسر إذا طرأ عليه العسر والعناء الخارجين عن حد العادة والاحتمال، شُرعَ التيسير لدفع هذا الحرج والعسر الذي طرأ. o وقفة : قال الشيخ / سعد بن ناصر الشثري / في شرح هذه المنظومة : العلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا ، المؤلف هنا يقول : " في كل أمر نابه تعسير "ـ أي التعسير سبب للتيسير ، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر ، فيقولون " المشقة تجلب التيسير " ، ولعل لفظ المؤلف ـ أي الناظم ـ أولى من لفظ الفقهاء ، وذلك لعدد من الأمور : ـ الأمر الأول : أن الشريعة إنما جاءت بنفي العُسر ، ولا يوجد فيها نفي المشقة . " يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. سورة البقرة / آية : 185 . ـ الأمر الثاني : أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة ، لاشك أن الجهاد فيه مشقة ، وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة ، بل إن الصلاة فيها مشقة ، كما قال سبحانه" وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشعِينَ ". سورة البقرة / آية : 45 . لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل هذا من جهة و من جهة ثانية : أن هذه المشقة التي فى الفعل مقدورة للمكلف . و من جهة ثالثة : أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه ؛ ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء مُرًّا ، لكن المصلحة المترتبة على الدواء أعظم ، وهي الخاصية التي جعلها الله عز وجل في الدواء يُشفى بها المريض ، هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء . وكذلك أحكام الشريعة . والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة ، وإنما مقصوده المصلحة الراجحة الواقعة في الفعل . وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة ؛ متى يوصف الفعل بأنه مشقة ؟ هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر ؛ ولذلك لا نجد الشريعة تُعوّل على المشقة في بناء الأحكام ، وإنما تعول على رفع العُسر ورفع الحرج . ا . هـ .بقليل تصرف. * وقد تظاهرت وتضافرت أدلة الشرع على اعتبار هذه القاعدة فمن ذلك : ° قوله تعالى " لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعرَجِ حَرَج و لا على الْمَرِيضِ حَرَجٌ " . سورة النور / آية : 61 . يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير،... أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها ،....مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة المريض،. تفسير السعدي = هنا = ° وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ". سورة الحج / آية : 78 . أي ما جعل ،مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير، وسهله بغاية السهولة، فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس، لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف، خفف ما أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه. تفسير السعدي = هنا = °وقوله تعالى"وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. سورة البقرة / آية : 185 . أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير, ويسهلها أشد تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله, سهَّله تسهيلا آخر, إما بإسقاطه, أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها, لأن تفاصيلها, جميع الشرعيات, ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. تفسير السعدي = هنا = * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " صحيح البخاري . متون / 11 ـ كتاب : الجمعة / 8 ـ باب : السواك يومَ الجمعة / حديث رقم : 887 / ص : 102 . وورد في فيض القدير شرح الجامع الصغير / للمناوي / ج : 5 / ص : 442 : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم :أي : لولا مخافة أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب ، ففيه نفي الفرضية ، وفي غيره من الأحاديث إثبات الندبية . ا . هـ . * عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أن أبا هريرةَ أخبره أن أعرابيًّا بال في المسجد ، فثار إليه الناسُ ليقعوا به ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " دعوه وأهَرِيقوا على بوله ذنوبًا من ماءٍ أو سَجْلاً من ماءٍ ، فإنما بُعثتُم ميسرين ، ولم تُبعثوا معسرين " . صحيح البخاري / 78 ـ كتاب : الأدب / 80 ـ باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم " يسروا ولا تعسروا / حديث رقم : 6128 / ص : 721 . ( 1 )" فأصغى " : أي أمال لها الإناء لتتمكن من الشرب . حاشية سنن ابن ماجه ... .* عن كبشةَ بنتِ كعبٍ ـ وكانت تحت بعض ولدِ أبي قتادةَ ـ أنها صبت لأبي قتادةَ ماءً يتوضأُ به ، فجاءت هِرَّةٌ تشربُ ، فأصغَى (1) لها الإناءَ ، فجعلتُ أنظرُ إليه ، فقال : يا ابنةَ أخي ! أتعجبين ؟ . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم" إنها ليست بنجسٍ ، هي من الطَّوافينَ أو الطوَّافاتِ " . سنن ابن ماجه/ تحقيق الشيخ الألباني / 1 ـ كتاب : الطهارة وسنَنِها / 32 ـ باب :الوضوء بسؤر الهرَّةِ والرخصة في ذلك / حديث رقم : 367 / ص : 82 / صحيح . ـ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الحديث ـ علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال " إنها من الطوافين " . القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم ... / ص : 52 . o نظرة تأمل : ــــــ من تتبع الشريعة الغراء في أصولها وفروعها يجد التيسير واضحًا جليًّا في العبادات والمعاملات والحقوق والقضاء والأحوال الشخصية وغير ذلك مما يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم ، أوعلاقة الخلق بعضهم ببعض بما يضمن سعادتهم في الدنيا والآخرة . فالشرع في ذاته يسير. والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن نوعين اثنين : = نوع شُرِعَ من أصلِهِ للتيسير-ميسر في نفسه - ، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية ، وهنا لفتة وهي إن إيراد هذه القاعدة لا يعني ذلك أن الأصل في الشريعة العُسر ، وإنما المراد أن الأصل فيها اليسر . = نوع شُرع لِمَا يَجِدّ من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرُّخَص . وهذا دليل عيان يَشهد بأن هذا الدِّين دين اليسر والسهولة ، وشاهد أيضًا على سماحته وتجاوبه مع الفِطَر المستقيمة ، ... وتقديم ما تزول به مشقتهم وعناؤهم . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . °فالدين يسر في ذاته فلنتأمل: *الصلوات الخمس : فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها ، وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها - للرجال-؛ فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها ، ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها- أي يشعر بحلاوتها- ، ويَحْمَد اللهَ على فرضه لها على العباد ؛ إذ لا غنى لهم عنها الإسلام سؤال وجواب= هنا= "يا بلالُ أقمِ الصلاةَ، أرِحْنا بها"الراوي : سالم بن أبي الجعد - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 4985 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية - الشرح الصَّلاةُ أعظمُ أركانِ الإسلامِ العَمليَّةِ، ولها أهمِّيَّتُها الخاصَّةُ في الشَّرعِ، وفيها مِن الرُّوحانيَّاتِ والصِّلةِ باللهِ ما يَجْعَلُ القلبَ يَرْتاحُ ويَخْرُجُ مِنْ متاعبِ الدُّنيا إلى مَعِيَّةِ الحَقِّ سُبْحانَه، وقد جعلتُ قُرَّةُ عينِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّلاةِ. وفي هذا الحَديثِ يقولُ رَّجُلٌ من خُزاعةَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ "يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها"، أي: ارْفَعْ أذانَ الصَّلاةِ وأَقِمْها؛ لِنَستريحَ بِها، وكأنَّ دُخولَه فيها هو الرَّاحةُ مِنْ تَعَبِ الدُّنيا ومَشاغِلِها؛ لِمَا فيها مِنْ مُناجاةٍ للهِ تعالى وراحةٍ للرُّوحِ والقَلْبِ، ولا عَجَبَ في ذلك؛ فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم هو القائلُ "وجُعِلتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاةِ"، وطَلَبُ الرَّاحةِ في الصَّلاةِ يَصْدُرُ ممَّنْ كان خاشعًا فيها ومُحِبًّا لها، وإنْ كانت ثَقيلةً على البعضِ؛ كما قال اللهُ"وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ"البقرة: 45. وفي الحَديثِ: أنَّ الصَّلاةَ راحةٌ للقَلْبِ مِنْ تَعَبِ الدُّنيا ومَشاغِلِها.= الدرر = "وجعلَتْ قرةُ عَيني في الصلاةِ"الراوي : أنس بن مالك - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 3950 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر = الشرح: وهذا بيانٌ لعظيمِ محبَّتِه لها؛ وذلكَ لِما فيها مِن القُرْبِ مِن المولَى عزَّ وجلَّ؛ فلا شيءَ يُسعِدُه ويُدخِلُ عليه السُّرورَ بمِثْلِ ما تُدخِلُ عليه الصَّلاةُ؛ فقُرَّةُ العينِ يُعبَّرُ بها عنِ المَسرَّةِ ورؤيةِ ما يُحِبُّه الإنسانُ. وفي الحديثِ: بَيانُ عِظَمِ قَدْرِ الصَّلاةِ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأنَّها يَنبغي أنْ تكونَ الأَوْلَى عندَ كلِّ مسلِمٍ .الدرر = ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض ، من مرض أو سفر أو غيرهما ، رتب على ذلك من التخفيفات ، وسقوط بعض الواجبات ، أو صفاتها وهيئتها ما هو معروف : "كانتْ بي بَواسيرُ ، فسأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصلاةِ ، فقال : صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ ". الراوي : عمران بن الحصين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 1117- خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر = *وأما الزكاة : فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي ، وإنما تجب على الأغنياء تتميمًا لدينهم وإسلامهم ، وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ، ودفعًا للآفات عنهم وعن أموالهم ، وتطهيرًا لهم من السيئات ، ومواساة لمحاويجهم ، وقيامًا لمصالحهم الكلية ، وهي مع ذلك جزءٌ يسير جدًا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق .الإسلام سؤال وجواب= هنا= الأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أموال الدولة العامة، والأوقاف العامة، وما أعد للإنفاق في وجوه البر، وما ليس له مالك معين، وكل ما أعد للقنية والاستعمال كالأثاث، والثياب، والدار، والدابة، والسيارة ونحو ذلك.كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي = هنا = "ليس على المسلمِ في عَبْدِه ولا فَرَسِه صدقةٌ" الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 982- خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر- "ما نقصَ مالُ عبدٍ من صدقةٍ" الراوي : أبو كبشة الأنماري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 2325 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر= أي: ما قَلَّ مالُ عبدٍ مسلِمٍ تصَدَّق به، بل يُبارِكُ اللهُ له فيه. قال تعالى"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " التوبة :103. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه، آمرًا له بما يطهر المؤمنين، ويتمم إيمانهم "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" وهي الزكاة المفروضة،"تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" أي: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. "وَتُزَكِّيهِمْ"أي: تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. "وَصَلِّ عَلَيْهِمْ" أي: ادع لهم، أي: للمؤمنين عمومًا وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. "إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ" أي: طُمأنينة لقلوبهم، واستبشار لهم، "وَاللَّهُ سَمِيعٌ" لدعائك، سمع إجابة وقبول. "عَلِيمٌ" بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله، وعلى قدر نيته، فكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يمتثل لأمر اللّه، ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرَّك. تفسير الشيخ السعدي رحمه الله = هنا = * وأما الصيام : فإن المفروض شهر واحد من كل عام ، يجتمع فيه المسلمون كلهم ، فيتركون فيه شهواتهم الأصلية - من طعام وشراب ونكاح - في النهار , ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم ، وزيادة كمالهم ، وأجره العظيم ، وبره العميم ، وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير ، ويكون سببًا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها ، وترك المنكرات .الإسلام سؤال وجواب= هنا= قال تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "البقرة: 183.". فالصيام :أجره عظيم - إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، لا مِثلَ له،لا عِدْلَ له. * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "قال اللهُ عزَّ وجلَّ : كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلَّا الصِّيامُ . فإنَّه لي وأنا أجْزِي به...." الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1151 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر = * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم"يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ كلُّ عمَلِ ابنِ آدمَ له إلا الصيامَ فهو لِي وأنا أجزِي بِهِ إنَّمَا يتْرُكُ طعامَهَ وشَرَابَهُ مِن أجْلِي فصيامُهُ لَه وأنا أجزِي بِه كلُّ حسنةٍ بعشرِ أمثالِهَا إلى سبعمائِةِ ضعفٍ إلا الصيامَ فهو لِي وأنا أجزِي بِهِ "الراوي : أبو هريرة - المحدث : أحمد شاكر - المصدر : مسند أحمد-الصفحة أو الرقم: 13/239 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر - * عن أبي أمامة ، قال : أتيتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ؛ فقلتُ : مُرني بأمرِ آخذه عنك ، قال " عليك بالصوم ؛ فإنه لا مِثلَ له " . سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / 22 ـ كتاب : الصيام / 43 ـ باب :الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب / حديث رقم : 2220 / ص : 351 / صحيح . * عن أبي أمامة ، أنه سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أيُّ العمل أفضلُ ؟ . قال " عليك بالصوم ، فإنه لا عِدْلَ له " . سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / 22 ـ كتاب : الصيام / 43 ـ باب :الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب / حديث رقم : 2222 / ص : 351 / صحيح . *وأما الحج : فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع ، وفي العمر مرة واحدة ، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده ، قال تعالى" لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ "الحجّ/28, أي: دينية ودنيوية. "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "آل عمران: 97. "مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" صحيح البخاري - كِتَاب الْحَجِّ - لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور=الدرر= عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ"صحيح البخاري - كِتَاب الْعُمْرَةِ - بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا- هنا= عطايا عظيمة من الرحمن عز وجل . *ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية اليسر ، الراجعة لأداء حق الله وحق عباده . فهي في نفسها ميسرة ، قال تعالى " يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "البقرة/185، قال تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" البقرة : 286 . = ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض ، من مرض أو سفر أو غيرهما ، رتب على ذلك من التخفيفات ، وسقوط بعض الواجبات ، أو صفاتها وهيئتها ما هو معروف . ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل ، وصلاة وصيام وصدقة وغيرها ، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل - البشر - وإمامهم محمد صلّى الله عليه وسلم ، رأى ذلك غير شاق عليه ، ولا مانع له عن مصالح دنياه ، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها : حقّ الله ، وحقّ النفس ، وحقّ الأهل والأصحاب ، وحقّ كلّ من له حقّ على الإنسان برفق وسهولة . الإسلام سؤال وجواب= هنا= *فائدة: المداومة على الطاعة تجعلها سجية في صاحبها، ويسيرة عليه بإعانة الله له. "يقول اللهُ تعالَى : أنا عندَ ظنِّ عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكَرَنِي ، فإن ذَكَرَنِي في نفسِه ذكرتُه في نفسي ، وإن ذكَرَنِي في ملأٍ ذكرتُه في ملأٍ خيرٌ منهم ، وإن تقرَّبَ إليَّ شبرًا تقرَّبتُ إليه ذراعًا ، وإن تقرَّبَ إليَّ ذراعًا تقرَّبتُ إليه باعًا ، وإن أتاني يمشي أتيتُه هَرْوَلةً" الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 7405 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر = في هذه الجُمَلِ الثَّلاثِ بَيانُ فَضْلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّه يُعطي أكثَرَ ممَّا فُعِلَ مِن أجلِهِ، أي: يُعْطي العامِلَ أكثَرَ مِمَّا عَمِلَ.الدرر = كلما تقرب العبد للرب أعانه الله بأن يقيم العبد على طاعته، وييسر له الأمر، ويجازية بأحسن وأعظم مما فعل بمضاعفة المثوبة . قال تعالى "وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ " محمد 17. أي:والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها ، وثبتهم عليها وزادهم منها ، "وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ" أي : ألهمهم رشدهم .تفسير ابن كثير = هنا = * أسباب التخفيف : حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية وهي : ـ السفر : والسفر على الراجح يُرجع فيه إلى العُرْف . " السفر " والدليل على أن السفر مِناط به التخفيف قول الله ـ عز وجل ـ "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 184. ـ المرض : وهو خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد " المرض " كما قال ـ جل وعلا ـ " فَمَن كانَ منكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صيَامٍ أَوْ صدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " . سورة البقرة / آية : 196 . فْعلق الحكم بالمرض " مريضًا " ولم يطلق ، لم يقل : من كان به مرض ، فدل ذلك على أن المراد مرض خاص ، والذي يترتب عليه الفعل أو يترتب عليه الحكم و إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معها لتأخر البُرْءُ أو زاد المرض ، فإنه يشرع التخفيف حينئذ . مثال ذلك : من كان الصيام يؤخر شفاءه ، أو كان الصيام يزيد في مرضه جاز له الفطر ، ومن لم يكن كذلك لم يُجز له الفِطر ، ولو كان مريضًا ؛ ولذلك من به وجع أسنان أو صداع بحيث أن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض ، فإنه لا يجوز له الإفطار . فالمريض قد أُذن له بأن يتخلف عن صلاة الجماعة ، وأن يصلي قاعدًا أو يصلي على جنبه حسب ما يستطيع . ويرجع لتفصيل هذا في كتب الفقه ، فهناك من قال بمطلق المرض . ـ الإكراه : وهو في اصطلاح الفقهاء " حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو تُرك ونفسه " . قال تعالى"مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ " النحل 106. ـ النسيان أو السهو : والنسيان هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة ، أو هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه . فإذا نسي الإنسان ، وكان لا يمكن تدارك هذا الشيء ، فإنه يسقط وجوب هذا الشيء بفواته . -قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: كمن أكل في الصيام ناسيًا ومتى ترك واجبًا ناسيًا فلا شيء عليه حال نسيانه- هنا= وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده ؛ كالصلاة والزكاة ونفقات الزوجات وجب تداركه "رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطَأَ والنِّسيانَ وما اسْتُكرِهُوا عليْه"الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 3515 - خلاصة حكم المحدث : صحيح بلفظ وضع= الدرر = ـ الجهل : هو نقيض العلم ، وهو في الاصطلاح اعتقاد الشيء جزمًا على خلاف ما هو في الواقع . فالجهل سبب يرفع الإثم والحرج والمسئولية عن المكلفين . لما نُزِّلَت " حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ "البقرة/187 . والمراد من الخيط الأبيض النهار ، والخيط الأسود الليل . قال الحافظ : وَمَعْنَى الآيَةِ حَتَّى يَظْهَرَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ , وَهَذَا الْبَيَانُ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ . اهـ . ومعنى ذلك: أن الله تعالى أباح للصائم الأكل والشرب ليلًا حتى يتبين له ؛أي يتيقن طلوع الفجر . وقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم الآية على خلاف معناها ، ففهموا أن المراد منها الخيط الحقيقي، فكان أحدهم يجعل تحت وسادته أو يربط في رجله خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ويظل يأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر. روى البخاري :1917،ومسلم :1091: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أُنْزِلَتْ " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ" وَلَمْ يَنْزِلْ "مِنْ الْفَجْرِ" فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ "مِنْ الْفَجْرِ" فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . فهؤلاء الصحابة حَمَلُوا الْخَيْطَ عَلَى ظَاهِرِهِ , فَلَمَّا نَزَلَ "مِنْ الْفَجْرِ" عَلِمُوا الْمُرَادَ . وَقَوْلُهُ " مِنْ الْفَجْرِ " بَيَانٌ لِلْخَيْطِ الأَبْيَضِ , وَاكْتَفَى بِهِ عَنْ بَيَانِ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ لأَنَّ بَيَانَ أَحَدِهِمَا بَيَانٌ لِلآخَرِ . = الإسلام سؤال وجواب = هنا = وقد فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه الآية كما فهمها هؤلاء حتى صحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم وبين له المعنى المراد من الآية . = الإسلام سؤال وجواب = هنا = سأل عدي بن حاتم الطائي الرسول صلى الله عليه وسلم: "قلتُ يا رسولَ اللهِ، ما الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ، أهما خيطان ؟ قال " إنك لعَريضُ القَفا إن أبصَرتَ الخَيطَينِ " ثم قال "لا، بل هو سوادُ الليل وبياضُ النهارِ ".الراوي : عدي بن حاتم الطائي - المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 4510 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر = فَهِمَ مِن الآيةِ أنَّ المسلمَ لا يزال مفطِرًا يأكل ويشرب حتَّى يتجلَّى النَّهارُ، ويظهَرَ له الحبلُ الأبيض مِن الحبلِ الأسود،فلم يأمره النبي بإعادة الصيام وقضائه لجهله بالحكم .وقَالَ الْقَاضِي " إِنَّك لَعَرِيض الْقَفَا "مَعْنَاهُ إِنْ جَعَلْت تَحْت وِسَادك الْخَيْطَيْنِ الَّذِينَ أَرَادَهُمَا اللَّه تَعَالَى وَهُمَا اللَّيْل وَالنَّهَار فَوِسَادُك يَعْلُوهُمَا وَيُغَطِّيهِمَا , وَحِينَئِذٍ يَكُون عَرِيضًا وإِنَّك لَضَخْمٌ. اهـ . قناة بناء الملكة الفقهية على برنامج التلجرام بإشراف الدكتور محمد حسن عبد الغفار = هنا= "إنَّ اللهَ تجاوزَ عَن أمَّتي الخطأَ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا علَيهِ" الراوي : أبو ذر الغفاري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم: 1675 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر = قال تعالى" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "البقرة/ 286 فهذه النصوص تدل على أن كل من خالف ما كُلف به ، ناسياً أو جاهلاً فإنه معفو عنه ؛ فالمخطئ يشمل الجاهل ؛ لأن المخطئ هو كل من خالف الحق بلا قصد. وقال الشيخ ابن عثيمين " والجهل ـ بلا شك ـ من الخطأ .الإسلام سؤال وجواب .هنا= والجاهل العاجز عن السؤال والعلم؛ غير الجاهل المتمكن المفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله تعالى.هنا= فهذه ليست دعوى إلى الجهل ؛ لأن الإنسان لا يعذر بتفريطه بل نقول يجب عليه أن يتعلم ما لا تقوم العبادة إلا به ، وما لا تصح العبادة إلا به ، لكنه لو بذل واجتهد في ذلك لكنه جهل بعض المسائل فإنه يُرْفَع عنه الحرج . ـ العُسر وعموم البلوى : و " العسر " أي مشقة تجنب الشيء . و " عموم البلوى " أي شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء الابتعاد عنه . والأصل في ذلك:قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم" إنها ليست بنجسٍ ، هي من الطَّوافينَ أو الطوَّافاتِ " . سنن ابن ماجه/ تحقيق الشيخ الألباني / 1 ـ كتاب : الطهارة وسنَنِها / 32 ـ باب :الوضوء بسؤر الهرَّةِ والرخصة في ذلك / حديث رقم : 367 / ص : 82 / صحيح . وما أشبهه ويعسر الاحتراز منه ويصعب تجنبه منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف . منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف . * أنواع الرُّخَص : ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ أن الرخص الشرعية سبعة أنواع ، وهي كما يلي : ـ رخصة إسقاط : كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها ، كإسقاط الصلاة عن الحائض وعن النفساء ، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا . ـ رخصة تنقيص : أي إنقاص العبادة لوجود العذر ، وهذا كالقصر في الصلاة . ـ رخصة إبدال : أي إبدال عبادة بعبادة ـ كإحلال التيمم محل -الوضوء والغسل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ، - وإحلال القعود أو الاضجاع للمرض محل القيام بالصلاة -. ـ رخصة تقديم : كجمع التقديم بعرفات بين الظهر والعصر ، قالوا " يجوز تقديم الشيء بعد انعقاد سببه وقبل وجود شرطه " . مثلاً : الإنسان إذا صار عنده نصاب زكاة ، هذا هو سبب الزكاة بلوغ النصاب ، يجوز أن يقدم زكاته قبل شرطه وهو حلول الحول . ـ رخصة تأخير : كالجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء ، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء ... ـ لعدة من أيام أُخر - .. ـ رخصة اضطرار : كشرب الخمر للغصة إذا لم يجد ـ ماء ـ وخشي على نفسه الهلاك ،وأكْل الميتة والخنزير عند المسغبة - أي المجاعة- وخشية الموت جوعًا . ـ رخصة تغيير : كتغيير نظم الصلاة للخوف . منظومة القواعد الفقهية ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
المجلس الحادي عشر دورة تيسير القواعد الفقهية16 ـ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ* وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ الوَاجِبٌ : هو ما طَلَب الشارعُ فعله على وجه اللزوم ، كالصلاة والصيام ... . المُحَرَّم: هو ما طلب الشارع تركَهُ على وجه اللزوم ، كالربا والكذب ......منظومة القواعد الفقهية .د.مصطفى كرامة مخدوم *وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ: أي لا يثبت واجبٌ ولا يستقر على المكلف بدون قدرة، وبدون استطاعة، فالأحكام كلها تتبع الاستطاعة، قال الله تعالى"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا"البقرة:186. فإذا عجز المكلَّفُ عن القيام بالواجب فلا يكون واجبًا في حقه ، كالأعمى والأعرج لا يجب عليهما الجهاد لعجزهما عنه .قال تعالى"لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ "النور 61. قال الشيخ السعدي في تفسيره: أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض= هنا = °دليل هذه القاعدة: قول النبي -صلى الله عليه وسلم" دعوني ما تركتُكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالُهم واختلافُهم على أنبيائِهم ، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم"الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 7288 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر - قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم"فإذا أمرتُكم بشيء فأْتُوا منه ما استطعتُم" هذا مِن قواعدِ الإسلام المهمَّةِ، ومن جوامِعِ الكَلِمِ التي أُعْطِيها صلَّى الله عليه وسلَّم، ويَدخُلُ فيها ما لا يُحصَى من الأحكام، وهذا الحديثُ مُوافقٌ لقولِ الله تعالى"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"التغابن: 16= الدرر= فكل ما أمر الله به من الأوامر شرطه الاستطاعة، فإذا عجز عنه الإنسان سقط عنه الوجوب، إما أن يسقط - هذا الوجوب - إلى بدل: مثل الصلاة "صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ".صحيح البخاري= هنا = . وفي الصوم يقول الله عز وجل"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"البقرة:184 .وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ:أي: يتكلفون الصيام، ويشق عليهم مشقة لا تحتمل كالكبير والمريض والميئوس من بُرئه، فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره. تفسير السعدي. وإما أن يسقط إلى غير بدل مثل سقوط الحج عن غير القادر عليه. والعجز إما أن يكون بالبدن، وإما أن يكون عن الآلة التي يتوصل بها أو بوسيلتها أو بواسطتها إلى المطلوب، إما أن يكون عاجزًا عن هذا وهذا في الوقت نفسه، وإما عن هذا أو عن الآخر. ـ إعمال المُحَرَّم مع الاضطرار إليه - أي : إباحة المُحَرَّم عند الضرورة - .مثل: الحج،قد يكون- عاجزًا ببدنه قادرًا بماله، أو قادرًا ببدنه عاجزًا بماله، أو عاجزًا ببدنه وماله كإنسان مقعد وفقير.الشيخ خالد بن عثمان السبت = هنا = فإذا عجز عن الواجب سقط - كما سبق -، لكن إذا عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه هل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه - في كل الأحوال- أو لا؟ هذا تحته أقسام: القسم الأول: أن يكون المقدور عليه وسيلةً محضة، فهذا لا يجب عليه، مثال ذلك: أن يقول: أنا أستطيع أن أصل إلى المسجد لكني لا أستطيع أن أصلي جماعةً فنقول: لا يجب عليك أن تجيء؛ لأن المجيء من البيت إلى المسجد وسيلة محضة، ومثال ذلك أيضًا: إمرار المُوس في الإحرام على رأس الأصلع، نقول: هذا لا يجب؛ لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا نوع من العبث، فإذا كان المقدور عليه وسيلةً محضة فلا يجب. القسم الثاني: ألاّ يكون المقدور عليه إذا انفرد عبادةً بنفسه، وأيضًا نقول: لا يجب. مثال ذلك أن يقول: أنا أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار ولكن لا أستطيع أن أكمل، يقول لم يرد في الشرع الصيام إلى نصف النهار، وعليه فلا يجب عليك أن تصوم ثم تفطر. القسم الثالث: ما عدا ذلك فنقول: يجب، إذا كان يقدر على البعض ولا يستطيع البعض الآخر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه"صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ".صحيح البخاري= .الشيخ خالد بن علي المشيقح = هنا = *وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ: *الضّرورة في الاصطلاح: عرّفها السّيوطيّ رحمه الله بقوله: «فالضّرورة: بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب - الهلاك ».= هنا = *لكن إذا كان يمكنه أن يستغني بمكروه أو بمباح، كأن وجد رجلًا يُقْرِضه مالًا يشتري به طعامًا والطعام موجود، أو وجد من يقرضه الطعام، فنقول: إنه ليس له أن يأكل الحرام ما دام يمكنه أن يستغني بالحلال المباح أو المكروه. *الأصل في سؤال الناس هو التحريم، وعلى جواز سؤال المسلم من المسلم عند الضرورة والحاجة. "أَقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ . فنأمرُ لك بها . قال : ثم قال : يا قَبيصةُ ! إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ : رجلٍ تحمَّل حمالةً فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها ثم يمسِك . ورجلٍ أصابته جائحةٌ اجتاحت مالَه فحلَّتْ له المسألةُ حتى يصيب قِوامًا من عيشٍ - أو قال سِدادًا من عيشٍ -. ورجلٍ أصابتْه فاقةٌ حتى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِه : لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ . فحَلَّتْ له المسألةُ . حتى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ - أو قال سِدادًا من عيشٍ - فما سواهنَّ من المسألةِ ، ياقَبيصةُ ! سُحْتًا يأكلُها صاحبُها سُحتًا"الراوي : قبيصة بن مخارق الهلالي - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1044 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر = شرح الحديث: هذا الحديثُ يوضِّح جانبًا عملِيًّا مِن التربِيَةِ النبويَّةِ للمسلمين على العِفَّةِ وعِزَّةِ النفسِ، وعدمِ سؤالِ الناسِ إلَّا في الحالاتِ التي بيَّنها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للصَّحابِيِّ الذي جاء يَستَعِينُه بعدَ أن تحمَّل على نفسِه بمالٍ لِيُصْلِحَ بينَ الناسِ، فأعانَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه مِمَّن يَحِقُّ له السؤالُ ويَستَحِقُّ الصَّدقَةَ. وهذا الحديثُ له مقدِّمةٌ توضيحيَّةٌ تُبيِّن السببَ المُلجِئَ الذي أَجْبَرَ الصحابِيَّ على طلبِ العَوْنِ مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال الصحابيُّ "تَحمَّلْتُ حَمالَةً"، أي: تَكفَّلْتُ دَينًا، والحَمالَةُ: هي المالُ الذي يَتحمَّلُه الإنسانُ، أي: يَستَدِينُه ويَدْفَعُه في إصلاحِ ذاتِ البَيْنِ، كالإصلاحِ بينَ قَبِيلَتَيْنِ، ونحو ذلك. "فأَتَيْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَسْأَلُهُ فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تَأتِيَنا الصَّدَقةُ، فنَأمُرَ لكَ بها"، أي: ذهَبْتُ أطلُب مِن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم العَوْنَ على الحَمالَةِ، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: انْتَظِرْ حتَّى تَأتِيَنا الصَّدقةُ مِن زَكَوَاتِ الناسِ فنُعْطِيَك منها، وإنَّما حلَّتْ له المسألةُ واستَحَقَّ أن يُعطَى مِن الزَّكاةِ؛ لأنَّه استَدانَ لغيرِ مَعْصِيَةٍ. ثُمَّ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم له موضِّحًا الأصنافَ التي تَحِلُّ لها أن تسألَ الناسَ "يا قَبِيصَةُ، إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ"؛ الصِّنْفُ الأوَّلُ: "رَجُلٌ تحمَّلَ حَمالَةً فحَلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصِيبَها ثُمَّ يُمْسِكُ"، أي: مَن تَحمَّلَ دَينًا على نفسِه لِلإصلاحِ بينَ الناسِ، فهذا يَطلُب من الناسِ مالًا، "حتَّى يُصيبَها"، أي: يُصِيبَ ويَأخُذَ ما تَحمَّلَه مِنَ الحَمالَةِ، فيَأخُذ مِن الصدقةِ بقَدْرِها، "ثُمَّ يُمسِكُ"، أي: يُمسِكُ ويَمتَنِعُ عن المسألةِ والطلَبِ. والصِّنفُ الثاني الذي تَحِلُّ له المسألةُ "ورَجُلٌ أصابَتْه جَائِحَةٌ" الجائِحَةُ: الآفَةُ التي تُهلِكُ الثِّمارَ والأموالَ، وتَستأصِلُها، فمَن أصابَتْه الآفةُ السَّماوِيَّةُ، واستأصَلَتْ ثِمارَه أو أموالَه، "فحَلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوَامًا مِن عَيْشٍ، أو قال: سِدَادًا من عَيْشٍ"، أي: حَلَّتْ له المسألةُ حتَّى يَحصُلَ على ما يقومُ بحاجتِه الضروريَّةِ، وما يتقوَّم به من العَيْشِ، والقِوَامُ والسِّدادُ: هما ما يُغنِي من الشيءِ، وما تُسَدُّ به الحاجةُ، وكلُّ شيءٍ يُسَدُّ به شيءٌ فهو سِدَادٌ. والصِّنفُ الثالثُ الذي تَحِلُّ له المَسْأَلةُ "ورَجُلٌ أصابَتْه فاقَةٌ حتَّى يَقُومَ ثلاثةٌ مِن ذَوِي الحِجَا مِن قومِه: لقد أصابَتْ فُلانًا فاقةٌ، فحلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِن عَيْشٍ، أو قال: سِدَادًا مِن عَيْشٍ"، أي: أصابَه الفَقْرُ الشديدُ، واتَّضَحَ وظَهَر "حتَّى يقومَ ثلاثةٌ مِن ذَوِي الحِجَا"، أي: حتَّى يَشْهَدَ ثلاثةٌ مِن قومِه مِن ذَوِي الفَهْمِ والعَقْلِ يقولون: "لقد أصابَتْ فُلانًا فاقةٌ" وقيَّدهم بِذَوِي العُقولِ تنبيهًا على أنَّه يُشترَطُ في الشَّهادةِ: التيقُّظُ، فلا تُقبَلُ من مُغَفَّلٍ، وجعَلهم من قومِه؛ لأنَّهم أعلمُ بحالِه. وهؤلاءِ هم الذين تَحِلُّ لهم المسألةُ كما ورَد في الحديثِ، "فما سِوَاهُنَّ مِنَ المسألةِ -يا قَبِيصَةُ- سُحْتًا، يَأكُلُها صاحبُها سُحْتًا" السُّحْتُ: هو الحَرامُ الذي لا يَحِلُّ كَسْبُه؛ لأنَّه يُسحِتُ البَرَكَةَ، أي: يُذهِبُها. وقولُه: "يَأكُلها صاحبُها سُحتًا" يُفِيدُ أنَّ آكِلَ السُّحتِ لا يَجِدُ لِلسُّحتِ الذي يَأكُله شُبهةً تَجعلُها مباحةً لنفسِه، بل يَأكُلها مِن جِهَةِ السُّحتِ والحرامِ. وفي الحديثِ: النَّهيُ عن مسألةِ الناسِ إلَّا لِلضَّرورَةِ المُلجِئَةِ. وفيه: بيانُ أصنافِ مَن تَحِلُّ لهم المسألةُ مع بيانِ الأسبابِ المُلجِئَةِ لذلك. وفيه: أنَّ مَن أخَذَ أموالَ الناسِ بغيرِ حقٍّ فإنَّه يَأكُلُ سُحتًا وحَرامًا = الدرر = *فالمكلّف إذا اضطرَّ إلى فعلِ المُحَرَّم ، فإنه لا يكون مُحَرَّمًا في حقه ، ولا يكون آثمًا عند ذلك ، كالمنقطع في الصحراء يضطرُّ إلى أكلِ الميتةِ فلا حرج عليه في ذلك . وهذا معنى قول الفقهاء :الضرورات تبيح المحظوراتِ . والأصل في هذه الصورة قوله تعالى "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" .سورة الأنعام / آية : 119 . فأخبر ـ سبحانه ـ أن المضطر إليه مستثنى من المحرمات، أي ما اضطررتم إليه ليس حرامًا عليكم . oشروط تطبيق هذه القاعدة : ينبغي أن يُعلم أن الضرورة التي تبيح المحظور لابد فيها شروط: oالشرط الأول: أن يتعين ارتكاب المحرم. oالشرط الثاني: أن يتيقن زوال ضرورته بالمحرم. فمن كان في صحراء وأكل ما غُص به، فوقفت اللقمة في حقله، وإما أن يدفعها أو يهلك، وليس عنده إلا خمر، فإما أن يدفع هذه الغصة بما لديه من خمر، وإما أن يهلك، أولًا: هل تَعَيَّن ارتكاب المحرم؟، ما معنى هل تعين ارتكاب المحرم؟، يعني هل هناك شيءٌ آخر يمكن أن تندفع به الضرورة غير هذا الخمر، ما عنده إلا خمر، إذن تعين فعل المحرم. ثانيًا: هل إذا ارتكب المحرم وشرب الخمر ستندفع ضرورته به ؟ أو لا؟. الجواب: نعم، ستندفع ضرورته، لأنه لا يحتاج إلا إلى سائل حتى يدفع هذا، ففي هذه الحالة الضرورة تبيح المحرم , لأنه توافر في الصورة الشرطان. *النقاش في المثال ليس من شيم الرجال =صورة أخرى بنفس المثال، رجل في صحراء وعطش حتى شارف الهلاك، وليس عنده إلا خمر، هل يجوز له أن يشرب الخمر ليدفع عطشه ؟، الآن هل تعين فعل المحرم ؟، نعم، ليس عنده سائل لشربه إلا الخمر. هل تندفع ضرورته بشرب الخمر ؟، الجواب لا، لماذا ؟ لأن الخمر لا تزيده إلا عطشًا، ولذلك يقول الفقهاء ليس له أن يشرب، لأنه إذا شرب زاد عطشًا، وهو إنما يشرب لدفع عطشه، فهنا الآن لا يقول أشرب الخمر لأجل أن أدفع الضرورة، لماذا ؟، لأن الضرورة لا تندفع بهذا. الشيخ خالد المصلح = هنا = o الشرط الثالث: ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة . فإن وُجد ، لم يجز ـ حينئذ ـ فعل المحظور . مثال ذلك : طبيبة مسلمة ، وطبيب رجل ، وعندنا امرأة مريضة ، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطبيبة . أو رجلًا يُقْرِضه مالًا يشتري به طعامًا والطعام موجود، أو وجد من يقرضه الطعام، فنقول: إنه ليس له أن يأكل الحرام ما دام يمكنه أن يستغني بالحلال المباح أو المكروه. o الشرط الرابع: أن يكون المحظور أقل من الضرورة ، فإن كانت الضرورة أعظم ، لم يجز ـ فعل المحظور ـ . مثال ذلك : إذا اضطُّرَ إلى قتل غيره لبقاء نفسه . كما في مسألة الإكراه ، فهنا الضرورة أقل من المحظور ، - فلا يجوز فعل المحظور - . المحظور هو : قتل الغير . الضرورة هي : أنه سيقتل الإنسان ، بعد تهديده بالقتل إذا لم يقتل هذا الغير . ـ ويلاحظ أنه إذا زالت الضرورة ، زال حكم استباحة المحظور . القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف . *وبصيغة أخرى :أَنْ يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أَنْقَصَ مِنْ ضررِ حالةِ الضرورة، فإِنْ كان الضررُ في حالةِ الضرورةِ أَنْقَصَ أو يُساويهِ فلا يُباحُ له: كالإكراه على القتل أو الزِّنا: فلا يُباحُ واحدٌ منهما؛ لِمَا فيه مِنَ المَفْسدةِ الراجحة؛ إذ ليس نَفْسُ القاتل وعِرْضُه أَوْلى مِنْ نَفْسِ المقتول وعِرْضِه. ومِنْ ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت ـ الذي لم يُكفَّن ـ بغَرَض تكفينه؛ لأنَّ مفسدةَ هَتْكِ حُرْمته أَشَدُّ مِنْ مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مَقامَه موقع الشيخ فركوس = هنا = *آخر ما أقول في هذه القاعدة ما يتعلق بالخوف، والالتباس الذي يقع عند كثيرٍ من الناس في مسألة عدم التفريق بين الحاجة والضرورة، *الحاجة في الاصطلاح: عرّفها الإمام الشّاطبيّ رحمه الله بقوله: «أمّا الحاجيّات فمعناها أنّها مفتقر إليها من حيث التّوسعة ورفع الضّيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاّحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلّفين على الجملة الحرج والمشقّة ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العاديّ المتوقّع في المصالح العامّة.» *الضّرورة في الاصطلاح: عرّفها السّيوطيّ رحمه الله بقوله: «فالضّرورة: بلوغه حدًّا إن لم يتناوله الممنوع هلك أو قارب».= هنا = =فتجد أن أناسًا يستبيحون المحرمات لأجل الحاجة وليس للضرورة، والحاجة لا تبيح المحرم، الحاجات الخاصة لا تبيح المحرم، وإنما الحاجات تبيح المكروهات، وأما الضرورات فهي التي تبيح المحظورات والمحرمات. فإذا كان حاجة فهنا نقول إذا احتجت زالت الكراهة، مثال ذلك : السير في المقبرة بين القبور بالنعال مكروه , فإذا قال والله أنا عندي أذى في قدمي، الطبيب قال لا تخلع النعال، أو الأرض فيها ماء، شوك وأذى لا أستطيع أن أتوقاها إلا بلبس النعال، نقول هنا: الحاجات تبيح المكروهات، بمعنى أنها تزيل وصف الكراهة، لكن ليس هذا كالضرورة، ففرقٌ بين الضرورة وبين الحاجة. الشيخ خالد المصلح = هنا = |
|
#6
|
||||
|
||||
|
المجلس الثاني عشر 17-وَ كُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَهْ ... بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَهْدورة تيسير القواعد الفقهية شرح مجمل: فهذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة وقَيد لها ، وهي كقاعدة فقهية يذكرها الفقهاء بقولهم : " الضرورات تقدَّر بقدرِها " . وبيانها : أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فَحَسْب . فإذا اضطر الإنسان لمحظورٍ فليس له أن يتوسَّع فيه ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط . وأصلها قوله تعالى " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " .سورة البقرة / آية : 173 . ـ قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية " فالباغي " الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكَّى . فالبغي : أن يأخذ الإنسان بحكم الضرورة ، وهو غير مضطر . و " العادي " الذي يتعدى قدر الحاجة بأكملها " . 1 / 71 فالعدوان : هو تجاوز مقدار الضرورة . القواعد الفقهية ... / لابن القيم / ص : 315 / بتصرف . شرح القواعد ... / د . مصطفى كرامة مخدوم . المحظور يعني المُحَرّم -الممنوع-، ومعنى البيت أنّ المضطر إلى المُحَرّم يجب عليه أنْ يقتصر على القدر الذي تندفع به ضرورته؛ ولا يحلّ له أنْ يتجاوز ذلك، وهذا معنى القاعدة التي يذكرها الفقهاء "الضرورة تقدر بقدرها" وهذه مقيدة لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، يعني "الضرورات تبيح المحظورات" هل على الإطلاق؟ أم بقيد؟ يقال: بقيد ما تندفع به هذه الضرورة؛ فإذا اندفعت رجع الأمر إلى ما كان عليه. مِن الأمثلة :أنّ المضطر إلى أكل الميتة له أنْ يأكل بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك ولا يزيد على ذلك.حلقات جامع شيخ الإسلام ابن تيمية = هنا = الإمام مالك قال "إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى الشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها" قال في :الموطأ "وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة". الموطأ ص 309 ط الشعب، الإشراف 2/ 257، القواعد الفقهية، الروقي ص 310.= هنا =القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. *وقال الشيخ حمد الحمد: يأكل بقدر ما يدفع ضرورته؛ لكن إذا قال: إني يغلب على ظني أني لا أجد شيئًا أمامي وأنا أريد أن أمشي في الصحراء، فله أن يأكل حتى الشبع، أو أن يحمل منها، وذلك لأنه إذا منع فقد لا يجد في طريقه شيئًا فيهلك. إذًا: ليس له أن يأكل حتى الشبع إلا إذا كان يقول: أنا لا أدري هل أجد شيئًا أم لا، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد أو يتيقن أنه يجد الطعام عند حاجته بعد ذلك فليس له أن يأكل فوق حاجته. وكما أن الضرورة تقدر بقدرها فالحاجة أيضًا تقدر بقدرها، فالطبيب إذا أراد أن يكشف موضعًا من بدن المرأة يحتاج إلى علاج فإنه يقدر هذا بقدره ولا يزيد، فإذا كان الداء بوجهها فليس له أن يكشف شعرها بل يكتفي بكشف الوجه، وكذلك الشاهد ينظر من المرأة ما يحتاج إليه فقط ولا يزيد. شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد = هنا = أيضًا مِن الأمثلة: لو اضطر شخص لكشف عورته للطبيب أثناء العلاج؛ فهذا يباح له لكن بشرط أنْ يقتصر على موضع الحاجة أو الضرورة فقط، كما أنّ الطبيب يَحْرُمُ عليه أنْ ينظر مِن عورة هذا المريض ما زاد عن الضرورة أو زاد عن الحاجة، وهذه المسألة يحتاج إليها النساء أكثر مِن الرجال، لأنّ المرأة عورة، فإذا أُصيبت المرأة بمرض في أذنها؛ تَجِدُ بعض النساء إذا ذهبت إلى الطبيب وأراد أنْ يكشف على الأذن ماذا تعمل المرأة! كثير مِن النساء تكشف الوجه كله وهذا لا ضرورة إليه ولا حاجة إليه وإنما تكشف الأذن؛ وإنِ احتاج إلى موضع آخر كأنْ ينظر إلى الفم فتكشف الفم، فالضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها،- هذا إذا اضطرت للذهاب لطبيب رجل وإلا فالأصل أن المرأة تعالج عند طبيبة - دليل هذه القاعدة قول الله عزّ وجلّ"فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ"البقرة:173، قَيَّدَ نفي الإثم هنا بعدم البغي والعدوان، والبغي أنْ يأخذ الإنسان بحكم الضرورة وهو غير مضطر، يعني أنْ يأكل مِن الميتة قبل أنْ يصل إلى حال الضرورة، يقال: هذا باغٍ، والعدوان أنه إذا وقعت له الضرورة أَكَلَ أو فَعَلَ المُحَرّم زيادة على حاجته أو زيادة على ضرورته، فهذا هو دليل القاعدة. حلقات جامع شيخ الإسلام ابن تيمية = هنا * ما هو حد الضرورة ؟ ___________ نقول بأن الاضطرار وإن كان سببًا من أسباب إباحة الفعل إلا أنه لا يُسقط حقوق الآدميين وإن كان يُسقط حقَّ اللهِ عز وجل برفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر أو المستكرَه ، فإن الضرورة لا تبطل حق الآدميين . مثاله : شخص وجد شاة فذبحها مضطرًا ـ للجوع الشديد ـ وأكل لحمها ، ثم جاء صاحب الشاة وطالبه بالثمن ، فلا يقول أنا مضطر والضرورات تبيح المحظورات ! نعم هو رُفع عنه الإثم ـ حق الله ـ ، لكن لا يعني ذلك أن حق الآدميين يسقط ، وإنما يجب عليه أن يدفع القيمة ـ لصاحب الشاة ـ . منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري . ولكن هذا ليس على الإطلاق ، فهناك ضابط لهذه المسألة ، وهو : إذا نشأت الضرورة من حق الغير ، فإنه حينئذ لا حق لذلك الغير . * مثاله : إنسان هاج عليه جَمَل ، فاضطر إلى قتله ؛ دفاعًا عن نفسه ، فهل يحق لصاحب الجمل أن يأتي إليه ويطالبه بقيمة الجمل ؟ . الجواب : لا . لا يحق له ؛ لماذا ؟ . لأن الاضطرار هنا ناشئ من ملك الغير ، ناشئ من ذات المملوك ـ أي الجَمَل ـ فحينئذ لا يجب الضمان . أما إذا كان الاضطرار ليس ناشئًا عن حق الغير ، فعلى المضطر الضمان . مثل ذلك : مضطر جائع ، لم يجد إلا جملًا مملوكًا لغيره ، فذبحه وأكله ، فحينذ الاضطرار ليس ناشئًا عن مِلْك الغير ـ أي الجَمل ـ ومن ثَم فإنه ـ أي المضطر ـ يضمن ـ أي يدفع عِوَض ـ ذلك المِلْك ـ أي ـ الجمل ـ . * مثال آخر : إنسان في السفينة ، ألقى بعض المتاع في البحر ؛ لأنه مضطر إلى إلقائه . فهنا هل يجب الضمان أو لا يجب ؟ . نقول : ننظر لماذا ألقى المتاع ، فإن كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع ، كأن يكون الرجل في جانب السفينة ، فسقط عليه بعض المتاع ، فخشي على نفسه الهلاك ، فألقى بالمتاع في البحر . فهنا الاضطرار ناشئ من مِلْك الغير ، فلا يجب عليه الضمان . لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئًا من ذلك المتاع ، بأن تكون السفينة حمولتها كثيرة ، ويخشى عليها من الغرق ، فقال القائمون على السفينة : لابد من إلقاء بعض المتاع ، فأُخِذَ بعض المتاع فأُلقي ، فحينئذ هل يضمن ؟ . نقول : نعم يضمن ، لأن هذا الاضطرار ليس ناشئًا من ذات المتاع ، وإنما ناشئ من جميع من في السفينة ، فحينئذ يُقال لجميع من في السفينة : اضمنوا هذا المتاع ، ويضرب عليهم قيمته أو مثله ، بحسب أعدادهم . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 . |
|
#7
|
||||
|
||||
|
المجلس الثالث عشر دورة تيسير القواعد الفقهية18ـ وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لليَقِينِ * فَلاَ يُزِيلُ الشَّكُّ لليَقِيِنِ هذه القاعدة تشير إلى قاعدة فقهية كلية وهي :
" اليقين لا يزول بالشك " . وَتَرْجِعُ: تعود . الأَحْكَامُ : واحدها حُكم وهو في اللغة : المنع .وسُمِّي القضاء حكمًا؛ لأنه يمنع النزاع والخصومات. تقول : وحَكَّمْتُ الرجلَ تحكيمًا ، إذا منعته مما أراد ، قاله الجوهري في " الصِّحَاح " . والحكم في الاصطلاح هو : إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا . قاله الجرجاني في" التعريفات " ،أو هو : إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ومثاله في الإيجاب : زيد قائم ، حيث أثبت القيام لزيد . ومثال السَّلب : لم يقم زيد ، حيث نفيت القيام عن زيد . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 . أقسام الحكم: بِناءً على التعريف السابق، فقد ثبت بالاستقراء أن الحكم ينقسم إلى ما يلي: = الحكم الشرعي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع، كقولنا: الصلاة واجبة، والقتل حرام. = الحكم العقلي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل، كقولنا: الكل أكبر من الجزء. = الحكم العادي - التجريبي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة والعادة، كما يستفاد أن هذا الدواء لهذا الداء. = الحكم الحسي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس، كحكمنا أن النار محرقة، والماء مروٍ. = الحكم الوضعي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع، كقولنا: الفاعل مرفوع.= الألوكة = وقد عَرَّفَه الأصوليون بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ؛ اقتضاءً ـ أي طلبًا ـ ،أو تخييرًا ، أو وضعًا-أي: ثابت بالوضع والإخبار ، فالحكم الوضعي : هو خطاب الشرع بجعل أمرٍ ما علامة على أمر آخر . كالقرابة - مثلاً- فإنها وضع شرعي ، وهي سبب للإرث - والأحكام الوضعية خمسة هي : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحة ، والفساد . الواضح في ... / ص : 48 . الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 . ولمزيد تفصيل يرجع لهذا = هنا =الحكم الوضعي والفرق بينه وبين الحكم التكليفي. لليَقِينِ: *مراتب العلم أربعة: المرتبة الأولى: اليقين، وهو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه..منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . مثلًا: خمسة زائد خمسة، الجواب عشرة هل عندك فيها تردد؟ لا، فهذا يقين.ما حكم الطهارة؟ واجبة، هل عندك فيها تردد؟ لا، هذا يقين.المرتبة الثانية:الظن، وهو إدراك الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح، يعني هناك تردد لكن يترجح أحد الاحتمالين؛ فالراجح يسمى ظنًا والمرجوح هو الوهم.المرتبة الثالثة: الشك، وهي أنْ يتساوى الاحتمالان، ليس هنالك مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، فهذا شك.المرتبة الرابعة:الوهم وهو الاحتمال المرجوح.= هنا = حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا كنت تتوقع هذا بنسبة عشرة بالمائة، عشرين بالمائة، ثلاثين بالمائة، أربعين بالمائة، هذا يسمونه: وهمًا. وإذا كان التوقع بنسبة خمسين بالمائة، فهذا هو الشك. إذا كان ستين بالمائة، سبعين بالمائة، ثمانين، تسعين، يقولون له: الظن، أو يقولون له: الظن الراجح، إذا كان مائة بالمائة فهذا الذي يسمونه: اليقين. *اليقين اصطلاحًا : هو حصول الجزم ،أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه .منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . فاليقين عند الفقهاء يدخل فيه: الشيء المتيقن المجزوم به، ويدخل في ذلك أيضًا غالب الظن، فإذا كان عندك تردد بين أمرين لا تدري أيهما الصواب، فنقول: ارجع إلى اليقين أو غلبة الظن.شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد= هنا = *والسبب في إدخال الظن وجعله كاليقين هنا: هو أنّ الظن يُعمل به في كثير مِن الأحكام الشرعية، ولو قيل: إنه لا يُعمل إلّا باليقين! لتعذر الوصول إلى العلم في كثير مِن الأحكام الشرعية، فيكفي في ذلك غلبة الظن. مثال :شهادة الشهود عند القاضي: * الأصل براءة الذمة : وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم " البيِّنَة على المدعِي ، واليمين على المدعَى عليه" سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني13ـ كتاب : الأحكام عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ12ـ باب : ما جاء في أن البينة على المدَّعِي واليمين على المدَّعَى عليه / حديث رقم- 1341 : ص- 316 - صحيح . والمعنى : القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجود شيء أو لزومه ، وكونه مشغول الذمة هذا خلاف الأصل ، لأن المرء يولد خاليًا من كل دَيْنٍ أو التزامٍ أو مسئوليةٍ ، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة ، والأصل في الأمور العارضة العدمحتى تثبت بقرينة . فمثال الأخذ بغلبة الظن :شهادة الشهود عند القاضي، لو ادّعى شخص على آخر أنه قد أقرضه مئة ألف ريال؛ فأنكر المُدَّعَى عليه! والأصل ؛ أنّ المُدَّعَى عليه ذمته بريئة حتى يثبت ذلك . فإذا جاء المُدّعِي باثنين مِن الشهود العدول فشهدوا أنّ المُدَّعِي قد أقرض المُدّعَى عليه هذه المئة ألف؛ ماذا سيحكم القاضي؟ سيحكم بمقتضى هذه الشهادة، طيب هذه الشهادة الآن هل تفيد اليقين حتى يرفع اليقين السابق وهو براءة الذمة ؟ أو أنّها تفيد الظن؟ نعم تفيد الظن، طيب كيف تفيد الظن مع أنهم عدول؟ نعم، حتى لو كانوا عدولًا ألا يحتمل أنْ يكونوا قد أخطأوا أو تَوَهَّمُوا، وأيضًا العدل ليس معصومًا، قد يكذب! هذا محتمل، لكن هذا الاحتمال مرجوح مادام عدلًا قد زُكِّيَ مِن قِبَلِ اثنين مِن المُزَكِّيْن؛ فإنّ شهادتَهُ تكون مفيدة للظن، وهذا الظن رفع اليقين السابق، إذًا لا يلزم في رفع اليقين أنْ يحصل يقين يرفعه! يكفي في رفعه الظن. والحكمُ المسْتَصحَبُ ، وإن كان يقينًا في أصله إلا أنه ظنيٌّ من جهة بقائه واستمراره ، فرجعت المسألةُ إلى تعارض الظنون «واليمين على من أنكر»؛ أي: مَن أنكر دعوى خَصْمِهِ إذا لم يكن لِخَصْمِهِ بيِّنَة، فإذا قال زيدٌ لعمرٍو: أنا أقرضتك مائة درهم، وقال عمرٌو: لا، قلنا لزيدٍ: اِئْتِ ببيِّنَةٍ، فإنْ لم يأتِ بالبيِّنَة، قلنا لعمرٍو: احلفْ على نفيِ ما ادعاه، فإذا حلفَ برِئَ. أيضًا مِن الأدلة على هذا أنّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم عمل بشهادة المرضِعَةِ الواحدة في التفريق بين الرجل والمرأة في الحديث الذي ورد في ذلك، مع أنّ شهادة المرأة إنما تفيد الظن! فأزال بها اليقين السابق وهو حِل هذه المرأة للرجل، هذا ما يتعلق باليقين.= هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. فعن عقبة بن الحارث : أنَّهُ تزَوَّجَ ابنَةً لأبِي إِهَابِ بنِ عُزَيْزٍ ، فأَتَتْهُ امرأةٌ فقالتْ : قدْ أَرْضَعْتُ عقْبَةَ والتي تَزَوَّجَ ، فقالَ لهَا عقبةُ : ما أعلمُ أنَّكِ أَرْضَعْتِنِي ولا أخْبَرْتِنِي ، فَأَرسَلَ إلى آل أبِي إهَابٍ يسأَلُهُم ، فقَالوا : ما عَلِمنَا أَرضَعَتْ صَاحِبَتَنَا ، فَرَكِبَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالمدينةِ فسَأَلَهُ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " كيفَ وقَدْ قيلَ". ففَارَقَهَا ونَكَحَت زوجًا غَيرَهُ ".الراوي : عقبة بن الحارث - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2640 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر = وفي هذا الحديثِ: تزوَّج عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ رضِي اللهُ عنه ابنةَ أَبِي إِهَابِ بنِ عَزِيزٍ، فجاءَتْه امرأةٌ وأَخْبَرَتْه أنَّها أَرْضَعَتْه هو ومَن تزوَّجَها، فقال لها عُقْبَةُ: ما أَعْلَمُ أنَّكِ أَرْضَعْتِني ولا أَخْبَرْتِني، يعني: لم يُخْبِرْني أحدٌ- بِمَا فيهم أَنْتِ- بأنَّكِ أَرْضَعْتِني قبلَ ذلك، فأَرْسَل عُقْبَةُ لِآلِ أَبِي إِهَابٍ يسألُهم عن الأمرِ، فأَخبَروه بأنَّهم لا عِلمَ لهم قَبلَ ذلك بأنَّها أرضعَتِ ابنتَهم، فذَهَب عُقْبَةُ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأَخْبَره بما حَدَث، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم «كَيْفَ وقَدْ قِيلَ؟!»، أي: كيف تُبقِيها عندك تُباشِرُها وتُجامِعُها وقد قِيلَ: إنَّك أَخُوها مِن الرَّضَاعةِ؟! ففَارَقَها عُقْبَةُ رضِي اللهُ عنه، وتزوَّجَتْ هي بعدَه زوجًا آخَرَ.الدرر= قالوا:والأصل والغالب إن تعارضا فقدِّم الغالبَ وهو المرتضى. والحكمُ المسْتَصحَبُ ، وإن كان يقينًا في أصله إلا أنه ظنيٌّ من جهة بقائه واستمراره ، فرجعت المسألةُ إلى تعارض الظنون . فَلاَ يُزِيلُ الشَّكُّ لليَقِيِنِ: و الشَّكُّ في الاصطلاح يطلق على التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح لأحدهما على الآخر، ويدخل في الشك مِن باب أولى في هذه القاعدة الوهمُ، يعني لو كان عندنا يقين أو ظن ثم جاءني شك؛ هذا الشك لا يزيل اليقين أو الظن السابق، طيب إذا كان عندي يقين أو ظن ثم جاءني وَهْم؛ فهو مِن باب أولى لا يرفع اليقين أو الظن السابق.هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا تكاد تلك القاعدة تخلو من باب من أبواب الفقه ويدل على صحة هذه القاعدة عدة أدلة ترجع إلى الخبر ،والإجماع ، والنظر. فأما الخبر، ما رواه مسلم في صحيحه : * فعن سعيد وعبَّادِ بنِ تميمٍ ، عن عمهِ ، شُكِيَ إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الرجلُ يُخيلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاةِ . قال "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا ، أو يجد ريحًا " .صحيح مسلم / 3 ـ كتاب : الحيض / 26 ـ باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك / حديث رقم : 361 / ص : 93. يَجدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، يعني: يَظنُّ أَنَّه خرَجَ منه الرِّيحُ، فقال له النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم « لا يَنصرفُ» ، «حتَّى يَسمعَ صوتًا أو يَجدَ ريحًا»، والمعنى: أَنَّه لا يَخرجُ مِن صَلاتِه حتَّى يَتيقَّنَ خروجَ الرِّيحِ منه؛ لأنَّه مُتيقِّنٌ لِطهارتِه فلا يزولُ هذا اليقينُ بِمجرَّدِ الشَّكِ، بل ينبغي أن يتيقَّنَ مِنَ الحدَثِ وخُروجِ الرِّيحِ. ـ ففي هذا الخبر:الحكم ببقاء الطهارة وإن طرأ الشك ، لأن الطهارة مُتيقَّنٌ منها ، وأما إذا تُيقِّن من الحدث الموجب نقض الطهارة ـ نُقِضَت الطهارة ـ . وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا ، فإنه لا يرفع حكمه بالشك . *وعن أبي سعيد الخُدري ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ علَى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ له صَلاتَهُ، وإنْ كانَ صَلَّى إتْمامًا لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطانِ. " الراوي : أبو سعيد الخدري -المحدث : مسلم -المصدر: صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم- 571 خلاصة حكم المحدث:صحيح= الدرر = في هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إذا شَكَّ أحدُكم"، أي: تَردَّد، "في صَلاتِه "، ولم يَترجَّحْ عندَه أحدُ الطَّرفين بالتَّحرِّي، "فلم يَدرِ كم صَلَّى ثلاثًا، أم أربعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ"، أي: المشكوكَ فيه، وهو الأكثرُ، والمعنى: يُلغي الزائدَ الَّذي هو محلُّ الشَّكِّ ولا يأخُذْ به في البناءِ، يعني: الرَّكعةَ الرَّابعةَ، "وليَبْنِ على ما استيقَنَ"، أي: المُتَيَقَّنُ به وهو الأقلُّ؛ فالثَّلاثُ هو المُتَيَقَّنُ، والشَّكُّ والتَّرَدُّدُ، إنَّما هو في الزيادَةِ، فيَبنِي على المُتَيَقَّنِ لا على الزائدِ الَّذي يشُكُّ فيه، ثُمَّ يَسجُدُ سجدتين قبل أن يُسلِّمَ، "فإن كان صلَّى خَمْسًا"، فإن كان ما صلَّاه في الواقعِ أربعًا فصار خمسًا بإضافةِ ركعةٍ أخرى إليه شفعن له، أي: للمُصلِّي، يعني: شفعتِ الركعاتُ الخمسُ صلاةَ أحدِكم بالسَّجدتين. "وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربع"، إنْ صلَّى ما شكَّ فيه حالَ كونِه مُتمِّمًا للأربع، فيكون قد أدَّى ما عليه من غيرِ زيادَةٍ ولا نُقصانٍ. "وكانتا" أي: السجدتان، "ترغيمًا للشيطان"، أي: دحرًا له ورميًا له بالرَّغام وهو التُّرابُ؛ فإنَّ الشَّيطانَ لَبَسَ عليه صَلاتَه، وتعرَّضَ لإفسادِها ونَقْصِها، فجعَلَ اللهُ تعالى للمُصلِّي طريقًا إلى جَبْرِ صَلاتِه، وتَدارُكِ ما لَبَسَه عليه، وإرغامِ الشَّيطانِ، وردِّه خاسئًا مُبعَدًا عن مُرادِه، وكَمَلَتْ صلاةُ ابنِ آدمَ لَمَّا امتثَلَ أمرَ اللهِ تعالى الَّذي عصَى به إبليسَ، مِن امتناعِهِ مِنَ السُّجودِ . = الدرر = -وأما الإجماع : فحكاه غير واحد كالقرافي ـ رحمه الله ـ في " الفروق " ، وابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ في" إحكام الإحكام " .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 64 . -وأما النظر : فلأن اليقين لا يغلبه الشك ألْبتة ، حيث إنه قطع بثبوت الشيء فلا ينهدم بالشك.مجموعة الفوائد البهية ... / ص65 . o فائدة : ــــ ذَكَرَ الناظم رحمه الله في شرحه أنّ هذه القاعدة لا تختصّ بالفقه بل تدخل أيضًا في غير الفقه،فقاعدة" اليقين لا يُزال بالشك"لها اعتبار عند الاستدلال بالأدلة ؛ إذا نظرنا إلى الألفاظ قالوا: إنّ الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة حتى يأتي ما يصرفها عن هذه الحقيقة، والأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يأتي الصارف، كقوله تعالى " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ " البقرة/43 ،فقد دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن الأمر بإقامة الصلوات الخمس للوجوب . مثال اقتران الأمر بما يدل على أنه ليس للوجوب , كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : 1183 " صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ , قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ." فقوله " لِمَنْ شَاءَ" دليل على أن الأمر في قوله " صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ " ليس للوجوب . والأصل في اللفظ العام أنه يفيد عموم جميع الأفراد حتى يأتي المخصِّص، رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ"لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ"ولا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ" الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم- 1039 : خلاصة حكم المحدث : صحيح=الدرر= فَاقْتَضَى ذَلِكَ نَفْيَ كُلِّ صَلاَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ قَال «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». "مَن نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذلكَ".الراوي : أنس بن مالك - المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم684 : -خلاصة حكم المحدث : صحيح. فَأَخْرَجَ بهَذَا اللَّفْظِ الخَاصِّ الصَّلاَةَ المَنْسِيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا بَعْدَ العَصْرِ، سَوَاءٌ كَانَ الخَاصُّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا».هنا = والأصل إحكام النص حتى يثبت الناسخ له وهكذا في كثير من القضايا.= هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. تعريف النسخ اصطلاحًا :رفعُ حُكْم شرعي متقدم ، بخطاب شرعي متأخر ، منفصل عنه منافٍ له . "كانَ أصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا كانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ ولَا يَومَهُ حتَّى يُمْسِيَ، وإنَّ قَيْسَ بنَ صِرْمَةَ الأنْصَارِيَّ كانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإفْطَارُ أتَى امْرَأَتَهُ، فَقالَ لَهَا: أعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قالَتْ: لا ولَكِنْ أنْطَلِقُ فأطْلُبُ لَكَ، وكانَ يَومَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عليه، فَذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ"أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ"البقرة: 187- فَفَرِحُوا بهَا فَرَحًا شَدِيدًا، ونَزَلَتْ"وَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ"البقرة: 187. الراوي : البراء بن عازب -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم1915 -خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر = خَيبةً لك: أي: حِرمانًا لك. فالأصل : إذَا كانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ ولَا يَومَهُ حتَّى يُمْسِيَ. أي والأصل إحكام النص حتى يثبت الناسخ له. وقد ثبت الناسخ في نفس الحديث : فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ"أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ"البقرة: 187- ، ونَزَلَتْ"وَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ"البقرة: 187. ولا يُخْرَج بتلك الأحكام عن أصولها الْمُتَيَقَنة لاستدلال أو دليل مشكوك فيه إما من جهة الثبوت أو الدلالة . عرف الجرجاني” الاستدلال: بأنه هو تقرير الدليل لإثبات المدلول- هنا - وقد نبه إلى ذلك العلائي ـ رحمه الله ـ في كتابه " المجموع الْمُذْهَب " ، وقال " ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلها " ومن ثَم يتبين أن القاعدة الكلية " اليقين لا يزال بالشك "، لها موردان- أي تطبق وتصب على شيئين- الأول :الأدلة الشرعية ، عند إعمال قاعدة " استصحاب الأصل " ، لأن الأصل له حكم اليقين . الثاني:أفعال المكلَّف ، عند اشتباه أسباب الحكم عليه. وهذا المورد هو المقصود أصالةً من القاعدة ، قاله ابن القيم ـ رحمه الله ـ في " بدائع الفوائد " . وهذا كله عندما يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك ، فَتُستصحَب ولا ينتقل عنها إلا بيقين ، وهذا جزم به الجمهور ، ونص عليه ابن القيم في كتابه السابق . قال ابن القيم : في " بدائع الفوائد " : " ينبغي أن يُعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألْبتة ، وإنما يعرض الشك للمكلف " .ا . هـ .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 66 . *أمثلة تطبيقية على القاعدة : _________ *إذا أكل الصائم شاكًّا في طلوع الفجر ، صح صومه ، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الفجر . أما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ، لم يصح صومه ، لأن الأصل بقاء النهار ، فلا يجوز أن يأكل مع الشك ، وعليه القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء عليه حينئذ. *من شك في حصول الرضاع بينه وبين امرأة أجنبية ، فيبنِ على الأصل المتيقَّنِ ، وهو كونُها أجنبية عنه . *من شك في طلاق امرأته ، فإنه يبني على الأصل المتيقن ، وهو بقاء الزوجية . منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . *وإذا شك كذلك هل طلق امرأته طلقة أو طلقتين فنقول: المتيقن هو طلاق مرة، وأما القدر الزائد فهو مشكوك فيه. وهكذا، فاليقين لا يزول بالشك.شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد = هنا = وهذا لو كان في الطَلْقة الأولى أو الثانية قد يكون الأمر سهلًا، لكن لو جاءنا شخص يريد أنْ يُثبت الطلاق عند القاضي، يعني يقول: أنا طلقت وأريد إثبات هذا الطلاق، القاضي مباشرة سوف يسأله:هل طلقت قبل هذه الطَلْقة أو لا؟ لأنّ هذا له أثرٌ في الحكم، فإذا قال: إنني طلقت قبل هذه الطَلْقة طلقة جازمًا بها وطَلْقة متردد فيها! يعني يقول: طلقتُ قبل عشر سنوات لكنني متردد لا أدري هل طلقتُ أم لم أطلق! وقبل سَنَة جازم بالطلْقة، وهذه الآن الطلقة التي يريد أنْ يُثبتها، بناءً على هذا يتحقق منه القاضي بالطلقة الأولى، إنْ كان عنده غلبة ظن عمل بهذا الظن وأثبت الطلقة وصارت الطلْقة الأخيرة هذه هي الثالثة، فتَبِيْنُ منه المرأة بينونة كبرى لا تحلّ إلّا لرجل ينكحها ويطؤها ثم يفارقها بموت أو طلاق، وأمّا إذا قال: إنّ الطَلْقة الأولى أنا متردد فيها تردد يستوي فيه الاحتمالان؛ فحينئذٍ الأصل عدم وقوع هذا الطلاق، فيكون قد طلَّق طلقتين فقط فلا تَبِيْنُ منه المرأة بينونة كبرى، هذا يدلك على أنّ المسألة مهمة ويترتب عليها أمور عظيمة جدًا.= هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. *من أتم صلاتَهُ وفرغ منها ، ثم شك في زيادة أو نقص ، فهذا الشك لا يؤثر ، فصلاته تامة لأن الأصل التمام ، ثم طرأ شك ، فلا يُعوَّل عليه لكن من شك أثناء الصلاة فهذا له حكم آخر مفصل بكتب الفقه . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف . *إذا كنت متيقنًا أنك على وضوء وعندك شك هل حصل ناقض لهذا الوضوء أم لا، فأنت -مثلاً- متيقن أنك توضأت لصلاة المغرب، فلما حضرت صلاة العشاء صرت لا تدري هل انتقض الوضوء أم لا؟ فنقول: المتيقن هو الوضوء والناقض مشكوك فيه، وعلى ذلك فنأخذ بالمتيقن وهو الوضوء فنقول: أنت على وضوء، واليقين لا يزول بالشك. *وإذا كان الأمر بالعكس، كأن تيقنت الناقض وشككت في الوضوء بعده؛ فمثلًا تقول: إنك قد قضيت حاجتك بعد صلاة المغرب ،وتقول: أنا لا أدري هل توضأت بعد أن قضيت حاجتي أم لا؟ فنقول: هنا المتيقن هو الحدث والوضوء مشكوك فيه، وعلى ذلك فخذ بالمتيقن وهو عدم الوضوء، فاليقين لا يزول بالشك. *إذا كنت لا تدري في صلاتك هل صليت ثلاثًا أم أربعًا، فالمتيقن هو الأقل، فتصلي رابعة وتسجد للسهو قبل السلام. *وإذا كنت في الطواف فحصل عندك شك هل طفت ستًا أم سبعًا، فنقول: الأقل هو المتيقن، فأنت في حكم من طاف ستة أشواط وعليك أن تطوف الشوط السابع. شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد = هنا = * الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: فلو أن إنسانًا استيقظ من النوم لما أراد أن يصلي الظهر وجد في ثيابه أثر مَنِيّ ـ للاحتلام ـ فأشكل عليه هل هذا من نومه بعد صلاة الفجر فتكون صلاة الفجر صحيحة ؟ أم أنه من الليل فيلزمه الاغتسال ثم إعادة صلاة الفجر ؟ . نقول : إذا لم يتأكد ولم تقم قرائن ، فالأصل إضافة الحال إلى أقرب أوقاته ، وعلى هذا نحكم بأنه من نومه بعد صلاة الفجر ، وبِنَاءً على ذلك نحكم بصحة صلاة الفجر . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله : عمن وجد منيًّا في ثيابه بعد أن صلى الفجر ولم يعلم به فما الحكم في ذلك ؟ . فأجاب : إذا لم ينم الإنسان بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وهو جنب حيث تيقن أنه قبل الصلاة . أما إذا كان الإنسان قد نام بعد صلاة الفجر ولا يدري هل هذه البقعة من النوم الذي بعد الصلاة أو من النوم الذي قبل الصلاة فالأصل أنها مما بعد الصلاة ، وأن الصلاة صحيحة ، وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها ، فليجعله من الليلة القريبة ويجعله من آخر نومة نامها ؛ لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه ، والشك في الحدث لا يوجب الطهارة منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد" ،رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، والله الموفق . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " 11 / السؤال رقم: 165 = هنا= |
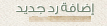 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 12:46 PM





 العرض المتطور
العرض المتطور
