|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
تفسير سورة آل عمران من آية 133إلى آية 152 "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"133. لمَّا بيَّن تعالى أنَّ أهل الجنَّة هم المتَّقون، أَعقَب ذلك بذِكْر قيام هؤلاء المتَّقِين بالمبادرة بأعمالٍ صالحة جليلة تؤهلهم لنَيل هذا الفضل العظيم ، فأمرهم - سبحانه - بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة التى توصلهم إلى مغفرة اللهِ ورضوانِهِ وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها ، ولقد عظم - سبحانه - بذلك شأن هذه المغفرة التي ينبغي طلبها بإسراع ومبادرة ، بأن جاء بها منكرة ، وبأن وصفها بأنها كائنة منه - سبحانه - هو الذي خلق الخلق بقدرته ، ورباهم برعايته . عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ: قال الزهري : إنما وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلا الله ، وهذا على التمثيل لا أنها كالسماوات والأرض لا غير.ا.هـ. فالأصل أن ما اتسع عرضه لم يضق ، وما ضاق عرضه دق ، فجعل العرض كناية عن السعة. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ:أي هيئت للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن محارم الله ، وجعلوا بينهم وبينها وقاية وساترًا ، وخافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم عن الهوى. "الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"134. ثم وصف المتقين وأعمالهم، فقال : الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ: أي: في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًا ولو قل. أي: إنَّ من صِفات المتَّقِين، أنَّهم يَتصدَّقون باستمرارٍ، وفي جميع الأحوال، سواء كانوا في حال سُرورٍ- بتوفُّر المال ورَغَد العيش؛ فلا يُلْهيهم ذلك عن مساعدة الآخرين- أو أصابَهم الضرُّ وضيقُ العيش؛ لقِلَّة ذاتِ اليد، فلا يَصرِفهم ذلك أيضًا عن مواصلةِ العطاء .فأصبحَ الإنفاقُ سَجِيَّةً دائمةً لهم، لا يَشغَلهم عنه أيُّ حالٍ أصابهم، ولا يَنشأ ذلك إلَّا عن نَفْس طاهرة. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ: أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم -وهو امتلاء قلوبهم من الحنق، الموجب للانتقام بالقول والفعل-، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. قال صلى الله عليه وسلم"مَن كَظَمَ غيظًا وهو قادرٌ على أن يَنْفِذَه دعاه اللهُ عزَّ وجلَّ على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ حتى يُخَيِّرُه اللهُ مِن الحُورِ ما شاءَ".الراوي : معاذ بن أنس - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4777 - خلاصة حكم المحدث : حسن. أَيْ: احتملَ الغضبَ في نفسِه وأمسَك عليه ولَم يُخرِجْه، وهو قادِرٌ على أن يَنتَصِر لنفسِه، وإمضاءِ غضبِه. دعاه اللهُ عزَّ وجلَّ على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ: أيْ: تباهَى اللهُ به يومَ القيامةِ، وشهَرَه بيْن النَّاسِ بأنَّه صاحِبُ هذه الخَصْلَةِ العظيمةِ؛ وذلك لأنَّه قهَر النفسَ الأمَّارةَ بالسُّوءِ، وتغلَّب عليها، وتجرَّع مرارَةَ الصَّبرِ في ذاتِ الله. حتى يُخَيِّرُه اللهُ مِن الحُورِ ما شاءَ : أي: حتَّى يُدْخِلَه الجَنَّة، ويَأخُذَ ما أَعْجبَه مِن نِساءِ أهلِ الجَنَّةِ، وفي هذا مِن الرِّفْعة والمَكانَة ما لا يعلمُه إلا اللهُ. *الكاظم غيظه يخير من الحور، فماذا للمرأة؟ الجواب : الأصل في أجور الأعمال الصالحة أن تكون للنساء كما هي للرجال.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"رواه أبو داود :236، والترمذي :113، وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 6 / 860. قال الله تعالى" وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا" النساء/124. ويستثنى من هذا : الجزاء المختص بالرجال دون النساء، فمن المعلوم أن الحور العين هي جزاء للرجال في الجنة لا للنساء، لكن المرأة تنال أصل هذا الجزاء وهو الوعد بالجنة؛ لأن الله تعالى إذا خير عبدًا في أي الحور شاء، فلازم هذا أن يدخل الجنة التي هي دار التمتع بالحور العين. فالمرأة التي تكظم غيظها وهي قادرة على إنفاذه ، موعودة بدخول الجنة ، ولها من الثواب الجزيل ما يشاؤه الله عز وجل لها .*الإسلام سؤال وجواب. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ: يدخل في العفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة، وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله، وعفا عن عباد الله رحمة بهم، وإحسانا إليهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم، لا على العبد الفقير، كما قال تعالى "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"الشورى :40. ثم ذكر حالة أعم من غيرها، وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ :والإحسان نوعان: -الإحسان في عبادة الخالق. والإحسان إلى المخلوق، فالإحسان في عبادة الخالق. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قالَ في حديث جبريل الطويل : ما الإحْسَانُ؟ قالَ: أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ "صحيح البخاري. -الإحسان إلى المخلوق، فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى، واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده. فالندى هو الكرم والجود. يعني أن تبذل الكرم والجود، والكرم ليس كما يظنه بعض الناس هو أن تبذل المال.- بل الكرم يكون في بذل النفس، وفي بذل الجاه، وفي بذل المال.- إذا رأينا شخصًا يقضي حوائج الناس يساعدهم يتوجه في شئونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه، ينشر علمه بين الناس، يبذل ماله بين الناس، فإنا نصفه بحسن الخلق؛ لأنه بذل الندى.كتاب العلم للعثيمين . "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ"135. والمعنى : سارعوا أيها المؤمنون إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدها خالقكم - عز وجل - للمتقين الذين من صفاتهم أنهم ينفقون أموالهم فى السراء والضراء ، ويكظمون غيظهم ، ويعفون عن الناس ، وأنهم إذا فعلوا فعلة فاحشة متناهية فى القبح ، أو ظلموا أنفسهم ، بارتكاب أي نوع من أنواع الذنوب " ذَكَرُوا اللَّهَ " أي تذكروا حقه العظيم ، وعذابه الشديد ، وحسابه العسير للظالمين يوم القيامة " فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ" أي طلبوا منه - سبحانه - المغفرة لذنوبهم التى ارتكبوها ، وتابوا إليه توبة صادقة نصوحًا . قال الفخر الرازى : واعلم أن وجه النظم من وجهين : الأول : أنه - تعالى - لما وصف الجنة بأنها معدة للمتقين بين أن المتقين قسمان : أحدهما : الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات ، وهم الذين وصفهم بالانفاق فى السراء والضراء ، وكظم الغيظ والعفو عن الناس . وثانيهما : الذين أذنبوا ثم تابوا وهو المراد بقوله - تعالى " والذين إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً " وبيَّنَ - سبحانه - أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى فى كونها متقية . والوجه الثاني : أنه في الآية الأولى ندب إلى الإحسان إلى الغير ، وندب فى هذه الآية إلى الإحسان إلى النفس ، فإن المذنب إذا تاب كانت توبته إحسانًا منه إلى نفسِه " . وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ : للإنكار والنفي. أي : لا أحد يقبل توبة التائبين ، ويغفر ذنوب المذنبين ، ويمسح خطايا المخطئين ، إلا الله العلي الكبير " الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل . "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا." الراوي : أبو موسى الأشعري - صحيح مسلم . وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ: بيان لشروط الاستغفار المقبول عند الله - تعالى - . أى أن من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ، سارعوا بالتوبة إلى الله - تعالى - ، ولم يصروا على الفعل القبيح الذي فعلوه ، وهم عالمون بقبحه ، بل يندمون على ما فعلوا ، ويستغفرون الله - تعالى - مما فعلوا ، ويتوبون إليه توبة صادقة . فهذه الآية الكريمة قد فتحت باب التوبة أمام المذنبين ، وحرضتهم على ولوجه بعزيمة صادقة ، وقلب سليم ، ولم تكتف بذلك بل بشرتهم بأنهم متى أقلعوا عن ذنوبهم ، وندموا على ما فعلوا ، وعاهدوا الله على عدم العودة على ما ارتكبوه من خطايا ، وردوا المظالم إلى أهلها ، فإن الله - تعالى - يغفر لهم ما فرط منهم ، ويحشرهم فى زمرة عباده المتقين. "أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ"136. أي : أولئك الموصوفون بتلك الصفات السابقة من الإنفاق في السراء والضراء ، وكظم الغيظ ، والعفو عن الناس . . إلخ " أولئك جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ " يعني: مغفرة كائنة من ربهم ،تستر ذنوبهم ، وتمسح خطاياهم . قال الشيخ العثيمين رحمه الله:المغفرة تتضمن الستر والمجاوزة وهي مأخوذة من المغفر ، والمغفر ألة يلبسها المقاتل على رأسه تغطيه وتحميه من ضرب السهام.أهل الحديث والأثر. . جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ : ونُكرت المغفرة، وهذا التنكير يُفيد التعظيم، يعني مغفرة عظيمة، يمحو الله ïپ• بها خطاياهم وجرائرهم، وهذه المغفرة كائنة من الرب -تبارك وتعالى-،مِّن رَّبِّهِمْ: وإذا أُضيفت إليه مِّن رَّبِّهِمْ فهذا يعني أن هذا الذي أضيف إلى العظيم الأعظم أنه عظيم وكبير. وهذا الاسم الكريم هنا في هذا الموضع مِّن رَّبِّهِمْ معنى التربيب والتربية، وهو الذي يتعاهد خلقه بما يغذوهم به، من النِعم الظاهرة والباطنة، وما إلى ذلك، فهذا من ألطافه ورحمته بعباده، وأنه يغفر ذنوبهم، ويقبل توبتهم، ويمحو خطاياهم. وَجَنَّاتٌ: والجنات هي البساتين، كثيرة الأشجار، تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. والتنكير في جنات أيضًا يدل على التعظيم، فإذا كانت شجرة واحدة في الجنة، كما يقول النبي"إنَّ في الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ، مِئَةَ عامٍ ما يَقْطَعُها."الراوي : أبو سعيد الخدري -صحيح مسلم. المُضَمَّرَ: أي: القَوِيَّ. مِئَةَ عامٍ ما يَقْطَعُها: أي: يَمْشي الرَّاكبُ برَكوبَتِه في ظلها ونَعيمها لا يصِلُ إلى نِهايتِها مع سَيرِه هذه المدَّةِ وبهذه السرعة؛ مُبالغةً في امتدادِ ظِلِّها.هذه شجرة واحدة بالجنة فكيف بسعة الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وفي الحَديثِ: بَيانُ سَعَةِ الجنَّةِ وعِظَمِ خَلْقِها. تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ: أنهار المياه العذبة، وأنهار اللبن، وأنهار الخمر، وأنهار العسل المُصفى.قال تعالى "مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ" محمد : 15. " فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ: غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة، ولا بمرارة، ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها، وأطيبها ريحًا، وألذها شربًا. خَالِدِينَ فِيهَا: الخلود:أي البقاء الأبدي السرمدي. أي: لا يخرجون منها أبدًا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ: فهذا مدح وثناء وإطراء للجزاء الذي منَّ عليهم به ، عملوا لله قليلا فأجروا كثيرًا ، وسماه أجرًا، وهذا من فضله على عباده، وإلا فإن أعمالهم بحد ذاتها لا تكون موفية لبعض نِعمه عليهم، ومع ذلك شرع لهم الأعمال، وهداهم إليها،وأرباهها لهم وأثابهم عليها أضعاف ما يستحقونه، وسمى هذا الثواب أجرًا، كالأجر الذي يُعطى للعامل كحق له على عمله ، مع أنه هو الموفق لهم لهذا العمل، وهو الذي شرعه وبينه، وأرسل الرسل، وهو الذي هداهم، وهو الذي قبل منهم وأرباه لهم ، فسماه أجرًا ، وهذا من فضله وكرمه ورحمته. قال تعالى "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"276البقرة: . يعني: يُنمّي الصَّدقات ويُكثرها ويُضاعفها. قال البخاري في صحيحه: حدَّثنا عبدالله بن منير:قال: أخبرنا كثير، أنه سمع أبا النَّصر: قال :حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:صلى الله عليه وسلم "مَن تَصَدَّقَ بعَدْلِ تَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، ولَا يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ، وإنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ" صحيح البخاري. "قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" 137. وهذه الآيات الكريمات، وما بعدها في قصة "أحد" يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم، ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة، امتحنوا، وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين، فلم يزالوا في مداولة ومجاولة، حتى جعل الله العاقبة للمتقين، والنصر لعباده المؤمنين، وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين، وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. " قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ" وأصل الخلو في اللغة : الانفراد . والمكان الخالي هو المنفرد عمن يسكن فيه . ويستعمل أيضًا في الزمان بمعنى المضي : لأن ما مضَى انفرد عن الوجود وخلا عنه ، وكذا الأمم الخالية . يقول تعالى مخاطبًا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد ، وقُتل منهم سبعونَ ،قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء ، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين .تفسير السعدي. ولهذا قال :فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ : أي : فسيروا في الأرض متأملين متبصرين ، فسترون الحال السيئة التي انتهى إليها المكذبون من تخريب ديارهم ، وبقايا آثارهم. فهذه الآية وأشباهها من الآيات ، تدعو الناس إلى الاعتبار بأحوال من سبقوهم . وإلى الاتعاظ بأيام الله ، وبالتاريخ وما فيه من أحداث ، وبالآثار التي تركها السابقون. "هَذا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ"138. والبيان : هو الدلالة التى تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة . والهُدَى : هو الإرشاد إلى ما فيه خير الناس فى الحال والاستقبال . والموعظة : هي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي من الأمور الدينية أو الدنيوية . هَذا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ:أي: دلالة ظاهرة، تبين الحق من الباطل للناس جميعا بر وفاجر ، وتبين أهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين سواء ماذُكِرَ في القرآن أو ما شوهد آثاره . وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ: أما من يهتدي ويتعظ من هذا البيان هم المتقون ، لأن المتقين هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد و الطَّريق القويم ، وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي والضلال والفساد، وأما باقي الناس فهي بيان لهم، تقوم به عليهم الحجة من الله، ليهلك من هلك عن بيِّنَة. قال الفخر الرازي ما ملخصه : اعلم أن الله - تعالى - لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية ، الغفران والجنات ، أتبعه بذكر ما يحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية . وهو تأمل أحوال القرون الخالية من المطيعين والعاصين فقال "قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ". وفي الآية تذكير لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلميوم أحد وإرشاد لهم إلى أنهم بين عاملي خوف ورجاء، فهي بشارة لهم بالنصر على عدوهم وإنذار بسوء العاقبة إذا هم حادوا عن سننه، وساروا في طريق الضالين ممن قبلهم، وعلى الجملة فالآية خبر وتشريع وتتضمن وعدًا ووعيدًا وأمرًا ونهيًا. "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"139. وبعد هذا البيان الحكيم ، يتجه القرآن إلى المؤمنين بالتثبيت والتعزية فينهاهم عن أسباب الفشل والضعف ، ويأمرهم بالصمود وقوة اليقين بأنهم الأعلون والعاقبة للمتقين إذا كانوا مؤمنين حقًا . وَلَا تَهِنُوا : أي: لا تَضعُفوا، وأصله ضعف الذات كما فى قوله - تعالى - حكاية عن زكريا"قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي" مريم : 4.أي ضعف جسمي . وهو هنا مجاز عن خور العزيمة ، وضعف الإرادة ، وانقلاب الرجاء يأسًا والشجاعة جبنًا ، واليقين شكًا ، ولذلك نُهُوا عنه . أي ولا تضعفوا عن القتال وما يتبعه من التدبير بسبب ما أصابكم من الجروح والفشل في يوم أُحد. ولا تحزنوا على من فقد منكم في هذا اليوم. وكيف يلحقكم الوهن والحزن وأنتم الأعلون. فقد مضت سنة الله أن يجعل العاقبة للمتقين الذين لا يحيدون عن سنته. بل ينصرون من ينصره ويقيمون العدل. فهم أجدر بذلك من الكافرين الذين يقاتلون لمحض البغي والانتقام، أو للطمع فيما في أيدي الناس. فهمة الكافر على قدر ما يرمي إليه من غرض خسيس، ولا كذلك همة المؤمن الذي يرمي إلى إقامة صرح العدل في الدنيا والسعادة الباقية في الآخرة - إن كنتم مؤمنين بصدق وعد الله بنصر من ينصره. وجعل العاقبة للمتقين المتبعين لسنته في نظم الاجتماع، حتى صار ذلك الايمان وصفًا ثابتًا لكم حاكمًا نفوسكم وأعمالكم. " إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ "140. فقال الفخر الرازى : واعلم أن هذا من تمام قوله - تعالى " وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ " فبيَّنَ - تعالى - أن الذين يصيبهم من القرح لا يصح أن يزيل جدهم واجتهادهم في جهاد العدو ، وذلك لأنه كما أصابهم ذلك فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك ، فإذا كانوا مع باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب ، فبأولى لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة، والتمسك بالحق أولى . " إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ : والمراد هنا : الإصابة بالجراح ونحوها . والمعنى : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر ، ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ، ولم ثبطهم عن معاودتكم بالقتال فأنتم أولى أن لا تضعفوا . ونحوه " وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا "النساء: 104. "وقيل : كان ذلك يوم أحد ، فقد نالوا منهم قبل أنيخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : إن المعنى إن تصبكم الجراح في أُحد فقد أصيب القوم بجراح مثلها في هذه المعركة ذاتها . ويبدو لنا أن الظاهر هو الرأي الأول، وهو أن الكلام عن غزوتي بدر وأحد ، لأن الله - تعالى - قد ساق هذه الآية الكريمة لتسلية المؤمنين بأن ما أصابهم في أُحد من المشركين قد أصيب المشركون بمثله على أيدي المؤمنين في غزوة بدر ، فلماذا يحزنون أو يضعفون ؟ ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك " وَتِلْكَ الأيام نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الناس " ، ويؤيد هذا المعنى - كما سنبينه بعد قليل - .تفسير الوسيط. نُدَاوِلُهَا : من المداولة ، وهي نقل الشىء من واحد إلى آخر . أيام الدنيا هي دُول بين الناس ، لا يدوم سرورها ولا غمها لأَحدٍ منهم ، فمن سره زمن ساءته أزمان ، ومن أمثال العرب . الحرب سجال : والأيام دُول فهي تارة لهؤلاء وتارة لأولئك. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا: هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء، ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء، تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام، في الضراء والسراء، واليسر والعسر، ممن ليس كذلك. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ : وهذا أيضًا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قيَّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ : أي : والله - تعالى - لا يحب الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم وتخاذلهم عن نصرة الحق ، وإنما يحب المؤمنين الثابتين على الحق ، المجاهدين بأنفسهم وأموالهم فى سبيل إعلاء دين الله ، ونصره شريعته. "وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ"141. وَلِيُمَحِّصَ: أي: ليُطهِّر، ويَختبر، ويُنقِّي، والتمحيصُ: الابتلاءُ والاختبارُ، وأصلُ المحْص: تخليصُ الشَّيءِ، وتنقيتُه ممَّا فيه من عَيب . يقال : محصت الذهب بالنار ومحصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث . وَيَمْحَقَ: يُهلك، ويَنقص، وأصل المَحْق: النُّقصانُ، أو نقصانُ الشيءِ قليلًا قليلًا حتى يفنى . ولقدقدَّرَ- سبحانه - ما قدَّرَ فى غزوة أحد ، لكي يمحص أي يطهر المؤمنين ويصفيهم من الذنوب ، ويخلصهم من المنافقين المندسين بينهم ، ولكىي يهلك الكافرين ويمحقهم بسبب بغيهم وبطرهم . "أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ "142. بيَّنَ - سبحانه – في هذه الآية أن طريق الجنة محفوف بالمكاره ، وأن الوصول إلى رضا الله - تعالى - يحتاج إلى جهاد عظيم ، وصبر طويل، فهذا استفهام إنكاري، أي: لا تظنوا، ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب، وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته، والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها، وتمرينها عليها ومعرفة ما تئول إليه، تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها، ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال صلى الله عليه وسلم"حُفَّتِ الجَنَّةُ بالمَكارِهِ، وحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ".الراوي : أنس بن مالك - صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم "حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ، وحُجِبَتِ الجَنَّةُ بالمَكارِهِ."الراوي : أبو هريرة -صحيح البخاري. شرح الحديث : ما عِندَ اللهِ لا يُنالُ بالتَّمنِّي، وإنَّما ببَذلِ الجُهدِ في الطَّاعةِ، والتَّغلُّبِ على شَهَواتِ النَّفْسِ، وحَملِها على ما يُحِبُّه اللهُ ويَرضاهُ. وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قدْ حَجَبَ النَّارَ وسَتَرَها بالشَّهَواتِ؛ فلا يُوصَلُ إلى النَّارِ إلَّا بتَعاطي الشَّهَواتِ؛ إذْ هي مَحجوبةٌ بها، فمَن هَتَكَ الحِجابَ وَصَلَ إلى المَحجوبِ ووَقَعَ فيه. وقدْ حَجَبَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ الجَنَّةَ بالمَكارِه، والمُرادُ بالمكارِهِ ما أُمِرَ المُكلَّفُ به؛ كمُجاهَدةِ النَّفْسِ في العِباداتِ، والصَّبرِ على مَشاقِّها، والمُحافَظةِ عليها، واجتِنابِ المَنهيَّاتِ، وكَظْمِ الغَيظِ، والعَفْوِ والحِلْمِ، والصَّدَقةِ، والإحسانِ إلى المُسيءِ، والصَّبرِ عن الشَّهَواتِ، ونَحوِ ذلك. وأُطلِقَ عليها مَكارِهُ؛ لِمَشَقَّتِها على العامِلِ، وصُعوبَتِها عليه. وفي هذا تَحذيرٌ مِن اتِّباعِ الشَّهَواتِ، وحَثٌّ على الصَّبرِ على المَكارِه؛ لِأنَّه الطَّريقُ إلى الجَنَّةِ. وفي الحَديثِ: بَيانٌ لجَوامعِ كَلِمِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبَديعُ بَلاغتِه. وفيه: الأمرُ بالابتعادِ عن الشَّهواتِ؛ لأنَّها الطَّريقُ إلى النَّارِ، والصَّبرِ على المَكارهِ؛ لأنَّها الطَّريقُ إلى الجنَّةِ.الدرر السنية. " وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ"143. قال ابن جرير ما ملخصه : كان قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يشهدوا بدرًا ، يتمنون قبل يوم أحد يومًا مثل يوم بدر ، فيعطون الله من أنفسهم خيرًا ، وينالون من الأجر مثل ما نال أهل بدر ، فلما كان يوم أحد ، فر بعضهم وصبر بعضهم ، حتى أوفى بما كان عاهد الله عليه قبل ذلك ، فعاتب الله من فر منهم بقوله " وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الموت" . . . الآية . والخطاب فى الآية الكريمة للمؤمنين الذين لم يفوزوا بالشهادة في غزوة أُحد ، وهو خطاب يجمع بين الموعظة والملام . والمراد بالموت هنا الشهادة في سبيل الله ، أو الحرب والقتال لأنهما يؤديان إلى الموت . فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ: أي: ها قدْ حصَل لكم ما تمنَّيتموه من لِقاءِ الأعداءِ، وشاهدتُم بأمِّ أعينِكم يومَ أُحُد الموتَ وأسبابَه وشِدَّته، ومَن يموتُ مِن الناس، أبصرتُم ذلك عِيانًا، فلِمَ لمْ تَثبُتوا وتَصبروا؛ حتى تنالوا ما أردتموه من قبلُ.! ويجدر الإشارة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عن كِتَابِ رَجُلٍ مِن أَسْلَمَ، مِن أَصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُقَالُ له: عبدُ اللهِ بنُ أَبِي أَوْفَى، فَكَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ حِينَ سَارَ إلى الحَرُورِيَّةِ، يُخْبِرُهُ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ في بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، يَنْتَظِرُ حتَّى إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فيهم، فَقالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، ثُمَّ قَامَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَقالَ: اللَّهُمَّ، مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عليهم."الراوي : عبدالله بن أبي أوفى - صحيح مسلم. العَافِيةُ نِعمةٌ مِنَ النِّعَمِ التي يَنبَغي على المَرءِ أنْ يُدَاوِمَ على سُؤالِ المَوْلَى سُبحانَه وتَعالى إيَّاها. وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن تَمَنِّي لِقاءِ العَدُوِّ، وهذا غَيرُ تَمَنِّي الشَّهادةِ. وفيه: أنَّ الإنسانَ إذا لَقيَ العَدُوَّ فإنَّ الواجِبَ عليه أنْ يَصبِرَ. وفيه: الدُّعاءُ على المُشرِكينَ بالهَزيمةِ والزَّلزَلةِ. "أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ قدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الفَرْخِ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: هلْ كُنْتَ تَدْعُو بشَيءٍ، أَوْ تَسْأَلُهُ إيَّاهُ؟ قالَ: نَعَمْ؛ كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ ما كُنْتَ مُعَاقِبِي به في الآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لي في الدُّنْيَا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ! لا تُطِيقُهُ -أَوْ لا تَسْتَطِيعُهُ- أَفلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قالَ: فَدَعَا اللهَ له، فَشَفَاهُ."الراوي : أنس بن مالك - صحيح مسلم. اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً:وحَسَنةُ الدُّنيا يَدخُلُ فيها كُلُّ ما يَحسُنُ وُقوعُه عِندَ العَبدِ؛ مِن رِزقٍ هَنيءٍ واسعٍ حَلالٍ، وزَوجةٍ صالحةٍ، ووَلدٍ تقَرُّ به العَينُ، وراحةٍ، وعِلمٍ نافعٍ، وعَملٍ صالحٍ، ونَحوِ ذلكَ مِنَ المطالبِ المَحبوبَةِ والمُباحةِ. وحسنَةُ الآخرَةِ هي: السَّلامةُ منَ العُقوباتِ في القَبرِ والموقِفِ والنَّارِ، وحُصولُ رِضا اللهِ، والفوزُ بالنَّعيمِ المُقيمِ في الجَنَّة، والقُربُ مِنَ الله الرَّحمن الرَّحيم، والدُّعاءُ بالوقايةِ مِن عَذابِ النَّارِ، وما يُقرِّبُ إليها مِن شَهوةٍ وعَملٍ في الدُّنيا، فهذا الدُّعاءُ مِن الجوامعِ الَّتي تَتضمَّنُ خيْرَ الدُّنيا والآخرةِ. وفي الحديثِ: أنَّه لا يَنْبغي للعبدِ أنْ يَطلُبَ لنَفسِه البلاءَ، وإذا سَأل فإنَّما يَسأَلُ ما فيه خيرٌ. "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ"144. ثم تمضي السورة الكريمة في حديثها عن غزوة أُحد ، فتذكِّر المؤمنينَ بما كان منهم عندما أُشِيعَ بأن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد قُتِلَ ، وترشدهم إلى أن الآجال بيد الله ، وأن المؤمنين الصادقين قاتلوا مع أنبيائهم في سبيل إعلاء كلمة الله بدون ضعف أو ملل فعليهم أن يتأسوا بهم في ذلك ، وأن الله - تعالى - قد تكفل بأن يمنح المؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيله أجرهم الجزيل في الدنيا والآخرة . قال ابن كثير : لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أُحد ، وقُتِلَ منً قُتِلَ مِنهم ، رجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلتُ محمدًا . وإنما قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه . فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس ، واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ، فحصل ضعف ووهن وتأخر - بين المسلمين - عن القتال . ففى ذلك أنزل الله تعالى "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ....". "أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَومَ أُحُدٍ، وَشُجَّ في رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عنْه، ويقولُ: كيفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهو يَدْعُوهُمْ إلى اللهِ؟! فأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ"آل عمران: 128.الراوي : أنس بن مالك - صحيح مسلم. فأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ :أي: ليس إليكَ مِن إصلاحِهم ولا مِن عذابِهم شيءٌ، وقيل: ليس إليكَ من النصرِ والهزيمةِ شيءٌ؛ فإنَّما هو لِأَجْلِنا وفِينَا ومِن جَرَّانَا، ونحن المُجازُون عليه.الدرر السنية. يُخبرهم اللهُ تعالى أنَّ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غيرُ مخلَّد في الدُّنيا، إنما رسالته هي الخالده الباقية ، فمن تمسك بها فقد سعد وفاز . ومن أعرض عنها فلن يضر الله شيئًا ،فإنَّما هو رسولٌ كباقي رُسل الله الذين من قبلِه؛ قد انقضتْ آجالهم في الدُّنيا بالموت أو القتْل؛ فهل إذا انقضَى أجلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكون هذا مبرِّرًا لأن تنقلبوا على أعقابكم بترك ما جاءكم من إيمان أو جهاد، أو غير ذلك.! وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا :ومَن يَرتدِدْ عن دِينه أو يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يضر نفسه، بتعريضها للسخط والعذاب ، وبحرمانها من الأجر والثواب . فالله تعالى غني عنه، وسيقيم دينه، ويعز عباده المؤمنين، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ: وسيُثيب الله الشَّاكرين. الثابتين على الحق والصابرين على الشدائد الشاكرين له نعمه في السراء والضراء ، والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه حتى ولو فُقِدَ القائد. وعبر هنا بالشاكرين ولم يعبر بالصابرين مع أن الصبر في هذا الموطن أظهر ، وذلك لأن الشكر في هذا المقام هو أسمى درجات الصبر ، لأن هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين وقفوا إلى جانب النبى - صلى الله عليه وسلم - في ساعة العُسْرة ، لم يكتفوا بتحمل البلاء معه فقط ، بل تجاوزوا حدود الصبر إلى حدود الشكر على هذه الشدائد التى ميزت الخبيث من الطيب ، فالشكر هنا صبر وزيادة ، وقليل من الناس هو الذي يكون على هذه الشاكلة. فالآية الكريمة قد تضمنت عتابا وتوبيخا لأولئك المسلمين الذين ضعف يقينهم ، وفترت همتهم ، عندما أرجف المرجفون في غزوة أُحد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قُتِل . كما تضمنت الثناء الجزيل على أولئك الثابتين الصابرين الذين لم تؤثر في قوة إيمانهم تلك الأراجيف الكاذبة ، بل مضوا في جهادهم وثباتهم بدون تردد أو تزعزع ولقد كان الثابتون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كثيرين ومن بينهم أنس بن النضر - رضي الله عنه - ، فقد ورى البخارى عن أنس - رضى الله عنه – قال: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بنُ النَّضْرِ عن قِتَالِ بَدْرٍ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، غِبْتُ عن أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ ما أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ وانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعْتَذِرُ إلَيْكَ ممَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ -يَعْنِي أَصْحَابَهُ- وأَبْرَأُ إلَيْكَ ممَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ -يَعْنِي المُشْرِكِينَ-، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ، فَقالَ: يا سَعْدُ بنَ مُعَاذٍ، الجَنَّةَ ورَبِّ النَّضْرِ، إنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِن دُونِ أُحُدٍ، قالَ سَعْدٌ: فَما اسْتَطَعْتُ يا رَسولَ اللَّهِ ما صَنَعَ، قالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا به بِضْعًا وثَمَانِينَ ضَرْبَةً بالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً برُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بسَهْمٍ، ووَجَدْنَاهُ قدْ قُتِلَ وقدْ مَثَّلَ به المُشْرِكُونَ، فَما عَرَفَهُ أَحَدٌ إلَّا أُخْتُهُ ببَنَانِهِ، قالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُرَى -أَوْ نَظُنُّ- أنَّ هذِه الآيَةَ نَزَلَتْ فيه وفي أَشْبَاهِهِ: "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ"الأحزاب: 23، إلى آخِرِ الآيَةِ. وَقالَ: إنَّ أُخْتَهُ -وهي تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ- ....."الراوي : أنس بن مالك - صحيح البخاري. "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ" 145. ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتَّم عليه بالقدر أن يموت، مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه، فلو أتى من الأسباب كل سبب، لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى " وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" الأعراف 34. فالآية الكريمة قد تضمنت تحريض المؤمنين على القتال . وتحذيرهم من الجبن والفرار ، لأن الجُبن لا يؤخر الحياة ، كما أن الإقدام لا يؤدي إلى الموت قبل حلول وقته ، فإن أَحدًا لا يموت قبل أجله ، وإن خاض المهالك واقتحم المعارك ثم مدح - سبحانه - الذين يبتغون بأعمالهم ثواب الآخرة فقال "وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخرة نُؤْتِهِ مِنْهَا " . أي ومن يرد بعمله وجهاده ثواب الآخرة وما ادخره الله فيها لعباده المتقين من أجر جزيل نؤته منها ما نشاء من عطائنا الذين تشتهيه النفوس ، وتقر له العيون . فتضمنت الآية الكريمة دعوة المؤمنين إلى الزهد في متع الحياة الدنيا ، وإلى أن يجعلوا مقصدهم الأكبر في تحصيل ما ينفعهم في آخرتهم ، فإن هذا هو المقصد الأسمى ، والمطلب الأعلى ، وإن الذين خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم التي أمرهم بالثبات فيها جريا وراء الغنائم ، لم يحصلوا منها شيئًا ، بل فقدوها وفقدوا أرواحهم وعزتهم وكرامتهم ، وكان فعلهم هذا من أسباب هزمية المسلمين في غزوة أحد. فكان أمر رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح الثبات والالتزام بمواقعهم .قال لاصلى الله عليه وسلم " انضَحوا الخيلَ عنَّا بالنَبلِ، لا يَأتونا مِن خلفِنا ! إن كانَت الدَّائرةُ لَنا أو علَينا فالزَموا أماكنَكم، لا نُؤتينَّ مِن قِبلِكم وفي روايةٍ قال لهم: احموا ظُهورَنا، إن رأيتُمونا نُقتَلُ فلا تنصُرُونا، وإن رأيتُمونا نَغنمُ فلا تَشرَكونا ."الراوي : محمد بن إسحاق - المحدث : الألباني - المصدر : فقه السيرة.- الصفحة أو الرقم : 251 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. الشرح: احموا ظُهورَنا، أي: خَلْفَنا، فإن رَأيتُمونا نُقتَلُ فلا تَنصُرونا، وإن رَأيتُمونا نَغنَمُ فلا تَشرَكونا، أي: لا تَكونوا مُشارِكينَ لَنا؛ لأنَّكُم إن فعَلتُم ذلك تَرَكتُم ظُهورَنا للعَدوِّ فيَتَمَكَّنوا مِنَّا، وهذا ما حَصَلَ في تلك الغَزوةِ؛ فقد خالَف الرُّماةُ ما أمَرَهمُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وذلك أنَّهم لَمَّا رَأوا المُسلمينَ انتَصَروا على الكُفَّارِ، وبَدَأ المُسلِمونَ يَأخُذونَ الغَنائِمَ، نَزَلَ الرُّماةُ مِنَ الجَبَلِ حَتَّى يَأخُذوا نَصيبَهم مِنَ الغَنائِمِ، فالتَفَّ المُشرِكونَ مِن خَلفِ الجَبَلِ وصَعِدوا عليه ووقَعَتِ الدَّائِرةُ على المُسلمينَ وأُصيبَ فيها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم! وفي الحَديثِ بَيانُ مَعرِفةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بإدارةِ الحَربِ والمَعرَكةِ. وفيه أهَمِّيَّةُ طاعةِ الأميرِ وعَدَمِ مُخالَفةِ أمرِه .الدرر السنية. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ : تذييل مقرِّرٌ لمضمون ما قبله ، ووعد من عطاء الله لمن شكره على نعمه ويثبت على شرعه .أي وسنجزي الشاكرين في دنياهم بما يسعدهم ويرضيهم . وسنجزيهم في الآخرة بما يشرح صدورَهُم ، ويُدخِل البهجةَ على نفوسِهم .ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، قلة وكثرة وحسنا. "وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ"146. ثم بيَّنَ - سبحانه - ما كان عليه أتباع الأنبياء السابقين من إيمان عميق ، وعزم وثيق ، حتى يتأسى بهم كل ذي عقل سليم. والربيون جمع رِبي وهو المتبع لشريعة الرب مثل الرباني ، والمراد بهم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبياء . ويجوز في رائه الفتح ، على القياس ، والكسر ، على أنه من تغييرات النسب وهو الذي قرئ به في المتواتر . ومحل العبرة هو ثبات الربانيين على الدين مع موت أنبيائهم ودعاتهم . والمعنى : وكثير من الأنبياء قاتل معهم مؤمنون صادقو الإيمان من أجل إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأصيبوا وهم يقاتلون بما أصيبوا من جراح وآلام ، " فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله " أي فما عجزوا أو جبنوا بسبب ما أصابهم من جراح ، أو ما أصاب أنبياءهم وإخوانهم من قتل واستشهاد . لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله وطاعته وإقامة دينه ، ونصرة رسله . وقوله " وَمَا ضَعُفُواْ" أي : عن قتال أعدائهم وعن الدفاع عن الذى آمنوا به وقوله " وَمَا اسْتَكَانُوا" أي ما خضعوا وذلوا لأعدائهم . الله - تعالى - قد نفى عن هؤلاء المؤمنين الصادقين ثلاثة أوصاف لا تتفق مع الإيمان . نفى عنهم - أولا - الوهن وهو اضطراب نفسي ، وهلع قلبي ، يستولى على الإنسان فيفقده ثباته وعزيمته . ونفى عنهم - ثانيًا - الضعف الذى هو ضد القوة ، وهو ينتج عن الوهن . ونفى عنهم - ثالثًا - الاستكانة وهي الرضا بالذل والخضوع للأعداء ليفعلوا بهم ما يريدون . وقد نفى - سبحانه - هذه الأوصاف الثلاثة عن هؤلاء المؤمنين الصادقين مع أن واحدًا منها يكفي نفيه لنفيها لأنها متلازمة - وذلك لبيان قبح ما يقعون فيه من أضرار فيما لو تمكن واحد من هذه الأوصاف من نفوسهم . وجاء ترتيب هذه الأوصاف في نهاية الدقة بحسب حصولها في الخارج ، فإن الوهن الذي هو خور في العزيمة إذا تمكن من النفس أنتج الضعف الذي هو لون من الاستسلام والفشل . ثم تكون بعدهما الاستكانة التي يكون معها الخضوع لكل مطالب الأعداء وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة في حياته كان الموت أكرم له من هذه الحياة. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ: تذييل قُصِدَ به حض المؤمنين على تحمل المكاره وعلى مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره من أجل إعلاء دينهم حتى يفوزوا برضا الله كما فاز أولئك الأنقياء الأوفياء . أي والله - تعالى - يحب الصابرين على آلام القتال ، ومصاعب الجهاد ، ومشاق الطاعات ، وتبعات التكاليف التى كلف الله - تعالى - بها عباده . "وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ"147. أي أن هؤلاء الأنقياء الأوفياء الصابرين ما كان لهم من قول في مواطن القتال وفي عموم الأحوال إلا الضراعة إلى الله - بثلاث أمور : أولها: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا : والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما حرم، أي : إنهم يدعون الله - تعالى - بأن يغفر لهم ذنوبهم ما كان صغيرا منها وما كان كبيرا : وأن يغفر لهم إسرافهم فى أمرهم أي ما تجاوزوه من الحدود التي حدها لهم سبحانه وأمرهم بعدم تجاوزها. فقد علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. ثانيها : وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا : ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله، وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين، أي أجعلنا يا ربنا ممن يثبت لحرب أعدائك وقتالهم ولا تجعلنا ممن يوليهم الأدبار . ثالثها: وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ: وسألوه سبحانه أن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده، والتوبة والاستغفار، والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. " فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" 148. ثم بين - سبحانه - الثمار التى ترتبت على هذا الدعاء الخاشع والإيمان الصادق والعمل الخالص لوجهه. الفاء فى قوله " فَآتَاهُمُ "لترتيب ما بعدها على ما قبلها. لَمَّا أتمَّ سبحانه الثناءَ على فِعل الرِّبِّيِّين في الصَّبر، وطريقتِهم في الدُّعاء، ذكَر ما سبَّبه لهم ذلك من الجَزاء في الدُّنيا والآخِرة. " فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ: أي: إنَّ الله تعالى قد منَحهم بفضله جزاءً في الدنيا، كالنَّصرِ على الأعداءِ، والظَّفر بالغنائمِ، وغيرِ ذلك، وضمَّ لهم مع أجْر الدنيا جزاءَ الآخرة الحَسَن، من الفوز برِضوانِ الله تعالى، والخلودِ في دار السَّعادة الأبديَّة. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: فالإحسان مع الله تعالى: هو أن يعلم العبد أن الله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن يراقبه في صلاته أو غيرها، في خشوع ورهبة حتى كأنه يرى الله عيانًا، فإذا لم يستطع فليعلم أن الله مطلع عليه، وأنه بين يدي علَّام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما قال جبريل عليه السلام لمحمد صلوات الله وسلامه عليه حينما سأله عن الإحسان فقال له "الإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبَدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" فالإحسان مع الله: هو أن يراقب الإنسان الله في حركاته وسكناته، وأن يدرك تمام الإدراك أن الله علّام الغيوب يراه؛ وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.فتُري اللهَ منك كل خير،بأداء الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في أنواع الخير التي لا تجب عليك. هكذا المحسن، يحرص على كل خير من واجب ومستحب ويتباعد عن كل شر وعن كل ما ينبغي تركه ولو كان غير محرم .سبحانه يحب المحسنين في عبادة الخالق ومعاملة الخلق، ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء، كفعل هؤلاء الموصوفين. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ "149. وجه القرآن نداء إلى المؤمنين ، نهاهم فيه عن طاعة أعداء الله وأعدائهم ، وأمرهم بالتمسك بتعاليم دينهم وبشرهم بسوء عاقبة أعدائهم . والنداء متوجه ابتداء للمؤمنين المجاهدين الذين حضروا غزوة أحد ، وسمعوا ما سمعوا من أراجيف أعدائهم وأكاذيبهم ، إلا أنه يندرج تحت مضمونه كل مؤمن في كل زمان أو مكان لأن الكافرين في كل العصور لا يريدون بالمؤمنين إلا كل شر وفساد ، ولا يتمنون لهم إلا الشرور والمصائب . فقد كانت الهزيمة في أُحد مجالا لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة . وكانت المدينة لم تخلص بعد للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة أحاطتها " بدر " بسياج من الرهبة ، بما كان فيها من النصر الأبلج . فلما كانت الهزيمة في أُحُد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة لهؤلاء الأعداء المتربصين أن يُظهروا أحقادَهم ، وأن ينفثوا سمومهم ؛ وأن يجدوا في جو الفجائع التي دخلت كل بيت من بيوت المسلمين - وبخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المثخنة - ما يساعد على ترويج الكيد والدس والبلبلة في الأفكار والصفوف . قال الآلوسي : ما ملخصه : قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إِن تُطِيعُواْ الذين كَفَرُواْ " شروع في زجر المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارها ، إثر ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء ببيان فضائله وتصدير الخطاب بالنداء والتنبية لإظهار الاعتناء بما في حيزه ،ووصَفَهُم بالإيمان لتذكيرهم بحال ينافي تلك الطاعة فيكون الزجر على أكمل وجه . والمراد من الذين كفروا إما المنافقون لأنهم هم الذين قالوا للمؤمنين عند هزيمتهم فى أحد : ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم . . وإما أبو سفيان وأصحابه وحينئذ فالمراد بطاعتهم الاستكانة لهم وطلب الأمان منهم . . وإما اليهود والنصارى لأنهم هم الذين كانوا يلقون الشُّبه في الدين ويقولون : لو كان محمدٌ نبيًا حقًا لما غلبه أعداؤه . . وإما سائر الكفار " .ا.هـ. وجاء التعبير : بإن الشرطية "إِن تُطِيعُوا " دون " إذا " ؛ لأن إذا لتحقق الشرط والجزاء أما إن فإنها لا تفيد التحقق بل تفيد الشك ، وهذا هو المناسب لحال المؤمنين لأن إيمانَهم يمنعهم عن الوقوع في طاعة الذين كفروا . ثم بين - سبحانه - النتيجة - السيئة التى تترتب على طاعة المؤمنين للكافرين فقال :يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ: أي : إن تطيعوهم يرجعوكم إلى ما كنتم عليه قبل الإسلام من ضلال وكفران أو يردوكم إلى الحالة التى كنتم عليها قبل مشروعية الجهاد وهي حالة الضعف والهوان التي رفعها الله عنكم بأن أذن لكم في مقاتلة أعدائكم الذين أخرجوكم من دياركم بغير حق . وقوله : فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ : أي فترجعوا هالكين، قد خسرتم أنفسكم، وضللتم عن دينكم، وذهبت دنياكم وآخرتكم. "بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ"150. بعد أن حذر المؤمنين من طاعة الكافرين وما يترتب عليها من مضار ، انتقل إلى توجيههم إلى ما فيه عزتهم وكرامتهم وسعادتهم . أي لا تتخذوا الذين كفروا أولياء ، ولا تأبهوا لإغوائهم فإنهم لا يستطيعون لكم نصرًا، وإنما الله هو الذي ينصركم بعنايته التي وعدكم بها في قوله" فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ"الأنفال:40. والمولى هنا بمعنى النصير والمعين. والمعنى إني أنهاكم - أيها المؤمنون - عن طاعة الكافرين ، لأنهم ليسوا أولياء لكم فتطيعوهم ، بل الله - تعالى - هو وليكم ومعينكم وهو خير الناصرين ، لأنه هو الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء فأخلصوا له العبادة والطاعة . ""سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ" " 151. من ولايته ونصره لهم سبحانه أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد حدث ذلك بالفعل، وذلك أن المشركين -بعدما انصرفوا من واقعة "أُحد" - تشاوروا بينهم، وقالوا: كيف ننصرف، بعد أن قتلنا منهم من قتلنا، وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بالرجوع لقتال المسلمين مرة أخرى، فألقى الله الرعب في قلوبهم، فانصرفوا خائبين، ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفًا من الذين كفروا أي: جانبًا منهم وركنا من أركانهم، إما بقتل، أو أسر، أو استيلاء على بلد، أو غنيمة مال، فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون ، أو يكبتهم أي يرجعون بخسارة وغم وحسرة، فينقلبوا خائبين، أي : لم يحصلوا على ما أملوا . وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين،فقال: ......بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا: أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام، التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة، من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن، فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد وأعظم، ولهذا قال "وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ " :أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ :بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. المأوى والمثوى كلمتان تدلّان على مكان اللجوء ومكان الإقامة، ولا علاقة لأي منهما في ذاتها بالجنة والنار. "وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"152. أنَّه لَمَّا وعَد اللهُ تعالى المؤمنين في الآية المُتقدِّمة إلقاءَ الرُّعبِ في قلوب الذين كفروا، أكَّدَ ذلك بأنْ ذَكَّرهم ما أَنجَزهم من الوعدِ بالنَّصرِ في واقعةِ أُحُد؛ فإنَّه لَمَّا وعدَهم بالنُّصرةِ بشرْط أنْ يتَّقُوا ويَصبِروا؛ فحينَ أَتَوْا بذلك الشَّرطِ لا جَرَمَ وفَّى اللهُ تعالى بالمشروطِ وأعطاهم النُّصرةَ، فلمَّا تَركوا الشَّرطَ لا جرَمَ فاتَهم المشروطُ ، فقال: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ: أي: إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أَنجَز لكم ما وعَدَكم به يومَ أُحدٍ أيُّها المؤمنون، وهو نصْركم على عَدوِّكم، وكان ذلك في بدايةِ المعركة حين طفِقتُم تَستأصِلونهم بقتْلهم قتلًا ذريعًا، وذلك قد وقَع عن أَمرِ اللهِ تعالى شرعًا وقدَرًا . حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ : أي: لَمَّا استولَى عليكم الضَّعفُ والخَوَرُ، وجَبُنتم عن القِتال، ووقَع الخلافُ بين رُماتكم؛ هل يَلزَمون ثُغُورَهم- كما عهِد إليهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أم يتحرَّكون لجمْعِ الغنائم، وعصَى بعضُكم في النِّهاية أمْرَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، مِن بعدِ أنْ أَظهَر الله تعالى لكم ما تُحِبُّونه من انهزام الكفَّار، وتوليتهم الأدبار، فلمَّا وقع ذلك كلُّه، حلَّت بكم الهزيمةُ . عن البَرَاءِ بن عازبٍ رضِي اللهُ عنه، قال"لَقِينا المشركين يومئذٍ، وأجلَسَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جيشًا مِن الرُّماةِ، وأمَّرَ عليهم عبدَ الله - عَبدَ اللهِ بنَ جُبَيرٍ -، وقال: لا تَبرَحوا ، إنْ رأيتمونا ظهَرْنا عليهم فلا تَبرَحوا، وإنْ رأيتموهم ظهَروا علينا فلا تُعينونا، فلمَّا لَقِيناهم هرَبوا حتى رأيتُ النِّساءَ يَشتَدِدْنَ في الجبلِ، رفعْنَ عن سُوقِهنَّ، قد بدَتْ خَلاخلُهنَّ، فأخذوا يقولون: الغنيمةَ الغنيمةَ، فقال عبدُ اللهِ: عهِد إليَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألَّا تَبرَحوا! فأَبَوا، فلمَّا أبَوْا صُرِفت وجوهُهم، فأُصِيبَ سبعون قتيلًا، وأَشَرَفَ أبو سفيان، فقال: أفي القومِ محمدٌ؟ فقال: لا تُجيبوه، فقال: أفي القومِ ابنُ أبي قُحافَةَ؟ قال: لا تُجيبوه، فقال: أفي القوم ابنُ الخطابِ؟ فقال: إنَّ هؤلاء قُتِلوا، فلو كانوا أحياءَ لأجابوا، فلم يَملِكْ عمرُ نفسَه، فقال: كذبتَ يا عدوَّ اللهِ، أبقى اللهُ عليك ما يُخْزِيك، قال أبو سفيان: اعْلُ هُبَلُ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أجيبوه، قالوا: ما نقولُ؟ قال: قولوا: اللهُ أعلى وأجلُّ، قال أبو سفيانَ: لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم! قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أجيبوه، قالوا: ما نقولُ؟ قال: قولوا: اللهُ مولانا ولا مولى لكم، قال أبو سفيان: يومٌ بيومِ بدرٍ، والحربُ سِجَالٌ، وتجدون مُثْلَةً، لم آمرْ بها ولم تَسؤْني ".صحيح البخاري. والمُثْلةُ: قَطعُ الأُنوفِ وبَقْرُ البُطونِ، ونَحوُ ذلك لِلقَتْلى- ثمَّ نَوَّهَ أنَّ تِلكَ المُثْلةَ لم يَأمُرْ بها؛ لِأنَّها تُعَدُّ نَقيصةً في أدبِيَّاتِ الحُروبِ، ومع ذلك يُشيرُ أبو سُفيانَ إلى أنَّهُ لم تَسُؤْهُ تلك المُثْلةُ، فلم يَكرَهْ ما فُعِلَ بالمُسلِمينَ مِن تَمثيلٍ بالقَتْلى، وقدْ رَضيَ أبو سُفيانَ بتلك المُثلةِ في حَقِّ المُسلِمينَ، باعتِبارِ أنَّهم أعداءٌ له، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ أي: إنَّ بعضًا منكم- أيُّها المؤمنون- قد ابتَغَوا الدُّنيا، وهم الرُّماةُ الذين تَرَكوا أماكنَهم وأخَذوا في جمْعِ الغنائمِ والحُطامِ الفاني يَومَ أُحُد، والبعضَ الآخَرَ كانوا يَرغبونَ في أجْرِ الآخرةِ الباقي، وهم الرُّماةُ الذين لزِموا مَقاعدَهم التي أَقعَدَهم فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ: أي: بعدَ أنِ انصرفَ بعضُ الرُّماة من المؤمنين من أماكنهم، مُنصرِفين بذلك عن طاعةِ رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وانصرَفتْ قلوبُهم للدُّنيا، ردَّ الله وجوهَكم عن الكفَّار، فصارتِ الدَّائرة عليكم؛ امتحانًا مِن الله تعالى لكم، ليَتميَّز الطَّائعُ من العاصي، والصَّابرُ على البلاء من الجازِع . وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ: أي: إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد تَجاوَز عن عقوبة استئصالِكم جميعًا أيُّها الرُّماة، لمعصيتكم الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واستبدَل بها عقوبةً أخفَّ وطأة عليكم، وهي إلحاقُ الهزيمة بكم، وقَتْل بعضكم . وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: أي: إنَّ اللهَ تعالى صاحِبُ الفضلِ على جميعِ المؤمنين؛ لأجْلِ ما معهم من إيمانٍ، ومن ذلك: العَفوُ عمَّا يَقَعُ منهم من عِصيان . |
|
#2
|
||||
|
||||

تفسير سورة آل عمران من آية 153إلى آية 158 "إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"153. تُصْعِدُونَ :من الإصعاد وهو الذهاب في صعيد الأرض والإبعاد فيه. قال القرطبي : الإصعاد : السير في مستو من الأرض وبطون الأودية والشعاب . وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ : أي : لا تعرجون ولا تقيمون على أحد ولا يلتفت بعضكم إلى بعض. أي: اذكُروا- أيُّها المؤمنون- حين كنتُم تَجدُّون في الفِرارِ والإبعادِ في الأرض، ولا أحدَ منكم يَلتفِتُ إلى غيره أو يَنظُر إليه؛ إذ لم يكُن لديكم مِن همٍّ سِوى النَّجاةِ من الأعداء. يوم أُحد بعد أن اضطربت أحوالكم وجاء أعداؤكم من أمامكم ومن خلفكم بسبب ترك معظم الرماة لأماكنهم من أجل الغنائم. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ: أي: إنَّ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد خلَّفتموه وراءَ ظُهورِكم ممَّا يلي جِهةَ العدوِّ، وهو يدعوكم مِنْ خَلْفِكم إلى التَّوقُّفِ عن الفِرار والثَّبات، فلم تَلتفِتوا إليه. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ:فَجَازَاكُمْ، جَعَلَ الْإِثَابَةَ بِمَعْنَى الْعِقَابِ، وَأَصْلُهَا فِي الْحَسَنَاتِ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا مَوْضِعَ الثَّوَابِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى" فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ "آل عمران: 21. جَعَلَ الْبِشَارَةَ فِي الْعَذَابِ، وسميت العقوبة التي نزلت بهم ثوابًا على سبيل الاستعارة التهكمية كما فى قوله " فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ "آل عمران: 21. ويجوز أن يكون اللفظ مستعملا في حقيقته ، لأن لفظ الثواب في أصل اللغة معناه ما يعود على الفاعل من جزاء فعله ، سواء أكان خيرًا أو شرًا . وَمَعْنَاهُ: جَعَلَ مَكَانَ الثَّوَابِ الَّذِي كُنْتُمْ تَرْجُونَ " غَمًّا بِغَمٍّ " وَقِيلَ: الْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى، أَيْ: غَمًّا عَلَى غَمٍّ، وَقِيلَ: غَمَّا مُتَّصِلًا بِغَمٍّ. قال مجاهد وقتادة وغيرهما : الْغَمُّ الْأَوَّلُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ وَالْغَمُّ الثَّانِي: مَا سَمِعُوا أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُتِلَ ، وقيل الْغَمُّ الْأَوَّلُ مَا فَاتَهُمْ مِنَ الظَّفَرِ وَالْغَنِيمَةِ ؛ والثَّانِي : استِعْلَاءُ المشركينَ عَلَيْهِم . لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ : لكي لا تحزنوا على مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ وَالْغَمُّ ، وعلى مَا فَاتَكُمْ مِنَ الظَّفَرِ وَالْغَنِيمَةِ ، إذا تحققتم أن الرسولَ صلى اللهُ عليه وسلم لم يُقتل هانت عليكم تلك المصيبات. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ : أي: واللهُ تعالى هو وحْدَه العالمُ ببواطنِ ما تَعمَلونه من خيرٍ أو شرٍّ- أيُّها المؤمنون- ومِن ذلك: ما قُمتُم به في غزوةٍ أُحُد، كما أنَّ ما ترتَّبَ عليها من ابتلاءاتٍ ومِحَنٍ وأسرار، إنَّما هو صادرٌ عن كمال عِلْمه ببواطنِ الأمور. فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن كمال علمه بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم وعن حكمته ، ولهذا قال"وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" "ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ"154. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًايَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ: قال أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل " كُنْتُ فِيمَن تَغَشَّاهُ النُّعاسُ يَومَ أُحُدٍ حتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِن يَدِي مِرارًا؛ يَسْقُطُ وآخُذُهُ، ويَسْقُطُ فَآخُذُهُ."الراوي : أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل/ المصدر :صحيح البخاري /الصفحة أو الرقم: 4068/ صحيح. شرح الحديث : إذا حدَث للإنْسانِ ما يُسبِّبُ له الفَزعَ، أوِ الخَوفَ، أو عَدمَ الاستِقرارِ؛ تَسبَّبَ ذلك في حُدوثِ أرَقٍ وقلَّةِ نَومٍ، ممَّا يُؤدِّي إلى تَزايُدِ المَشقَّةِ، وقدْ جعَلَ اللهُ النُّعاسَ أمَنةً لأصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَربِهم ضِدَّ الكُفَّارِ، وهذا مِن فَضلِ اللهِ ونِعمَتِه. هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو طَلْحةَ الأنْصاريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه كان ممَّن نزَل به وغَطَّاه النُّعاسُ يَومَ أُحُدٍ، حتَّى إنَّه كان يَسقُطَ سيفُه مِن يَدِه مرَّةً بعْدَ أُخْرى، يَسقُطُ ويأخُذُه، وذلك لَمَّا وقَعَتْ يَومَ أُحُدٍ الهَزيمةُ في أصْحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكثُرَ القَتلُ فيهم؛ اشتَدَّ خَوفُهم، وقَويَ غمُّهم، فأنعَمَ اللهُ عليهم بأنْ أنْزَلَ عليهم بعْدَ الغَمِّ أمَنةً نُعاسًا، وأَمَّنَهم أمْنًا يَنامونَ معَه، كما قال تعالى"إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ"الأنفال: 11، والأمَنةُ، أي: الأمْنُ، والنُّعاسُ: أخَفُّ النَّومِ، والأمَنةُ بزَوالِ الخَوفِ؛ لأنَّ الخائِفَ لا يَنامُ، والنُّعاسُ كان فيه فَوائدُ؛ لأنَّ السَّهرَ يُوجِبُ الضَّعفَ والكَلالَ، والنَّومَ يُفيدُ عَودَ القوَّةِ والنَّشاطِ، ولأنَّ المُشرِكينَ كانوا في غايةِ الحِرصِ على قَتلِهم، فبَقاؤُهم في النَّومِ معَ السَّلامةِ في تلك المَعرَكةِ مِن أدَلِّ الدَّلائلِ على حِفظِ اللهِ تعالَى لهُم، وذلك ممَّا يُزيلُ الخَوفَ مِن قُلوبِهم، ويُورِثُهمُ الأمنَ، ... وقدِ استُشْهِدَ في تلك الغَزْوةِ عَدَدٌ كبيرٌ منَ الصَّحابةِ رِضوانُ اللهِ عليهم، وقد قاتَلَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومَن ثبَت معَه منَ الصَّحابةِ بقُوَّةٍ وشَجاعةٍ، رَغمَ تَخلخُلِ الصُّفوفِ بعْدَ مُخالَفةِ أمْرِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. وفي الحَديثِ: مَعيَّةُ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولُطفُه بعِبادِه المؤمِنينَ الصَّادِقينَ. وفيه: مَنقَبةٌ لأبي طَلْحةَ الأنْصاريِّ رَضيَ اللهُ عنه؛ لأنَّه كان ممَّن ثبَت يومَ أُحُدٍ.الدرر السنية. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين الله، ورضا الله ورسوله، ومصلحة إخوانهم المسلمين.تفسير السعدي. وأما الطائفة الأخرى الذين قال فيهم سبحانه: وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ: أي: إنَّ ثمَّة جماعةً أخرى مِن بين مَن خرجَ لأُحد، لم يَغْشَهم النعاسُ مِن شِدَّة قلقِهم واضطرابِهم على حياتِهم، وهم المنافِقون وضعاف الإيمان الذين لا همَّ لديهم غيرُ أنفسِهم التي يَحذرون من قتْلِها، فلم يكن إيمانهم صادقًا ،لم تكن صادقة في إيمانها لأنها كانت لا يهمها شأن الإسلام انتصر أو انهزم ولا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وإنما الذي كان يهمها هو شىء واحد وهو أمر نفسها وما يتعلق بذلك من الحصول على الغنائم ومتع الدنيا . يَظُنُّونَ بِاللَّهِ:أي: يظنُّ أفرادُ هذه المجموعةِ ظنونًا كاذبةً، كما هو دَيدنُ أهلِ الجهلِ بالله تعالى، وذلك حين رأوا هجمةَ المشركين على المسلمين، وإعمالَ القتْل فيهم؛ إذ ظنُّوا أنَّ دِينَ الله تعالى مُضمحِلٌّ وأتباعَه مَهزومون. هذه الطائفة لم تكتف بما استولى عليها من طمع وجشع وحب لنفسها بل تجاوزت ذلك إلى سوء الظن بالله بأن توهمت بأن الله - تعالى - لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام ليس دينًا حقًا وأن المسلمين لن ينتصروا على المشركين بعد معركة أحد . . . إلى غير ذلك من الظنون الباطلة التي تتولد عند المرء الذي ضعف إيمانه وصار لا يهمه إلا أمر نفسه. يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ:أي: قال هؤلاء الحريصونَ على سلامةِ أنفسِهم مُستنكِرين بأنَّهم لم يكونوا يَملِكون شيئًا من قرارِ خُروجِهم للقِتال. وهذا استفهام إنكاري، أي: ما لنا من الأمر -أي: النصر والظهور- شيء، فأساءوا الظن بربهم وبدينه ونبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله، قال الله في جوابهم: قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ : أي: قل- يا محمَّدُ- لهؤلاء المنافقين: إنَّ جميعَ الأمور، مُبتدَأها ومنتهاها لله تعالى وحده لا شريكَ له، فهو الذي يُصرِّفها كيف شاء، ويُدبِّرها كيفما أراد، فجميعُ الأمورِ بقضائِه وقدَره، ومِن ذلك خُروجُكم للقتال، وما يقَعُ فيه من نصْرٍ أو هزيمة، كما أنَّ العاقبةَ في النهاية لدِين اللهِ تعالى وأوليائِه، وإنْ وقَع عليهم ما وقَع. والأمر يشمل الأمر القدري، والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبة النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته، وإن جرى عليهم ما جرى. يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ :أي يضمرون في أنفسهم ما لا يستطيعون إعلانه لك، فهم يُظهِرُون أنهم يسألون مسترشدين طالبين النصر بقولهم "هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ" ويبطنون الإنكار والتكذيب. أي: إنَّ الذي كانوا يُخفونه عنك- يا محمَّدُ- هو قولهم فيما بينهم مُتحسِّرين ونادِمين: لو كان لنا في شَأنِ الخروجِ لهذا القِتال نَصيبٌ من الرأي والاختيارِ في ذلك، لَمَا اتَّخذنا قرارًا بالخروجِ مِن المدينة مُطلقًا، ولَمَا وقعتْ في صُفوفنا مَقتلةٌ. ثم بين الأمر الذي يخفونه، فقال: يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا: أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلنا هاهنا وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله، وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله: قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ: أي: قل- يا محمَّدُ- لأولئك المنافقين- ردًّا على قولِهم الذي أسرُّوه وأَطْلَعَك اللهُ تعالى عليه-: إنَّما وقَع ما وقَع بقدَر الله تعالى وحْدَه، وهو حُكمٌ ماضٍ لا بدَّ أن ينفُذ، فحتى لو كنتُم في بيوتِكم التي ليستْ بمظنَّةٍ لوقوعِ القتْل فيها، فسيخرُج منها مَن كتَب اللهُ تعالى عليه ذلك ويأتي الموضعَ الذي يَلقَى فيه مصرعَه. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ: أي: إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد قدَّر عليكم الخروجَ والقتل؛ ليختبرَ قلوبَكم. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ : التمحيص تخليص الشىء مما يخالطه مما فيه عيب له . ليخرج ويظهر، وليَميزَ الله تعالى ما في قلوبِكم من خَبيثٍ وطيِّب، ويُظهرَ أمْرِ المؤمِن والمنافِقِ للنَّاس في أقوالهم وأفعالهم. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ: أي: إنَّ اللهَ تعالى ذو عِلمٍ بكلِّ ما تُكنُّه صُدورُ عِبادِه، لا يَخفى عليه شيءٌ من ذلك، ومُجازٍ كلًّا منهم بحسبَه. لكنَّ حِكمتَه اقتضتْ أنْ يُقدِّر من الأسبابِ ما تَتبيَّن به مُخبَّاتُ الصُّدورِ. "إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ"155. أخبر - سبحانه - عن الذين لم يثبتوا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وبين السبب فى ذلك وفتح لهم باب عفوه. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ : من التولي ويستعمل هذا اللفظ بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار فإن كان متعديًا بنفسه كان بمعنى الإقبال كما في قوله - تعالى "وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ" المائدة: 56. وإذا كان متعديًا بعن أو غير متعد أصلا كان بمعنى الإعراض كما في الآية التي معنا."إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ" أي الذين فروا. والتولي الذي وقع فيه من ذكرهم الله - تعالى - في الآية التي معنا يتناول الرماة الذين تركوا أماكنهم التي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء فيها لحماية ظهور المسلمين كما يتناول الذين لم يثبتوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بل فروا إلى الجبل أو إلى غيره عندما اضطربت الصفوف . يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ :الجمعان مُثنّى ، والمراد بهما جمْع المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع المشركين بأُحُد. إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا: إنَّما أَوْقَعَهم الشيطانُ في تلك الزَّلَّة، وما تَسلَّط عليهم إلَّا بسببِ بعضِ ذُنوبهم. أي بسبب بعض ما اكتسبوه من ذنوب ، لأن نفوسهم لم تتجه بكليتها إلى الله فترتب على ذلك أن منعوا النصر والتأييد وقوة القلب والثبات . .فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخّص فيها الإنسان سهلت استيلاء الشيطان على نفسه، فهم قد انحرفوا عن أماكنهم بتأوّل، إذ ظنوا أنه ليس للمشركين رجعة من هزيمتهم، فلا يترتب على ذهابهم وراء الغنائم فوات منفعة ولا وقوع في ضرر، ولكن هذا التأويل كان سببًا في كل ما جرى من المصائب التي من أَجَلَّها ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، والذنب يجر إلى الذنب، كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة، وعلى هذا فالزلل الذي أوقعهم فيه الشيطان هو ما كان من الهزيمة والفشل بعد توليهم عن مكانهم طمعًا في الغنيمة، وهذا التولي هو بعض ما كسبوا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ:أي إنّ ما صدر عن هؤلاء الزالين من الذنوب في هذا اليوم يستحق أن يعاقبوا عليه في الدنيا والآخرة، لكن الله عفا عن عقوبتهم الأخروية، وجعل عقوبتهم في الدنيا تربية وتمحيصًا. ، لأن فرارهم لم يكن عن نفاق ، بل كان عارضًا عرض لهم عندما اضطربت الصفوف واختلطت الأصوات .وفي هذا دفع لاستيلاء اليأس على نفوسهم، وتحسين لظنونهم. ، حتى تكون أمامهم الفرصة لتطهير نفوسهم . وبعثها على التوبة الصادقة والإخلاص لله رب العالمين. " جاء رجلٌ حجَّ البيتَ، فرأى قومًا جلوسًا، فقال: مَن هؤلاء القعودُ؟ قالوا: هؤلاء قريشٌ, قال: مَن الشَّيخُ ؟ قالوا: ابنُ عمرَ، فأتاه فقال:... أَتَعْلمُ أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ فرَّ يومَ أُحُدٍ؟ قال: نعَمْ... أمَّا فِرارُهُ يومَ أُحُدٍ فأَشهدُ أنَّ اللهَ عفا عنه وغفَر له..."صحيح البخاري. يَرْوي التَّابِعيُّ عُثمانُ بنُ مَوْهَبٍ أنَّه قد جاء رَجلٌ مِن أهلِ مِصرَ للحَجِّ، فوجَدَ قَومًا مِن قُرَيشٍ يَجلِسونَ، فسَأَل عن كَبيرِهم، فأشاروا إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، فذكَر له بَعضًا مِن الشُّبُهاتِ الَّتي أُثيرَتْ في حقِّ الخَليفةِ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه، فقال له: هلْ تَعلَمُ أنَّ عُثمانَ فرَّ يومَ أُحدٍ؟ أي: في غَزْوةِ أُحدٍ، فقال ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: نَعمْ.فقال ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما للرَّجلِ: تعالَ أُبيِّنْ لكَ حَقيقةَ كلِّ تُهْمةٍ وشُبْهةٍ منَ الَّتي ذكَرْتَها، فأمَّا فِرارُه يومَ أُحدٍ، فكان فيمَن أخْطأَ مِن المُسلِمينَ، وقدْ عَفا اللهُ عنهم، وغفَرَ لهم. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ: ذكر سبحانه اسمين يتضمنان وصفين بهذا الختم لهذه الآية مما يصلح للتعليل إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيم : والغفور صيغة مُبالغة كثير الغفر على كثرة الذنوب والإساءات ، يستر، ويقي العبد شؤم المعصية، والتبعات التي تلحقه من جرائها، حليم، لا يُعاجل بالعقوبة، بل قابل هؤلاء أيضًا بالعفو. أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يعفو عنا، ويتجاوز، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يُعيينا على ذكره وشكره وحُسن عبادته، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا، اللهم ذكرنا منه ما نُسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنا. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"156. أي: يا أيُّها المؤمنون، لا تَصيروا مثلَ الكفَّار- المنافقون وأشباههم- الَّذين قالوا قولًا منكَرًا ناشئًا عن اعتقادٍ فاسدٍ بالاعتراضِ على قضاءِ الله عزَّ وجلَّ وقدَرِه، وهو قولُهم عن إخوانهم من أهلِ الكفرِ والنفاقِ الَّذين خرَجوا من بلادهم سَفرًا لأجل التِّجارة وطلب المعيشة، أو خرَجوا غُزاةً للقتال، فماتوا في سَفَرهم، أو قُتلوا في غزوهم: يعارضون القدر ويقولون: لو أقاموا معنا ولم يَخْرُجوا كما فعلنا نحن لَمَا ماتوا في سفَرِهم، ولَمَا قُتِلوا في غَزوِهم. ولو كانوا مؤمنين بقضاء الله وقدره لعلموا أن كل شىء عنده بمقدار ، وأن العاقل هو الذي يعمل ما يجب عليه بجد وإخلاص ثم يترك بعد ذلك النتائج لله يسيرها كيف يشاء. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ:والحسرة - كما يقول الراغب – هي الهم المضني الذى يلقي على النفس الحزن المستمر والألم الشديد والغم على ما فاته ، والندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه ، أو انحسرت قواه - أي انسلخت - من فرط الغم ، وأدركه إعياء عن تدارك ما فرط " ، واللام في قوله لِيَجْعَلَ هي التي تسمَّى بلام العاقبة ، وهي متعلقة بقالوا أي قالوا ما قالوا لغرض من أغراضهم التي يتوهمون من ورائها منفعتهم ومضرة المؤمنين فكان عاقبة قولهم ومصيره إلى الحسرة والندامة لأن المؤمنين الصادقين لن يلتفتوا إلى هذا القول . بل سيمضون في طريق الجهاد الذي كتبه الله عليهم وسيكون النصر الذي وعدهم الله إياه حليفهم وبذلك يزداد الكافرون المنافقون حسرة على حسرتهم . ويجوز أن تكون اللام للتعليل ويكون المعنى : أن الله - تعالى - طبع الكفار على هذه الأخلاق السيئة بسبب كفرهم وضلالهم لأجل أن يجعل الحسرة في قلوبهم والغم في نفوسهم والضلال بهذه الأقوال والأفعال في عقولهم . أي: إنَّ اللهَ تعالى يَجعلُ هذا القولَ وهذا الاعتقادَ ندامةً في قلوبهم وهمًّا، فتزداد مصيبتُهم بذلك. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ: أي: هو المنفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر. واللهُ تعالى هو وحْدَه الَّذي يملِكُ الإحياءَ والإماتة، فلن يموتَ أحدٌ أو يُقتَل إلَّا بمشيئتِه سبحانه، وذلك بعدَ استكمالِ أجَلِه الَّذي قدَّره الله عزَّ وجلَّ له. فالأرواح كلها بيد الله يقبضها متى شاء ، ويرسلها متى شاء فالقعود في البيوت لا يطيل الآجال كما أن الخروج للجهاد في سبيل الله أو للسعي في طلب الرزق لا ينقصها. أي لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا فيمن ماتوا أو قتلوا ما قالوا، ليكون عاقبة ذلك القول مع الاعتقاد حسرة في قلوبهم على من فقد من إخوانهم تزيدهم ضعفا وتورثهم ندما على تمكينهم إياهم من التعرض لما ظنوه سببا ضروريا للموت، فإنكم إذا كنتم مثلهم في ذلك يصيبكم من الحسرة مثل ما يصيبهم، وتضعفون عن القتال كما يضعفون. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: واللهُ عزَّ وجلَّ مطلع على أعمال العباد وأقوالهم. مطلعٌ على كلَّ ما يَعمَلُه العبادُ، مؤمنُهم وكافرُهم، من خيرٍ أو شرٍّ، قليلٍ أو كثيرٍ، وهو حافظٌ له، فلا يخفى عليه شيء مما تكنّون في أنفسكم من المعتقدات التي لها أثر في أقوالكم وأفعالكم،وسيجازيكم عليها يوم القيامة بما تستحقون من خير أو شر. "وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"157. الفرق بين القتل والموت، فالموت: هو زهوق الروح، أن تزهق روح الإنسان حتف أنفه، يعني: من غير جناية، من غير تسبُب، أو مُباشرة، والقتل قلنا: هو زهوق الروح بتسبُب. والذي يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يُقتل، فما الذي يرجح عنده هذا العمل؟ إنه يبتغي الخير بالحياة. وما دام يبتغي الخير بالحياة، إذن فحركته في الحياة وفي همه ستأتيه بخير، فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك الخير، إنه لم يمتلك بصيرة إيمانية، ونقول له: الخير في حياتك على قدر حركتك: قوة وعلما وحكمة، أما تمتعك حين تلقى الله شهيدًا فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة وهي عطاءات بلا حدود، إذن فأنت ضيعت على نفسك الفرق بين قُدرتك وحِكمتك وعِلمك وحَركتك في الكسب وبين ما يُنسب إلى الله في كل ذلك، أي: إنَّكم إذا قُتِلتم في سبيلِ الله ....، فهذا أمرٌ حسَنٌ يَنبغي أنْ تطمَعوا فيه، وتتنافسوا عليه؛ لأنَّه موصلٌ إلى نيلِ مغفرةِ الله تعالى لذُنوبكم، وشمولِ رحمتِه عليكم، وذلك أفضلُ لكم من البقاءِ في هذه الدَّارِ وجمْعِ حُطامِها الفاني، كما يفعلُ أهلُ الدُّنيا. خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ: أي إن مغفرة الله ورحمته لمن يموت أو يقتل في سبيل الله، خير مما يجمعه ويتمتع به الكفرة من متع الدنيا وشهواتها الزائلة في هذه الدار الفانية ، بخلاف مغفرة الله ورحمته فإنهما باقيتان ولا كدر معهما ولا تعب.فإن هذا ظل زائل، وذاك نعيم خالد. فما أجدر المؤمنين أن يؤثروا مغفرة الله ورحمته على الحظوظ الفانية، وألا يتحسروا على من يقتل منهم أو يموت في سبيل الله. الرحمة نجاة من العقاب، فلا ينجو من عقاب الله وعذابه إلا من تغمده الله برحمته، وعلى ذلك تكون المغفرةستر عن الزلة، والرحمة نجاة من العذاب. "وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ"158. ولنا أن نلحظ أن قول الحق في الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال تعالى"وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ" وجاء في هذه الآية بتقديم الموت على القتل قال- جل شأنه"وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ" فقدم القتل على الموت في الآية الأولى لأنها جاءت في المقاتلين، والغالب في شأنهم أن من يلقى الله منهم ويفضي إلى ربه يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه، أما هذه الآية فقد جاءت لبيان أن مصير جميع العباد-ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله- تعالى- وأن أكثرهم تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه بسبب الموت، فلذا قدم الموت هنا على القتل. إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها. إنه قول الحكيم الخبير. الخَلْق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت، فإنما مرجعهم إلى الله، ومآلهم إليه، فيجازي كلا بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله، وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله؟" إذا جاءت سكرة الموت عند ذلك يتلاشى كلُّ عرضٍ من أعراضِ الدنيا عن الإنسان وتبدد، وعرف أنه كان في وهم كبير، وأنه لن يُخلصه في هذه الحال، لا المال ولا الولد ولا الأعوان، ولا غير ذلك، وإنما يُفضي وحده من غير شيء إلا العمل الصالح، أو السيء يُفضي إلى الله، ينتقل إلى الله، وهناك يتولاه ملائكة الرحمة، أو ملائكة العذاب، وهناك يُجازي ويُحاسِب من لا تخفى عليه خافية، هنا تخفى على الناس أشياء كثيرة، وقد يظهر الإنسان بغير ما يُبطن، ويُسر، لكن هناك تظهر الحقائق، ومُخبآت النفوس، وأعمال الناس، فتلك الدار الحقيقية. لذلك على العاقل الذي يريد أن ينفع نفسه ينظر في أعماله، وفي حاله، وفي غفلته، وفي ما يصدر عنه، وفي نياته، ومقاصده، ويُصلح ذلك كله قبل أن يُغادر في أي لحظة، والمُغادرة لا يدري الإنسان متى تكون ، ربما تكون وهو في بحبوحة من العيش، وفي رغد، ونعمة يكون لربما ضاحكًا مع أهله أو أصحابه، أو غير ذلك، ثم بعد ذلك في لحظة، أو في حادث، أو نحو ذلك، وهو لربما في طرب،فيباغته الموت، ولا يستطيع تلك اللحظة أن يتوب، ولا يستطيع أن يوصي، ولا أن يرجع إلى أهله ليودع، هذا أمر مُشاهد، ماذا ينتظر الإنسان بعد العافية؟ وماذا ينتظر بعد الإمهال؟ وماذا ينتظر بعد الفراغ؟ أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحُسن عبادته.
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
تفسير سورة آل عمران من آية 159إلى آية 170 " فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ"159. نزلت هذه الآيات عقب غزوة أُحد التي خالف فيها النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعضُ أصحابهِ، وكان من جرّاء ذلك ما كان من الفشل وظهور المشركين عليهم حتى أصيب النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع من أصيب. فبعد أن أرشد سبحانه عباده المؤمنين في الآيات المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم - زاد في الفضل والإحسان إليهم في هذه الآيات بأن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم على عفوه عنهم وتركه التغليظ عليهم،. فبسبب رحمة عظيمة فياضة منحك الله إياها يا محمد كنت لَيِّنًا مع أتباعك فى كل أحوالك ، ولكن بدون إفراط أو تفريط ، فقد وقفت من أخطائهم التي وقعوا فيها في غزوة أُحد موقف القائد الحكيم المُلْهَم فلم تعنفهم على ما وقع منهم وأنت تراهم قد استغرقهم الحزن والهم. بل كنت لَيِّنًا رفيقًا معهم . وهكذا القائد الحكيم لا يُكثر من لوم جنده على أخطائهم الماضية ، لأن كثرة اللوم والتعنيف قد تولد اليأس ، وإنما يتلفت إلى الماضي ليأخذ منه العبرة والعظة لحاضره ومستقبله ويغرس في نفوس الذين معه ما يحفز همتهم ويشحذ عزيمتهم ويجعلهم ينظرون إلى حاضرهم ومستقبلهم بثقة واطمئنان وبصيرة مستنيرة . وإن الشدة فى غير موضعها تفرق ولا تجمع وتُضعف ولا تقوي ، ولذا قال – تعالى " وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ" لو كنت تحمل قلبًا قاسيًا وخُلقًا صعبًا. الفظ : خشونة القول وسوء الخُلق، غَلِيظَ الْقَلْبِ :الغلظ في القلب هو قسوة في القلب ما ينشأ عنه الخشونة في الألفاظ. أي ولو كنت خشنًا جافيًا في معاملتهم لتفرقوا عنك، ونفروا منك، ولم يسكنوا إليك، ولم يتم أمرك من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط السوي. وإن الشدة في غير موضعها تفرق ولا تجمع وتضعف ولا تقوي ، فالجملة الكريمة تنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فظا أو غليظا ، في الظاهر والباطن لأن " لو " تدل على نفي الجواب لنفي الشرط . أي أنك لست - يا محمد - فظا ولا غليظ القلب ولذلك التف أصحابك من حولك يفتدونك بأرواحهم وبكل مرتخص وغال ، ويحبونك حبًا يفوق حبهم لأنفسهم ولأولادهم ولآبائهم ولأحب الأشياء إليهم . والرسول صلى الله عليه وسلم كان مبرأ من كل ذلك ، ويكفي أن الله - تعالى - قد قال فى وصفه " لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ "التوبة: 128. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ: فالفاء هنا تفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أي أنه يترتب على لين جانبك مع أصحابك ، ورحمتك بهم ، أن تعفو عنهم فيما وقعوا فيه من أخطاء تتعلق بشخصك أو ما وقعوا فيه من مخالفات أدت إلى هزيمتهم في أُحد ، فقد كانت زلة منهم وقد أدبهم الله عليها. وأن تلتمس منَ اللهِ تعالى ، أن يغفر لهم ما فرط منهم ، إذ في إظهارك ذلك لهم تأكيد لعفوك عنهم ، وتشجيع لهم على الطاعة والاستجابة لأمرك. وأنْ يَستشيرَهم في الأمورِ الَّتي تحتاجُ إلى مشورةٍ، فإذا ترجَّح له أمرٌ بعد الاستشارةِ فليَمضِ فيه متوكِّلًا على الله، أي: اعتمد على حول الله وقوته، متبرئا من حولك وقوتك، والله سبحانه يحبُّ مَن يتوكَّل عليه. "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"160. ثمَّ يخبِرُهم تعالى أنَّه حِين يُقدِّرُ للمؤمنين النَّصرَ فلنْ يَستطيعَ أحدٌ أنْ يَهزمَهم، وإنْ تخلَّى اللهُ عنهم فلا يُمكن لأحدٍ أنْ يَنصُرَهم أبدًا، لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه، ولا تسكن إلا بإذنه ،وعلى اللهِ وحْدهَ فليكُنِ اعتمادُ كلِّ مؤمن. والمراد بالنصر هنا العون الذي يسوقه لعباده حتى ينتصروا على أعدائهم . والمراد بالخذلان ترك العون . والمخذول ، هو المتروك الذى لا يُعبأ به. " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "161. ثمَّ يُخبِرُ تعالى أنَّه ليس من صِفاتِ الأنبياءِ الغُلولُ، أي: كتمانُ الغنيمةِ، أو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها ولا الخيانةُ عمومًا، ولا يَنبغي أن يُتَّهموا بذلِك، أو يَخُونَهم أحدٌ، وأنَّ مَن قام بالخيانةِ في غنائمِ المسلمين فإنَّه يُجيءُ معه يومَ القيامة بذلك الشَّيءِ الَّذي أخَذَه خِيانةً، ثمَّ تُجزَى كلُّ نفسٍ بما عمِلَتْ، لا يُظلَمُ أحدٌ شيئًا. نزلَت هذه الآيه " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ "في قَطيفةٍ حمراءَ افتُقدت يومَ بدرٍ فقال : بَعضُ النَّاسِ لعلَّ رسولَ اللهِ أخذَها، فأنزلَ اللهُ تبارَك وتعالَى " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ "إلى آخرِ الآيةِ"الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم : 3009 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. اخْتارَ اللهُ سبحانَه رُسلَه وأنبياءَه واصطَفاهُم مِن خِيرةِ الخلقِ، وأدَّبَهم على عْينِه سبْحانَه؛ فَهم أفْضلُ الخلقِ خُلقًا وعمَلًا، ولكنْ دائمًا ما كان الرُّسلُ يُبْتَلَوْن بالمنافِقينَ والمعَانِدينَ الَّذين يَصِفونَهم بالقبائحِ، ولكنَّ اللهَ يُظهِرُ براءةَ أنبيائِه ورسلِه على أعْيُنِ النَّاسِ جميعًا، وقد تَعرَّض النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لِمثْلِ هذا، وأنْزلَ اللهُ براءتَه قرْآنًا يُتلَى إلى يومِ القيامةِ، كما يقولُ عبدُ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما في هذا الحديثِ. وفي الحديثِ: أنَّ اللهَ تعالى يُدافِعُ عن أنبيائِه وأوليائِه. وفيه: بيانُ أنَّ المنافِقين شِرارُ النَّاسِ.الدرر السنية. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : جمهور العلماء على أن الغال يأتي بما غله يوم القيامة بعينه على سبيل الحقيقة لأن ظواهر النصوص من الكتاب والسنة تؤيد ذلك . ولأنه لا موجب لصرف الألفاظ عن ظواهرها . قال أبو هريرة: قَامَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ذَاتَ يَومٍ، فَذَكَرَ الغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قالَ: لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ علَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ يقولُ: يا رَسولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فأقُولُ: لا أَمْلِكُ لكَ شيئًا، قدْ أَبْلَغْتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ علَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ له حَمْحَمَةٌ، فيَقولُ: يا رَسولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فأقُولُ: لا أَمْلِكُ لكَ شيئًا، قدْ أَبْلَغْتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ علَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يقولُ: يا رَسولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فأقُولُ: لا أَمْلِكُ لكَ شيئًا، قدْ أَبْلَغْتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ علَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فيَقولُ: يا رَسولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فأقُولُ: لا أَمْلِكُ لكَ شيئًا، قدْ أَبْلَغْتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ علَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فيَقولُ: يا رَسولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فأقُولُ: لا أَمْلِكُ لكَ شيئًا، قدْ أَبْلَغْتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ علَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فيَقولُ: يا رَسولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فأقُولُ: لا أَمْلِكُ لكَ شيئًا، قدْ أَبْلَغْتُكَ."الراوي : أبو هريرة - صحيح مسلم. حَذَّر الشَّرعُ الإسلاميُّ المُطهَّرُ تَحذيرًا شَديدًا مِنَ الغُلولِ، وهو الخِيانةُ والسَّرِقةُ مِنَ الغَنيمةِ قبْلَ قِسمَتِها، وبَيَّنَ أنَّ عُقوبَتَه تَكونُ على رُؤوسِ الأشهادِ يَومَ القيامةِ. وأخبَرَ أنَّه لا يَأخُذُ أحَدٌ مِنَ المَغنَمِ شَيئًا بغَيرِ حَقٍّ، إلَّا جاءَ يَومَ القيامةِ وهو يَحمِلُ ما سَرَقَه على رَقبَتِه. رِقاعٌ: جَمعُ رُقعةٍ، وهي الخِرقةُ، تَخفِقُ: أي: تَتَحرَّكُ إذا حَرَّكَتْها الرِّياحُ، أو تَلمَعُ. كلُّ هؤلاء يُنادُون رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيَشفَعَ لهم عِندَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ أنْ يَرفَعَ عنهم هذا العَذابَ، فتَكونُ الصَّدمةُ أنْ يُخبِرَهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّه لا يَملِكُ لهم عِندَ اللهِ شَيئًا مِنَ المَغفِرةِ أوِ الشَّفاعةِ؛ لِأنَّ الشَّفاعةَ تَكونُ بأمْرِ اللهِ وإذنِه، ثمَّ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لكلِّ واحدٍ منهم"قدْ أبلَغتُكَ"، فأنذَرتُكَ عاقِبةَ هذا الفِعلِ وأنتَ في الدُّنيا، فلمْ تَستجِبْ، فغَلَلْتَ وسَرَقتَ، فاستَحَقَّيتَ العُقوبةَ مِن اللهِ تعالَى. وحِكمةُ الحَملِ على الرَّقَبةِ هي فَضيحةُ الحامِلِ على رُؤوسِ الأشهادِ في ذلك المَوقِفِ العَظيمِ، وقال بَعضُهم: هذا الحَديثُ يُفسِّرُ قَولَه تَعالى"وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"آل عمران: 161، أي: يأتِ به حامِلًا له على رَقَبَتِه. وفي الحَديثِ: أنَّ العُقوباتِ قدْ تَكونُ مِن جِنسِ الذُّنوبِ، بأنْ يَجعَلَها اللهُ سُبحانَه وتعالَى عِقابًا لِلشَّخصِ. وفيه: تَعديدُ بَعضِ أنواعِ الغُلولِ؛ لِيَكونَ إعلامًا لِلنَّاسِ بها. يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ علَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ: الصامِتُ الذَّهَبُ والفِضَّةُ المَغلولةُ. .الدرر السنية. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ: ثم تُعطَى كلُّ نفسٍ يومَ القيامةِ جزاء ما كسبت من خير أو شر وافيًا تامًا ، وهم لا يظلمون شيئًا.جاء بصيغة العموم ، ولم يقل ثم يوفي الغال مثلا - لأن من فوائد ذكر هذا الجزاء بصيغة العموم ، الإعلام والإخبار للغال وغيره من جميع الكاسبين بأن كل إنسان سيجازَى على عمله سواء أكان خيرًا أو شرًا . فيندرج الغال تحت هذا العموم أيضًا فكأنه قد ذُكِرَ مرتينِ . " أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ"162. ثم أكد - سبحانه - نفي الظلم عن ذاته ، أي أفمن اتقى وسعى في تحصيل رضا الله بفعل الطاعات، وترك الغلول وغيره من الفواحش والمنكرات حتى زكت نفسُهُ وصفت روحُهُ - يكون جزاؤه كجزاء من انتهى أمرُهُ إلى سخطِ اللهِ، وعظيم غضبه، بفعل ما يدنس نفسَهُ منَ الخطايا من سرقة وغلول وسلب وقتل، وترك ما يطهرها من فعل الخيرات وعمل الصالحات؟!. فالآية الكريمة تفريع على قوله - تعالى - قبل ذلك " ثُمَّ توفى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ " وتأكيد لبيان أنه لا يستوي المحسن والمسىء والأمين والخائن . والاستفهام إنكاري بمعنى النفي ، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله مع من باء بسخط منه . وقد ساق - سبحانه - هذا الكلام الحكيم بصيغة الاستفهام الإنكاري ، للتنبيه على أن عدم المساواة بين المحسن والمسيء أمر بدهي واضح لا تختلف فيه العقول والأفهام ، وأن أي إنسان عاقل لو سُئل عن ذلك لأجاب بأنه لا يستوي من اتبع رضوان الله مع من رجع بسخط عظيم منه بسبب كفره أو فسقه وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى " "أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ" السجدة:18. وقوله " "أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ" ص:28..ثم أعقب - سبحانه - ذكر سخطه وغضبه بذكر عقوبته فقال " وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" أي أن هذا الذي رجع بغضب عظيم عليه مِنَ اللهِ - تعالى - بسبب كفره أو فسوقه أو خيانته ، سيكون مثواه ومصيره إلى النار وبئس وسوء ذلك المصير الذي صار إليه وكان له مرجعًا ونهاية نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم . "هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ" 163. "هُمْ دَرَجَاتٌ " والدرجات المنازل بعضها أعلى من بعض في المسافة أو في التكرمة، أو العذاب. اختلف المفسرون في قوله تعالى" هُمْ دَرَجَاتٌ " مَن المراد بذلك؟ فقال ابن إسحاق وغيره: المراد بذلك الجمعان المذكوران، أهل الرضوان وأصحاب السخط، أي لكل صنف منهم تباين في نفسه في منازل الجنة، وفي أطباق النار أيضًا، وقال مُجَاهِدٌ و السُّدِّيُّ ما ظاهره: إن المراد بقوله " هُمْ " إنما هو لمتبعي الرضوان، أي لهم درجات كريمة عند ربهم. والمعنى: هم: أي الأخيار الذين اتبعوا رضوان الله، والأشرار الذين رجعوا بسخط منه متفاوتون في الثواب والعقاب على حسب أعمالهم كما تتفاوت الدرجات وإطلاق الدرجات على الفريقين من باب التغليب للأخيار على الأشرار والمراد إن الذين اتبعوا رضوان الله يتفاوتون في الثواب الذي يمنحهم الله إياه على حسب قوة إيمانهم، وحسن أعمالهم. كما أن الذين باءوا بسخط منه يتفاوتون في العقاب الذي ينزل بهم على حسب ما اقترفوه من شرور وآثام، فمن أوغل فى الشرور والآثام كان عقابه أشد من عقاب من لم يفعل فعله وهكذا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ: أي مطلع على أعمال العباد صغيرها وكبيرها ظاهرها وخفيها، لا يغيب عنه شىء، وسيجازي كلَّ إنسانٍ بما يستحقه على حسب عمله، بمقتضَى علمه الكامل، وعدله الذي لا ظلم معه. وبعد أن نزه الله - تعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم عن الغلول وعن كل نقص، وبيَّنَ أنَّ الناسَ متفاوتون في الثوابِ والعقابِ على حسب أعمالهم. بعد أن بيَّن ذلك أتبعه ببيان فضله - سبحانه - على عباده في أن بعث فيهم رسولًا منهم ليخرجهم مِنَ الظلماتِ إلى النورِ فقال – تعالى: " لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ"164. مَنَّ : أي: أنْعَم وصنَع الصُّنع الجَميل. " مِّنْ أَنفُسِهِمْ" أي من نفس العرب، ويكون المراد بالمؤمنين مؤمني العرب، وقد بعثه الله عربيًّا مثلهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع بتوجيهاته. ويصح أن يكون معنى قوله " مِّنْ أَنفُسِهِمْ" أنه بشر مثل سائر البشر إلا أن الله - تعالى - وهبه النبوة والرسالة، ليُخرِج الناس جميعا العربي منهم وغير العربي - من ظلمات الشرك إلى نور الإِيمان، وجعل رسالته عامة. ثم بيَّنَ- سبحانه- مظاهر هذه المنة والفضل ببعثة الرسول صلّى الله عليه وسلّم فقال: يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ: أي لقد أعطى الله - تعالى - المؤمنين من النعم ما أعطى، لأنه قد بعث فيهم رسولًا من جنسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ : يقرأ عليهم كتاب الله لفظًا وحفظًا وتحفيظًا، فكان النبيصلّى الله عليه وسلّم يحفظها، فلم يكن يقرأ في كتاب " سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى" سورة الأعلى:6. ويقرأ عليهم فيحفظون . ويبيِّنُ لهم آيات الله الكونية،أي يتلو عليهم آياته الدالة على قدرة الله ووحدانيته وعلمه، كما جاء في قوله" إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ "آل عمران: 190. وقوله " وَالشَّمْسِ وَضُحاها وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها "الشمس: 1،2. وقوله " أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ " الغاشية: 20. " وَيُزَكِّيهِمْ " أي يطهرهم من الكفر والذنوب. أو يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مما كانوا عليه من دنس الجاهلية، والاعتقادات الفاسدة، بالتربية بالأعمال الصالحة، والتنزه عن أضدادها من الرذائل. " وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ . أي: ويُعلِّمهم معانيَ القرآنِ الكريم، والسُّنَّة النَّبويَّة. قال ابن تيمية:والحكمة قال غير واحد من السلف: هي السنة.وقال أيضًا طائفة كمالك وغيره: هي معرفة الدين والعمل به.ا.هـ. فيعلمهم المعاني، والأحكام بسيرته العملية، وبقوله -عليه الصلاة والسلام- فصارت ثلاثة أشياء متدرجة: الحفظ، والتلاوة، والتحفيظ، والثاني: التزكية والتربية العملية، ، والثالث: البيان للمعاني، والفقه في الدين ، وبهذا يحصل الكمال، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فالتلاوة وحدها لا تكفي، فلا بد من التعليم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فالفقه في الدين، وفهم معاني القرآن إنما يُتلقى ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمن أخذوا عنه، وليس لأحد أن يقول: نحن رجال، وهم رجال، ونُريد أن نُفسر القرآن بحسب مُعطيات عصرنا، وبحسب أعرافنا وأفهامنا، فلكل عصر رجاله، فهذا الكلام مُغالطة كبيرة، ولا يمكن أن يتوصل معها إلى هُدى، وإنما هو الضلال المُبين، والخروج من رِبقة الدين، فهذه هي النتيجة، فلو أُطلق العنان لكل أحد أن يتكلم في معاني القرآن، بعيدًا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، فلا تسأل عن ضلالة هؤلاء. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ: أي: إن حال الناس وخصوصًا العرب أنهم كانوا قبل بعثة الرسول صلّى الله عليه وسلّم إليهم في ضلال بيِّن واضح لا يخفى أمره على أحد من ذوي العقول السليمة ، لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكي النفوس ويطهرها. "أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"165. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ : والهمزة في قوله "أَوَلَمَّا" للاستفهام الإنكاري التعجيبى. مُّصِيبَةٌ : المراد بالمصيبة: ما أصابهم يوم أحد من ظهور المشركين عليهم، وقتل سبعين من المسلمين . قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا: أي: أحِينَ حلَّت بكم مُصيبةُ غزوةِ أُحُدٍ بقتلِ سبعينَ رجلًا منكم، مع أنَّكم نِلتُم قبلها في بَدْرٍ ضِعْفَيْ ما نالوا منكم عددًا، بقَتلِ سبعينَ من صناديدهم ، وأَسْرِ سَبعينَ آخَرين، أحينَها تقولون: مِن أين جرَى علينا هذا الأمرُ، وكيفَ حلَّتْ بنا هذه الكارثةُ يوم أُحُد! من أين لنا هذا القتل والخذلان ونحن مسلمون نقاتل في سبيل الله، وفينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداؤنا الذين قَتَلُوا منا مَنْ قُتِلُوا مشركون يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقوله قلتم أنى هذا هو موضع التوبيخ والتعجيب من شأنهم، لأن قولَهم هذا يدل على أنهم لم يحسنوا وضع الأمور في نصابها حيث ظنوا أن النصر لا بد أن يكون حليفهم حتى ولو خالفوا أمر قائدهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم ولذا فقد رد الله- تعالى- عليهم بما من شأنه أن يعيد إليهم صوابهم وبما يعرفهم السبب الحقيقي في هزيمتهم فقال: قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ : أي قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا ما قالوا: إن ما أصابكم في أُحد سببه أنتم لا غيركم. فأنتم الذين أبيتم إلا الخروج من المدينة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليكم بالبقاء فيها. وأنتم الذين خالفتم وصيته بترككم أماكنكم التي حددها لكم وأمركم بالثبات فيها. وأنتم الذين تطلعت أنفسكم إلى الغنائم فاشتغلتم بها وتركتم النصيحة، وأنتم الذين تفرقتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الشدة والعسرة فلهذه المخالفات التي نبعت من أنفسكم أصابكم ما أصابكم في أُحد، وكان الأولى بكم أن تعرفوا ذلك وأن تعتبروا وأن تقلعوا عن هذا القول الذي لا يليق بالعقلاء، إذ العاقل هو الذي يحاسب نفسه عندما يفاجئه المكروه ويعمل على تدارك أخطائه ويقبل على حاضره ومستقبله بثبات وصبر مستفيدًا بماضيه ومتعظًا بما حدث له فيه. وفي أحد كذلك كان لهم النصر في أول المعركة على المشركين، وقتلوا منهم قريبًا من عشرين إلا أنهم حين خالفوا وصية رسولهم صلى الله عليه وسلم وتطلعوا إلى الغنائم، منع الله عنهم نصره، فقتل المشركون منهم قريبا من سبعين. من فوائد غزوة أُحُد أنها كشفت عن قوي الإيمان من ضعيفه، ميزت الخبيث من الطيب.وإذا كان انتصار المسلمين في بدر جعل كثيرًا من المنافقين يدخلون في الإسلام طمعًا في الغنائم، فإن عدم انتصارهم في أُحُد قد أظهر المنافقين على حقيقتهم، ويسر للمؤمنين معرفتهم والحذر منهم. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : أي إن الله تعالى- قدرته فوق كل شيء فهو القدير على نصركم وعلى خذلانكم وبما أنكم قد خالفتم نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد حرمكم الله نصره، وقرر لكم الخذلان، حتى تعتبروا ولا تعودوا إلى ما حدث من بعضِكم في غزوةِ أُحُدٍ، ولتذكروا دائمًا قوله- تعالى" وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ"الشورى:30. وإياكم وسوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ،قال تعالى " ذلك وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ" محمد : 4. " وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ" 166. ثم أكد- سبحانه - عموم قدرته وإرادته أن كل شيء بإذنه أي: وما أصابكم- أيها المؤمنون- من قتل وجراح وآلام يوم التقى جمعكم وجمع أعدائكم في أُحُد، فَبِإِذْنِ اللَّهِ أي فبإرادته الكونية وعلمه، إذ ما من شيء يقع في هذا الكون إلا بتقدير الله وعلمه، فعليكم أن تستسلموا لإرادة الله، وأن تعودوا إلى أنفسكم فتهذبوها وتروضوها على تقوى الله وطاعته، حتى تكونوا أهلا لنصرته وعونه. والمقصود بالإذن هنا الإذن الكوني، وليس المقصود به الإذن الشرعي، يعني بقضائه وقدره؛ لأن كل شيء إنما هو بقضاء وقدر، لا يقع في هذا الكون صغيرة ولا كبيرة، ولا تحريك ولا تسكين إلا بقضاء الله -تبارك وتعالى- وتقديره، فالملك ملكه والخلق خلقه. وقوله :وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ: بيان لبعض الحِكَم التي من أجلها حدث ما حدث في غزوة أُحُد. المقصود بالعلم هنا: علم الوقوع؛ العلم الذي يترتب عليه الجزاء؛ لأن الله -تبارك وتعالى- كما هو معلوم يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فإذا جاء مثل هذا في كتاب الله عز وجل وليعلم كذا: وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِين الذين صبَروا وثبَتوا مِن غيرهم. فإن ذلك محمول على هذا المعنى العلم الذي يترتب عليه الجزاء وهو علم الوقوع؛ لأن الله لا يُجازيهم بمقتضى علمه السابق من كمال رحمته وعدله، وإنما يُجازيهم ويُحاسبهم إذا صدر ذلك عنهم ووقع: وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِين فيظهر ذلك عيانًا ويتميز أهل الإيمان من غيرهم. الشيخ العثيمين: علم ظهور، يعني: وليعلمه بعد ظهوره، أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عز وجل؛ لأن الله عَلِم كل شيء إلى يوم القيامة، وأيضًا هذا العلم علم يترتب عليه الثواب، أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه العقاب، هذان فرقان، الفرق الثالث: أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن وقع، فهو علم بأنه وقع، وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع، وهناك فرق بين العلم بأنه وقع وبين العلم بأنه سيقع، هذه ثلاثة أوجه، وإلّا فإن كثيرًا من الناس يقول: كيف وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ أليس الله قد علمهم؟ فنقول: بلى علمهم، لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة. " وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ" 167. وَلِيَعْلَمَ : والعلم هنا كناية عن الظهور والوقوع والتقرر في الخارج لما قدره- سبحانه - في الأزل ،وقوع الذي يترتب عليه الجزاء. وهذه حكمة ثانية لما حدث في غزوة أحد. أي: حدث ما حدث في غزوة أُحد ليتميز - المؤمنون من المنافقين عِلم عيان ورؤية وظهور يتميز معه عند الناس كل فريق عن الآخر تميزا ظاهرًا.إذ أن نصر المسلمين في بدر فَتَحَ الطريقَ أمام المنافقين للتظاهر باعتناق الإسلام.وعدم انتصارهم في أُحُد، كشف عن هؤلاء المنافقين وأظهرهم على حقيقتهم، فإن من شأن الشدائد أنها تكشف عن معادن النفوس، وحنايا القلوب. ثم بيَّنَ- سبحانه- بعض النصائح التي قيلت لهؤلاء المنافقين حتى يقلعوا عن نفاقهم، وحكى ما رد به المنافقون على الناصحين. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا: أي قيل لهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض أصحابه: تعالوا معنا لتقاتلوا في سبيل الله، فإن لم تقاتلوا فادفعوا أي فانضموا إلى صفوف المقاتلين، فيكثر عددهم بكم فإن كثرة العدد تزيد من خوف الأعداء. أو المعنى: تعالوا معنا لتقاتلوا من أجل إعلاء كلمة الله، فإن لم تفعلوا ذلك لضعف إيمانكم، واستيلاء الشهوات والأهواء على نفوسكم، فلا أقل من أن تقاتلوا لتدفعوا عن أنفسكم وعن مدينتكم عار الهزيمة.أي إن لم تقاتلوا طلبا لمرضاة الله، فقاتلوا دفاعًا عن أوطانكم وعزتكم. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ : هذا ردهم القبيح على من نصحهم بالبقاء مع المجاهدين.أي قال المنافقون- وهم عبد الله بن أُبي وأتباعه- لو نعلم أنكم تقاتلون حقًا لَسِرنا معكم، ولكن الذي نعلمه هو أنكم ستذهبون إلى أُحُدٍ ثم تعودون بدون قتال لأي سبب من الأسباب.أو المعنى- كما يقول الزمخشري" لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم يعنون أن ما أنتم فيه لخطأ رأيكم وزللكم عن الصواب ليس بشيء، ولا يقال لمثله قتال، إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأن رأي عبد الله بن أُبي كان في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروج" .وقال ابن جرير: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أُحُد في ألف رجل من أصحابه وحتى إذا كانوا بالشوط بين أُحُدٍ والمدينةِ، انخذل عنهم عبد الله بن أُبَي ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وعصاني. والله ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق والريب، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام- أخو بني سَلَمَة- يقول لهم. يا قوم أُذَكِّركم الله أن تخذلوا نبيَكُم وقومَكُم- وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا- فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال.فلما استعصوا عليه، وأبوا إلا الانصراف عن المؤمنين قال لهم. أبعدكم الله يا أعداء الله فسيغني اللهُ رسولَهُ عنكم، ثم مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدل بهذه الآية على قاعدة "ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وفعل أدنى المصلحتين، للعجز عن أعلاهما" ؛لأن المنافقين أُمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان. تفسير السعدي. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ: يعني أن ميلهم إلى الكفر أقرب من ميلهم إلى الإيمان في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيه وانخذلوا عن المسلمين هم للكفر أقرب منهم للإيمان، وإن كان فيهم شيء من الإيمان ولعل هذا في بعضهم، لكنْ هم للكفر أقرب. تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. استدلوا بهذه الآية على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال ، فيكون في حال أقرب إلى الكفر ، وفي حال أقرب إلى الإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أي بينوا حالهم ، وهتكوا أستارهم ، وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون ; فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال ، وإن كانوا كافرين على التحقيق . يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ : مثل أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون"نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّه "المنافقون،، ويذكرون الله فيقولون: لا إله إلا الله، ويحضرون بعض الصلوات على أنهم مسلمون، فهم -والعياذ بالله يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ، ما الذي في قلوبهم؟ الكفر، والذي بأفواههم؟ الإسلام. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ: أي الله أعلم بحقيقة ما يُخفون في صدورهم ويُضمرون من النفاق والكفر. وأما ما يظهرونه من اللسان فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين. ثم حكى- سبحانه - لونًا آخر من أراجيفهم وأكاذيبهم التي قصدوا من ورائها الإساءة إلى المؤمنين، والتشكيك في صدق تعاليم الإسلام فقال عز من قائل: "الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ"168. الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا : أي أن هؤلاء المنافقين لم يكتفوا بما ارتكبوه من جنايات قبيل غزوة أحد وخلالها، بل إنهم بعد انتهاء المعركة قالوا لإخوانهم الذين هم مثلهم في المشرب والاتجاه،: قالوا لهم وقد قعدوا عن القتال: لو أن هؤلاء الذين استشهدوا في أُحُد أطاعونا وقعدوا معنا في المدينة لما أصابهم القتل، ولكنهم خالفونا فكان مصيرهم إلى القتل. قولهم هذا يدل على خبث نفوسهم، وانطماس بصيرتهم وجهلهم بقدرة الله ونفاذ إرادته، وشماتتهم فيما حل بالمسلمين من قتل وجراح يوم أُحُد. ولذا فقد رد الله عليهم بما يخرس ألسنَتَهم، ويدحض قولَهم، ويكشف عن جهلهم وسوء تفكيرهم فقال-تبارك وتعالى: قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ : أي قل لهم يا محمد على سبيل التوبيخ والتهكم بعقولهم الفارغة: إذا كنتم تظنون أنكم دفعتم عن أنفسكم الموت بقعودكم في بيوتكم، وامتناعكم عن الخروج للقتال، إذ كنتم تظنون ذلك فَادْرَؤُا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت المكتوب عليكم عند حلوله ، والذي سيدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة. قال مجاهد ، عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبَيّ ابن سلول . وبعد هذا الحديث الكاشف عن طبيعة المنافقين وعن أحوالهم، انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن الشهداء وفضلهم وما أعده الله لهم من نعيم مقيم فقال-تبارك وتعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"169. كلام مستأنف ساقه الله-تبارك وتعالى- لبيان أن القتل في سبيل الله الذي يحذره المنافقون ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر، بل هو أجل المطالب وأسماها، إثر بيان أن الحذر لا يدفع القدر، لأن من قدر الله له القتل لا يمكنه الاحتراز عنه.ومن لم يقدر له ذلك لا خوف عليه منه. فهذه الآيات الكريمة رد على شماتة المنافقين إثر الردود السابقة، وتحريض للمؤمنين على القتال، وتقرير لحقيقة إسلامية ثابتة هي أن الاستشهاد في سبيل الله ليس فناء بل هو بقاء. و الخطاب في قوله" وَلَا تَحْسَبَنَّ"للنبي صلّى الله عليه وسلّم أو لكل من يتأتى له الخطاب. بَلْ أَحْيَاءٌ : وهذه الحياة التي أثبتها القرآن الكريم للشهداء حياة غيبية لا ندرك حقيقتها، ولا نزيد على ما جاء به الوحي. عِندَ رَبِّهِمْ: يقتضي علو درجتهم، وقربهم من ربهم، يُرْزَقُونَ: من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه، إلا من أنعم به عليهم. عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّهُ سُئِلَ عن قولِهِ : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فقالَ : أما إنَّا قد سأَلْنا عن ذلِكَ، فأُخبِرنا أنَّ أرواحَهُم في طيرٍ خضرٍ تسرحُ في الجنَّةِ حيثُ شاءت، وتأوي إلى قَناديلَ معلَّقةٍ بالعرشِ، فاطَّلعَ إليهم ربُّكَ اطِّلاعةً، فقالَ : هل تستَزيدونَ شيئًا فأزيدُكُم ؟ قالوا ربَّنا : وما نستزيدُ ونحنُ في الجنَّةِ نَسرحُ حيثُ شِئنا ؟ ثمَّ اطَّلعَ عليهمُ الثَّانيةَ، فقالَ : هل تَستزيدونَ شيئًا فأزيدُكُم ؟ فلمَّا رأَوا أنَّهم لَا يُترَكونَ قالوا : تعيدُ أرواحَنا في أجسادِنا حتَّى نرجعَ إلى الدُّنيا، فنُقتلَ في سبيلِكَ مرَّةً أخرى "الراوي : مسروق بن الأجدع - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم 3011 - -خلاصة حكم المحدث : صحيح . قال صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابرُ ما لي أراكَ منكسِرًا ؟ قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ استُشْهِدَ أبي قُتِلَ يومَ أُحُدٍ، وترَكَ عيالًا ودَينًا، قالَ : أفلَا أبشِّرُكَ بما لقيَ اللَّهُ بِهِ أباكَ ؟ قلتُ : بلَى يا رسولَ اللَّهِ قالَ : ما كلَّمَ اللَّهُ أحدًا قطُّ إلَّا من وراءِ حجابِه وأحيا أباكَ فَكَلَّمَهُ كِفاحًا فقالَ : يا عَبدي تَمنَّ عليَّ أُعْطِكَ قالَ : يا ربِّ تُحييني فأقتلَ فيكَ ثانيةً قالَ الرَّبُّ تبارك وتعالَى : إنَّهُ قد سبقَ منِّي أنَّهم إليها لَا يُرجَعونَ قالَ : وأُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا" الآيةَ الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم - 3010 : خلاصة حكم المحدث : حسن . ثم بين- سبحانه - ما هم فيه من مسرة وحبور فقال: "فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"170. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ :أي: إنَّ هؤلاءِ الشُّهداءَ الَّذين قُتِلوا في سَبيلِ الله تعالى، وهم أحياءٌ عند ربهم ، مَسرورون بما منَحهم اللهُ تعالى إيَّاه، مِن النَّعيمِ المبهِجِ، والمُتعةِ العظيمةِ، جُودًا وكرَمًا منه سبحانه. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ: والِاسْتِبْشارُ: وأصل الاستبشار: طلب البشارة وهو الخبر السار الذي تظهر آثاره على البشرة، فساعة يكون الإنسان فرحا، فالفرحة تظهر وتشرق في وجهه ولذلك نسميهاالبشارة ، لأنها تصنع في وجه المُبَشَّر شيئا من الفرح مما يعطيه بريقا ولمعانا وجاذبية. والمراد هنا السرور استعمالا للفظ في لازم معناه. لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ: بِمَن بَقِيَ مِن إخْوانِهِمْ فالمُرادُ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ رُفَقاؤُهُمُ الَّذِينَ كانُوا يُجاهِدُونَ مَعَهم، ومَعْنى لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ لَمْ يُسْتَشْهَدُوا. وقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهم بَيْنَ المَسَرَّةِ بِأنْفُسِهِمْ والمَسَرَّةِ بِمَن بَقِيَ مِن إخْوانِهِمْ، لِأنَّ في بَقائِهِمْ نِكايَةً لِأعْدائِهِمْ، وهم مَعَ حُصُولِ فَضْلِ الشَّهادَةِ لَهم عَلى أيْدِي الأعْداءِ يَتَمَنَّوْنَ هَلاكَ أعْدائِهِمْ، لِأنَّ في هَلاكِهِمْ تَحْقِيقَ أُمْنِيَّةٍ أُخْرى لَهم وهي أُمْنِيَّةُ نَصْرِ الدِّينِ. فالمُرادُ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ رُفَقاؤُهُمُ الَّذِينَ كانُوا يُجاهِدُونَ مَعَهم، ومَعْنى لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ لَمْ يُسْتَشْهَدُوا فَيَصِيرُوا إلى الحَياةِ الآخِرَةِ.ابن عاشور ومصادر أخرى. فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله ، مستبشرون للمؤمنين الذين تركوهم من خلفهم في الدنيا من رفقائهم المجاهدين بأن لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا. ذهب إلى هذا المعنى الزجاج وابن فورك . ونفى عنهم الخوف والحزن، لأن الخوف يكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل. والحزن يكون بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في الماضي. فبين- سبحانه -أنه لا خوف عليهم فيما سيأتيهم من أحوال القيامة، ولا حزن لهم فيما فاتهم من متاع الدنيا. أي: إنَّ هؤلاء الشُّهداءَ مَسرورون أيضًا بإخوانِهم الَّذين ما زالوا أحياءً في عالَم الدُّنيا يُجاهِدون في سبيلِ الله تعالى؛ فإنَّهم إذا استُشهِدوا لحِقوا بهم، دون أن يُصيبَهم خوفٌ من أيِّ أمرٍ مستقبلٍ، أو حُزنٍ على أيِّ أمرٍ قد مضى، بل هم آمِنون دائمًا، وفَرِحونَ أبدًا. أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ :أي: لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما قضى من أمرهم؛ لأن الأصل أن الخوف للمستقبل والحزن للماضي. العثيمين. "لمَّا أُصيبَ إخوانُكم بأحدٍ جعلَ اللهُ عزَّ وجلَّ أرواحَهم في أجوافِ طيرٍ خُضرٍ تَرِدُ أنهارَ الجنةِ تأكلُ من ثمارِها وتَهوي إلى قناديلَ من ذهبٍ في ظلِّ العرشِ فلمَّا وجَدوا طيبَ شربِهم ومأكلِهم وحُسنَ مُتقلبِهم قالوا : ياليتَ إخوانَنا يعلمونَ بما صنعَ اللهُ لنا لِئلَّا يَزهدوا في الجهادِ ولا يَنكُلوا عنِ الحربِ فقال اللهُ عزَّ وجلَّ : أنا أُبلِّغُهم عنْكُم فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ هؤلاء الآياتِ على رسولِهِ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ.الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الوادعي - المصدر : صحيح أسباب النزول - الصفحة أو الرقم : 63 - خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره لشواهده.
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة رميلة ; 02-18-2025 الساعة 09:37 AM |
|
#4
|
||||
|
||||
|
من آية 171 إلى آية 179 " يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ" 171. استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل؛ لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانهم، والثاني فيما أنعم الله به عليهم، فهم لهم استبشارات متعددة، حسب ما يجدون من النعيم. بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ : إسناد النعمة إلى مُسدِيها، وهو الله جل جلاله، فهم لا يرون لأنفسهم فضلا بل يرون المنة والفضل لله عليهم. أي: إنَّ الشُّهداءَ يَفرَحون بما حَبَاهم اللهُ تعالى مِن النَّعيمِ العَظيم، وبما أَسبَغَ عليهم مِن جزيلِ ثوابِه الكريمِ، وزِيادةِ إحسانِه العميمِ. يَسْتَبْشِرُونَ : عُبر عنه بالمُضارع، فذلك يدل على التجدد، فهذا الاستبشار متجدد، وليس واقعًا مرة واحدة، وهذا يدل على تجدد متعلقه ومقتضاه، وأن هذه النعم تتجدد وتتكرر، ويأتيهم ألطاف بعد ألطاف، ونِعم بعد نِعم، وأفضال بعد أفضال. ولاحظ التنكير في قوله: بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ: يعني: يستبشرون بنعمة عظيمة، ويكفي في بيان عظمتها: أنه أضافها إلى الله تبارك تعالى؛ لأن المُضاف إلى العظيم لا شك أنه عظيم، نعمة لا يُقدر قدرها إلا الله. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ: أي: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد حَفِظ لأولئك الشُّهداءِ ما قدَّموه مِن الإيمانِ والأعمالِ الصَّالحةِ، وأعطاهم على ذلك أُجورَهم مِن فَضلِه سبحانه، وهكذا كلُّ مؤمنٍ؛ فإنَّ اللهَ تعالى لا يترُكُه، بل يُثيبُه .النعمة مفرد يُراد به جنس النعم . النعمة معناها الجمع كما نقله البغوي عن الحسن، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم "وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا "إبراهيم:34. وذلك لأن المفرد لا يصعب إحصاؤه، فالنعمة اسم جنس واسم الجنس يطلق مرادا به الجمع إذا أضيف كما ذكر الشيخ الشنقيطي في الأضواء، ومثل لذلك بهذه الآية، وبقوله تعالى"قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ "الحج:68.أي أضيافي ، وبقوله تعالى"فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ"النور:63. أي عن أوامره.والله أعلم.إسلام ويب. لِمَن قُتِل شهيدًا في سبيلِ الله فَضائِلُ كثيرةٌ عظيمةٌ، والحديثُ الآتي فيه بيانُ بَعضِ فَضائلِه تِلك، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "للشَّهيدِ عِندَ اللَّهِ ستُّ خصالٍ : يُغفَرُ لَه في أوَّلِ دَفعةٍ ويَرى مقعدَه منَ الجنَّةِ ويُجارُ مِن عذابِ القبرِ ويأمنُ منَ الفَزعِ الأكبرِ ويُوضعُ علَى رأسِه تاجُ الوقارِ الياقوتةُ مِنها خيرٌ منَ الدُّنيا وما فِيها ويزوَّجُ اثنتَينِ وسبعينَ زَوجةً منَ الحورِ العينِ ، ويُشفَّعُ في سبعينَ مِن أقاربِه"الراوي : المقدام بن معدي كرب - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم : 1663 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. قال صلى الله عليه وسلم " يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ." الراوي : عبدالله بن عمرو- صحيح مسلم. "الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ"172." الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"173. " فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ" 174. "إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"175 الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ : استجابوا لنداء النفير رغم ما أصابهم من جراحات وغيره من الآلام.لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا: بالاتباع ، وَاتَّقَوْا: بترك المخالفة، أَجْرٌ عَظِيمٌ: لهم أجر كثير واسع. غزوة حمراء الأسد هي المرادة من هذه الآية، فإن الأصح في سبب نزولها أن أبا سفيان وأصحابَهُ بعد أن انصرفوا من أُحُدٍ وبلغوا الروحاء، ندموا وقالوا: إنا قتلنا كثير منهم فلِمَ تركناهم؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم، فَهَمُّوا بالرجوعِ. فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن أصحابه قوة.فأمر بلالاً أن ينادي بالناس: إنّ رسول الله يأمركم بطلب عدوكم، وقد استجابوا وهم مرهقون ومتألمون ومثخنون بالجراح؛ فكل واحد منهم قد ناله نصيب من القرح يعني الألم أو الجرح، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه في أثر أبي سفيان وهم يحملون جراحهم، وأمر ألا يخرج معه إلا من شهد القتال في أُحد. كان هدف رسول الله من سَيره لحمراء الأسد إرهاب العدو، وإبلاغهم قوة المسلمين، وأن الذي أصابهم في أُحد لم يكن ليوهنهم عن عدوهم أو يفل من عزيمتهم. "كانَ يومُ أُحدٍ يومَ السَّبتِ للنصفِ من شوَّالٍ، فلمَّا كانَ الغدُ من يومِ الأحدِ لسِتَّ عشرةَ لَيلةً مضتْ من شوَّالٍ، أذَّنَ مؤذِّنُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في النَّاسِ بطلبِ العدوِّ، وأذَّنَ مؤذِّنُهُ ألَّا يخرجنَّ معَنا أحدٌ إلَّا من حضرَ يومَنا بالأمسِ. فَكَلَّمَهُ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنِ حرامٍ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبي كانَ خلَّفني علَى أخَواتٍ لي سبعٍ وقالَ : يا بُنَيَّ، إنَّهُ لا ينبغي لي ولا لَكَ أن نترُكَ هؤلاءِ النِّسوةَ لا رجلَ فيهنَّ، ولستُ بالَّذي أوثرُكَ بالجِهادِ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى نفسي، فتخلَّف علَى أخَواتِكَ، فتخلَّفتُ عليهنَّ، فأذِنَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فخرجَ معَهُ. وإنَّما خرجَ رسولُ اللَّهِ مُرهبًا للعدوِّ، وليبلغَهُم أنَّهُ خرجَ في طلبِهِم ليظنُّوا بِهِ قوَّةً، وأنَّ الَّذي أصابَهُم لم يوهِنُهم عن عدوِّهم.الراوي : محمد بن إسحاق - المحدث : أحمد شاكر - المصدر : عمدة التفسير -الصفحة أو الرقم1/440 - خلاصة حكم المحدث : أشار في المقدمة إلى صحته - التخريج : أخرجه ابن هشام في ((السيرة)) (2/ 100)، وابن إسحاق في ((مغازيه)) كما في ((البداية والنهاية)) (5/ 455) واللفظ لهما. "وهذا رجل من بني عبد الأشهل يصور حرص الصحابة على الخروج للجهاد فيقول:شَهِدْنا أُحُدًا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنا وأخٌ لي، فرَجَعْنا جَريحَيْنِ، فلَمَّا أذَّنَ مُؤذِّنُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالخُروجِ في طَلَبِ العَدُوِّ، قُلتُ لِأخي -أو قال-: أتَفوتُنا غَزوةٌ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ واللهِ ما لنا مِن دابَّةٍ نَركَبُها، وما مِنَّا إلَّا جَريحٌ ثَقيلٌ، فخَرَجْنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكُنتُ أيسَرَ جِراحًا منه، فكان إذا غُلِبَ حَمَلتُه عُقبةً، ومَشى عُقبةً، حتى انتَهَيْنا إلى ما انتَهى إليه المُسلِمونَ".الراوي : رجل من أصحاب رسول الله من بني عبدالأشهل - المحدث : أحمد شاكر - المصدر : عمدة التفسير- الصفحة أو الرقم : 1/440 : خلاصة حكم المحدث : أشار في المقدمة إلى صحته. وَكَانَتْ خُزَاعَةُ، مُسْلِمُهُمْ وَمُشْرِكُهُمْ عَيْبَةَ – أي هواهم مع النبي صلى الله عليه وسلم- نُصْحٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِتِهَامَةَ، صَفْقَتُهُمْ مَعَهُ، لَا يُخْفُونَ عَنْهُ شَيْئًا كَانَ بِهَا، وَمَعْبَدٌ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ – وقيل أسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أن يلحق أبا سفيان فَيُخَذِّلَه ـ ولم يكن أبو سفيان يعلم بإسلامه- ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمَا وَاَللَّهِ لَقَدْ عَزَّ عَلَيْنَا مَا أَصَابَكَ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّ اللَّهَ عَافَاكَ فِيهِمْ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، حَتَّى لَقِيَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ بِالرَّوْحَاءِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا الرَّجْعَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَقَالُوا: أَصَبْنَا حَدَّ أَصْحَابِهِ وَأَشْرَافَهُمْ وَقَادَتَهُمْ، ثُمَّ نَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ نَسْتَأْصِلَهُمْ! لَنَكُرَنَّ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ، فَلَنَفْرُغَنَّ مِنْهُمْ. فَلَمَّا رَأَى أَبُو سُفْيَانَ مَعْبَدًا، قَالَ: مَا وَرَاءَكَ يَا مَعْبَدُ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قَدْ خَرَجَ فِي أَصْحَابِهِ يَطْلُبُكُمْ فِي جَمْعٍ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ، يَتَحَرَّقُونَ عَلَيْكُمْ تَحَرُّقًا، قَدْ اجْتَمَعَ مَعَهُ مَنْ كَانَ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي يَوْمِكُمْ، وَنَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا ، فِيهِمْ مِنْ الْحَنَقِ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: وَيْحكَ! مَا تَقُولُ؟ قَالَ: وَاَللَّهِ مَا أَرَى أَنْ تَرْتَحِلَ حَتَّى أَرَى نَوَاصِيَ الْخَيل، قَالَ: فو الله لَقَدْ أَجْمَعْنَا الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، لِنَسْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ: قَالَ: فَإِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَاَللَّهِ لَقَدْ حَمَلَنِي مَا رَأَيْتُ عَلَى أَنْ قُلْتُ فِيهِمْ أَبْيَاتًا مِنْ شِعْرٍ، قَالَ: وَمَا قُلْتُ؟ قَالَ : لكن قبل أن يعود أبو سفيان لمكة حاول أن يغطي انسحابه هذا بشن حرب نفسية دعائية ضد الجيش الإسلامي، لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة ، فقد مر بأبي سفيان ركبٌ من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: المدينة، قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة، قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدًا رسالة أرسلكم بها إليه واحمل لكم إبلكم هذه غدًا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم، قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه، وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم ـ هو والمسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل وهو ماذكر في الآية التالية " الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"كَادَتْ تُهَدُّ مِنْ الْأَصْوَاتِ رَاحِلَتِي …إذْ سَالَتْ الْأَرْضُ بِالْجُرْدِ الْأَبَابِيلِ تَرْدِى بِأُسْدٍ كَرَامٍ لَا تَنَابِلَةٍ …عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَا مِيلٍ مَعَازِيلِ فَظَلْتُ عَدْوًا أَظُنُّ الْأَرْضَ مَائِلَةً …لَمَّا سَمَوْا بِرَئِيسٍ غَيْرِ مَخْذُولِ فَقُلْتُ: وَيْلَ ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمْ… إذَا تَغَطمطتُ الْبَطْحَاءُ بِالْجِيلِ إنِّي نَذِيرٌ لِأَهْلِ الْبَسْلِ ضَاحِيَةً …لِكُلِّ ذِي إرْبَةٍ مِنْهُمْ وَمَعْقُولِ مِنْ جَيْشِ أَحْمَدَ لَا وَخَشٍ تَنَابِلَةٍ …وَلَيْسَ يُوصَفُ مَا أَنْذَرْتُ بِالْقِيلِ ثم ذكر سائر الأبيات في جيش المسلمين .فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه وعاد. السيرة النبوية لابن هشام. وهكذا غيَّر أبو سفيان رأيه وخشي الهزيمة ومضى في طريقه إلى مكة، وعاد المسلمون إلى المدينة وقد حازوا ثواب هذه الغزوة دون أن يلقوا قتالًا أو يمسهم سوء. وهم الذين قال لهم بعض الناس المشركين - أراد بالناس الركب من عبد القيس: إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إليكم لاستئصالكم، فاحذروهم واتقوا لقاءهم، فإنه لا طاقة لكم بهم، فزادهم ذلك التخويف يقينًا وتصديقًا بوعد الله لهم، ولم يَثْنِهم ذلك عن عزمهم، فساروا إلى حيث شاء الله، وقالوا: حسبنا الله أي: كافينا، ونِعْم الوكيل المفوَّض إليه تدبير عباده. واستمر المسلمون في معسكرهم وأقاموا فيها ثلاثة أيام ، وآثرت قريش السلامة فرجعوا إلى مكة .. وعاد المسلمون بعد ذلك إلى المدينة بروح قوية متوثبة، مسحت ما حدث في أحد، فدخلوا المدينة أعزة رفيعي الجانب، قد أفسدوا انتصار المشركين، وأحبطوا شماتة المنافقين واليهود .. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ، قالَهَا إبْرَاهِيمُ عليه السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ في النَّارِ، وقالَهَا مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِينَ قالوا"إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"آل عمران: 173".الراوي : عبدالله بن عباس- صحيح البخاري . "فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ" 174 مِن صِدقِ الإيمانِ أنْ يَتيقَّنَ المؤمنُ أنَّ اللهَ هوَ كافِيه ما أهمَّه وألَمَّ بِه، وأنَّه نِعْمَ الكافي لِذلكَ، ويَتمثَّلُ هذا في القَولِ بِصِدقٍ: حَسبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوَكيلُ؛ فهوَ حَسبُنا وكافينا ونِعمَ المَولى ونِعمَ النَّصيرُ. وقالَها مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَقِبَ غَزوَةِ أُحدٍ؛ حَيثُ قيلَ: إنَّ المُشركينَ سَيَرجِعونَ إليكُم لِيُكمِلوا حَربَهُم، فَقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: حَسبُنا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ، فَكفاهُ اللهُ ذَلكَ؛ فمَنِ انتَصَرَ بِاللهِ نَصَرَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ، ومَن تَوكَّلَ على اللهِ فهوَ حَسبُه.الدرر. لما توكل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على الله حق توكله ؛ كفاهم الله وتولاهم ورجعوا من "حمراء الأسد" إلى "المدينة" بنعمة من الله بالثواب الجزيل وبفضل منه بالمنزلة العالية، وقد ازدادوا إيمانًا ويقينًا، وأذلوا أعداء الله، وفازوا بالسلامة من القتل والقتال، واتبعوا رضوان الله أي: اتبعوا ما يرضي الله عز وجل وذلك بالاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب رضاء الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا ممن يرضى الله عنهم.والله ذو فضل عظيم عليهم وعلى غيرهم، بمعنى صاحب فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ: بمعنى صاحب فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، إذ تفضل عليهم بزيادة الإيمان، والتوفيق إلى المبادرة إلى الجهاد، والجرأة على العدو، وحفظهم من كل ما يسوءهم. ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء بأن صرف عنهم عدوهم وجنبهم القتال ورجعوا أعزاء. وفي هذا التذييل زيادة تبشير للمؤمنين برعاية الله لهم، وزيادة تحسير للمتخلفين عن الجهاد في سبيله- عز وجل -، حيث حرموا أنفسهم مما فاز به المؤمنون الصادقون. كما أبرزت حكمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، الذي أراد أن لا يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس أصحابه الشعور بالهزيمة في أحد، فأزال بهذه الغزوة اليأس من قلوبهم، وأعاد لهم هيبتهم التي خُدِشت في أُحُد، ووضعهم على طريق التفاؤل والعزة والانتصارات، ثم قام بعد ذلك بمناورات وغزوات أعادت للمسلمين هيبتهم الكاملة، بل زادت فيها . "إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"175. إِنَّمَا:أداة حصر، والحصر عند العلماء إثبات الحكم للمحصور فيه، ونفيه عما سواه، إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات. أي: إن ترهيب من رَهَّبَ من المشركين، وقال: إنهم جمعوا لكم، داع من دعاة الشيطان، يخوف أولياءه المنافقين وضعفاء الإيمان ليقعدوا عن مقاتلة المشركين. فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله، لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله. "وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "176. يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ : أي: يسارعون إليه، ولكنه عدّى يسارع بـ(في) إشارة إلى أن هؤلاء يسارعون إلى الكفر ويتوغلون فيه. أي لا يحزنك يا محمد حال هؤلاء المارقين الذين يسارعون في الكفر وينتقلون فيه من دركة إلى دركة أقبح من سابقتها، فإنهم مهما تمادوا في كفرهم وضلالهم ومحاولتهم إضلال غيرهم، فإنهم لن يضروا دين الله أو أولياءه بشيء من الضرر حتى ولو كان ضررًا يسيرًا. يعني لن يضروا الله لا في ذاته، ولا في ملكه، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في غير ذلك، لن يضروا الله شيئًا أبدًا. ولقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم بمقتضى طبيعته البشرية، وغيرته على دين الله-تبارك وتعالى-يحزن لإعراض المعرضين عن الحق الذي جاء به، ولقد حكى القرآن ذلك في كثير من آياته، تبارك وتعالى"فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ" فاطر:8. وقوله -تبارك وتعالى"فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا" الكهف:6. فأراد- سبحانه -في هذه الآية الكريمة وأمثالها أن يزيل من نفس رسوله صلّى الله عليه وسلّم هذا الحزن الذي نتج عن كفر الكافرين، وأن يطمئنه إلى أن العاقبة ستكون له ولأتباعه المؤمنين الصادقين. عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فِيما رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أنَّهُ قالَ:يا عِبَادِي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَمُوا، يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلَّا مَن هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلَّا مَن أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يا عِبَادِي، إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يا عِبَادِي، إنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يا عِبَادِي، لو أنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا علَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُمْ؛ ما زَادَ ذلكَ في مُلْكِي شيئًا، يا عِبَادِي، لوْ أنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا علَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ ما نَقَصَ ذلكَ مِن مُلْكِي شيئًا، يا عِبَادِي، لو أنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فأعْطَيْتُ كُلَّ إنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ؛ ما نَقَصَ ذلكَ ممَّا عِندِي إلَّا كما يَنْقُصُ المِخْيَطُ إذَا أُدْخِلَ البَحْرَ، يا عِبَادِي، إنَّما هي أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا، فمَن وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَن وَجَدَ غيرَ ذلكَ فلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ. "الراوي-صحيح مسلم. يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ : أي:ليس لهم نصيبًا في نعيم الآخرة لأنهم مخلدون في النار؛ والإرادة هنا إرادة كونية قدرية، وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة،أما المؤمن فله نصيب في الآخرة، لكن قد يسبق بعذاب وقد لا يُسبق. أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية.جاء في التحرير والتنوير لابن عاشور"فَالْإِرَادَةُ وَالْمَشِيئَةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ" والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، وأنها قد تكون مما يحبه الله كالطاعات وقد تكون مما يبغضه الله كالمعاصي، وهذه الإرادة هي المطابقة لقولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي لا يقع في الكون خير أو شر إلا بمشيئة الله، فالإرادة الكونية أو المشيئة فإنها تكون في المحبوب وغيره، فكل ما في العالم من خير وشر فقد شاءه الله وأراده إرادة كونية بعلمه وحكمته .. ومثال هذا القسم: قوله تعالى عننوحعليه السلام "وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"هود:34.. إرادة الإغواء هنا هل هي مما يحبه الله ويرضاه؟ لا.إنما هي من مقتضى حكمته جل وعلا، فهي من الإرادة الكونية. قال أهل التفسير: يفعل ما يريد بأوليائه وأهل طاعته من الكرامة، وبأهل معصيته من الهوان؛بعلمه وحكمته. لأنه سبحانه لا يُعْجِزه شيء. "وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" الإنسان:30. "يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" الإنسان:31. وأما الإرادة الدينية الشرعية فلا تكون إلا مما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع. " يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " النساء" 26.هذه إرادة شرعية غير لازمة الوقوع، قد لا يتوب الله عز وجل على بعض من عصى، إنما هو يريد التوبة إرادة شرعية يحبها ويرضاها، لكن قد لا تقع من العبد. فالفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ثلاثة:الأول:أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله سبحانه والثانية بشرعه. الثاني:الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة.الثالث:الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. فإذا قال قائل:ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ أهو مراد بالإرادة الكونية أو الشرعية؟ .الجواب:إرادة كونية وشرعية؛ لأنه وقع بالإرادة الكونية، ولأنه متعلق بالشرع، فهو مما يحبه الله. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ:أي: لهؤلاء الذين يسارعون في الكفر عقوبة عظيمة. العِظم في كل موضع بحسبه، فقد يكون العظم مدحًا وقد يكون ذمًّا. ففي مقام المدح تكون العظمة مدحًا؛ وفي مقام الذم تكون العظمة ذمًّا؛ فقوله تعالى" وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ"النور:16. العظمة هنا ذمًّا. " مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ "البقرة105. "إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ "التوبة: 22. العظمة هنا مدحًا. "إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"177. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا :أي:اختاروا الكفر على الإيمان، وإلا فإن الكفر ليس سلعة يباع ويشترى، فالاشتراء هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر. .والتعبير بـ اشْتَرَوُا بيانُ شِدَّة رغبةِ الكفَّار في الكُفر؛ لأنَّهم اشتَرُوا الكفرَ اشتراءً، والمشترِي طالِبٌ للسِّلعة؛ فهم يأخذون الكفرَ عن رغبةٍ . يقول بعض علماء البلاغة:في هذه الجملة مجاز بالاستعارة المكنية أو الاستعارة التصريحية التبعية، فإنه شبه الكفر بالسلعة التي تباع .والاشتراء في الآية الكريمة بمعنى الاستبدال على سبيل الاستعارة التمثيلية فقد شبه- سبحانه - الكافر الذي يترك الحق الواضح الذي قامت الأدلة على صحته ويختار بدله الضلال الذي قامت الأدلة على بطلانه، بمن يكون في يده سلعة ثمينة جيدة فيتركها ويأخذ في مقابلها سلعة رديئة فاسدة. لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا : والمعنى أن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله لا في ذاته، ولا في ملكه، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في غير ذلك، لن يضروا الله شيئًا أبدًا ، وإنما يضرون بفعلهم هذا أنفسهم ضررًا بليغًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : أي: إنَّهم مع حِرمانِهم من نعيمِ الآخرة،لهم في الآخرة عذاب مؤلم شديد الإيلام، بسبب إيثارهم الغي على الرشد، والكفر على الإيمان، والشر على الخير. "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ"178. ثم بين سبحانه أن ما يتمتع به الأشرار في الدنيا من متع إنما هو استدراج لهم، وقوله نُمْلِي لَهُمْ من الإملاء وهو الإمهال والتخلية بين العامل والعمل ليبلغ مداه. يقال: أملى فلان لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء..ويطلق الإملاء على طول المدة ورغد العيش. والمعنى: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ، بتطويل أعمارهم، وبإعطائهم الكثير من وسائل العيش الرغيد هو، خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ كلا.بل هو سبب للمزيد من عذابهم، لأننا إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْمًا بكثرة ارتكابهم للمعاصي وَلَهُمْ في الآخرة عَذابٌ مُهِينٌ أى عذاب ينالهم بسببه الذل الذي ليس بعده ذل والهوان الذي يتصاغر معه كل هوان. " مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ "179. لِيَذَرَ:أي ليترك.الْمُؤْمِنِينَ: المراد المخلصون الذين صدقوا في إيمانهم .عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ :أي اختلاط المؤمنين بالمنافقين تحت مسمى الإسلام واستواؤهم في إجراء الأحكام. الْخَبِيثَ: أي المنافق ومن على شاكلته من ضعاف الإيمان.الطَّيِّبِ:أي الصادق في إيمانه. لَمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى عُقوبةَ المنافقين الأُخْرَويَّةَ، أَتْبعَها بوعيدِه للمنافقين بالعقوبةِ الدُّنيويَّةِ التي هي الفضيحةُ والخِزْي بالتمييزِ بينهما؛ لِيُظهرَ المؤمِنَ من المنافِق . مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ :أَيْ: إنَّه من الممْتَنِع على حِكْمةِ اللهَِ عزَّ وجلَّ أن يدَعَ عبادَه المؤمنين على ذات الحال التي هُم عليها من اختلاطِهم بالمنافِقين تحتَ مُسمَّى الإسلام الذي يَجمعهم، من دونِ أَنْ يُعْرَفَ هذا مِن هذا، بلْ لا بُدَّ أَنْ يَجعلَ كلَّ واحدٍ منهما مُتميِّزًا عن الآخر، مُنفصِلًا عنه بِلا لَبْسٍ بينهما؛ ولذا يُقَدِّرُ اللهُ تعالى أَسبابًا مِن المِحَن يُظهِر فيها ولِيَّه، ويُفضَحُ فيها عدُوَّهُ، كما فعلَ بهم يومَ أُحُدٍ ؛ فكان تقديرُ هذه الحوادثِ والوقائعِ؛ حتَّى يَحصُلَ هذا الامتياز.قال مجاهد: ميز بينهم يوم أُحُدٍ . وَما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ:معطوف على قوله تعالى"مَا كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ " .أَيْ: مِن الممتَنِع على حِكمَة الله تعالى أيضًا أَنْ يُطلِعَكم على ضَمائرِ قلوبِ عِبادِه؛ كَيْ يُظهرَ لكم المؤمِنَ من المنافِق. وَلكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ : لكنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يختارُ بعضَ رُسُله عليهم الصَّلاة والسَّلام؛ لِيُطلِعَهم على بعض الغيبِيَّات بحِكمتِه وإِذْنِه سُبحانَه، ومِن ذلك: إطْلاعُهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على عددٍ من المنافِقين. ولهذا سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - عددا من المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر،"ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إلى الشَّأْمِ، فَلَمَّا دَخَلَ المَسْجِدَ، قالَ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسَ إلى أبِي الدَّرْدَاءِ، فَقالَ أبو الدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أنْتَ؟ قالَ: مِن أهْلِ الكُوفَةِ، قالَ: أليسَ فِيكُمْ -أوْ مِنكُمْ- صَاحِبُ السِّرِّ الذي لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي حُذَيْفَةَ، قالَ: قُلتُ: بَلَى،....." صحيح البخاري. . يَقصِدُ حُذَيفةَ بنَ اليَمانِ رَضيَ اللهُ عنه، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعلَمَه بالمُنافِقينَ وأحْوالِهم، وأطْلَعَه على بَعضِ ما يَجْري لهذه الأمَّةِ بعْدَه، وجعَل ذلك سِرًّا بيْنَه وبيْنَه. الدرر السنية. قال الحافظ ابن حجر :والمراد بالسر ما أعلمه به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال المنافقين.إسلام ويب. الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسَرَّ إلى حذيفة بأسماء رجال من المنافقين ولم يُسِر إلى أبي بكر ولا عمر، ولا إلى من هو أفضل من حذيفة، وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية، وهي أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق، وأن الفضل نوعان:مطلق، ومقيد، فهنا لا شك أن حذيفة - رضي الله عنه - امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي - صلى الله عليه وسلم - من أسماء هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له فضل مطلق عليه، كأبي بكر وعمر ومن أشبههما، وعليه فإننا لا نعلم عما في قلوب هؤلاء ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه - صلى الله عليه وسلم. وأطلعه على حال تلك المرأة التي أرسلها حاطب بن أبى بلتعة برسالة إلى قريش لتخبرهم باستعداد الرسول صلّى الله عليه وسلّم لحربهم. "بَعَثَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَا والزُّبَيْرَ والمِقْدَادَ، فَقالَ: انْطَلِقُوا حتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ ، فإنَّ بهَا ظَعِينَةً معهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ منها فَذَهَبْنَا تَعَادَى بنَا خَيْلُنَا حتَّى أتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أخْرِجِي الكِتَابَ، فَقالَتْ: ما مَعِي مِن كِتَابٍ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فأخْرَجَتْهُ مِن عِقَاصِهَا، فأتَيْنَا به النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَإِذَا فيه مِن حَاطِبِ بنِ أبِي بَلْتَعَةَ إلى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِمَّنْ بمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ ببَعْضِ أمْرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما هذا يا حَاطِبُ؟ قالَ: لا تَعْجَلْ عَلَيَّ يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ امْرَأً مِن قُرَيْشٍ، ولَمْ أكُنْ مِن أنْفُسِهِمْ، وكانَ مَن معكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لهمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بهَا أهْلِيهِمْ وأَمْوَالَهُمْ بمَكَّةَ، فأحْبَبْتُ إذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فيهم، أنْ أصْطَنِعَ إليهِم يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وما فَعَلْتُ ذلكَ كُفْرًا، ولَا ارْتِدَادًا عن دِينِي، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّه قدْ صَدَقَكُمْ فَقالَ عُمَرُ: دَعْنِي يا رَسولَ اللَّهِ فأضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقالَ: إنَّه شَهِدَ بَدْرًا وما يُدْرِيكَ؟ لَعَلَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ اطَّلَعَ علَى أهْلِ بَدْرٍ فَقالَ: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قالَ عَمْرٌو: ونَزَلَتْ فِيهِ"يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أوْلِيَاءَ" قالَ: لا أدْرِي الآيَةَ في الحَديثِ أوْ قَوْلُ عَمْرٍو"الراوي : علي بن أبي طالب - صحيح البخاري. قال تعالى "عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا " الجن:26. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا " الجن:27.. ثم أمر الله تعالى عبادَهُ أن يثبتوا على الإيمان، وبشرهم بالأجر العظيم إذ هم استمروا على ذلك فقال: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ: حققوا إيمانكم بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام، والانقياد والإذعان بدون اعتراض، لا على القضاء والقدر، ولا على الحكم الشرعي. وهكذا حال المؤمن حقًا وهو الانقياد لأمر الله الكوني فيرضى به، والانقياد لأمر الله الشرعي فينفذه ويذعن له، مع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعا أو كرهًا. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.أي: وإن تؤمنوا بما جاءوا به من أخبار الغيب، مع تقوى الله بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به، فلكم الثواب العظيم، والأجر الجزيل الذي لا يستطاع الوصول إلى معرفة كنهه. " قالَ اللَّهُ: أعْدَدْتُ لِعِبادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ علَى قَلْبِ بَشَرٍ."الراوي : أبو هريرة - صحيح البخاري. |
|
#5
|
||||
|
||||

من آية 180 إلى آية 187 ثم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء مصير الذين يبخلون بنعم الله ، فلا يؤدون حقها . ولا يقومون بشكرها .وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"180. قوله : بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ:إشعار بسوء صنيعهم ، وخبث نفوسهم ، حيث بخلوا بشىء ليس وليد عملهم واجتهادهم ، وإنما هذا الشىء منحه الله - تعالى - لهم بفضله وجوده ، فكان الأولى لهم أن يشكروه على ما أعطى ، وأن يبذلوا مما أعطاهم في سبيله . أَيْ: لا تظنَّنَّ- يا مُحمَّدُ- ولا يظنَّنَّ هؤلاء الذين يشِحُّون بأموالهم التي رزَقهم الله تعالى؛ كرَمًا منه عن أداء حقِّه فيها، أَنَّ بُخلَهم هذا خيْرٌ لهم من العطاء الذي يُنقص المال كما يبدو في الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم" ما نقصت صدقة من مال ومازاد الله رجلا بعفو إلا عِزًا ، أو ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله"صحيح سنن الترمذي. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ: أَيْ: ليس الأمرُ كما يَظنُّون؛ فامتناعُهم عن أداءِ حَقِّ الله تعالى فيما رزَقَهم من أموالٍ بُخْلًا منهم، هو في حقيقةِ الأمْرِ شرٌّ من هذا النقْصِ الذي يَبدو لهم، ومضرَّةٌ عليهم في دِينهم ودُنياهم. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْ: سيَجعل اللهُ تعالى المالَ الذي بَخِل به مَن منَعَ حقَّ اللهِ تعالى فيه، سيجعلُه طَوْقًا يُحيطُ بعُنُقِ صاحبه، ويُعذَّب به يوم القيامة. عَن أبي هُرَيرَةَ رَضِي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال"مَن آتاه الله مالًا فَلم يُؤدِّ زَكاتَه، مُثِّلَ له مالُه شُجاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ- يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ "ثمَّ تلا هذه الآية: وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...إلى آخِرِ الآية" رواه البخاريُّ :4565. وقال الله عزَّ وجلَّ"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ "التوبة: 34-35. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ:والمعنى : أن لله - تعالى - وحده لا لأحد غيره ما في السموات والأرض فما بال هؤلاء القوم يبخلون عليه بما يملكه ، ولا ينفقونه فى سبيله ؛ فهو المالكُ ذو المَلَكوت، والحيُّ الباقي الَّذي لا يموتُ؛ فأنفِقوا في حياتِكم مِمَّا جعلَكم اللهُ عزَّ وجلَّ مُستَخلَفين فيه، وقدِّموا فيها من أموالِكم ما يَنفعُكُم يومَ تأتون إلى الله سُبحانَه، وليس معكم شيءٌ مِمَّا كنتُم تملكون. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: أَيْ: إِنَّ الله عزَّ وجلَّ مُطَّلِعٌ على خفايا أعمال الخلْق ومُطَّلِعٌ على نيَّاتهم وضمائرهم، وسيجازيهم على أعمالهم ونيَّاتهم بحسْبها، ومن ذلك: هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله تعالى من فَضْلِه؛ فإنَّ الله سبحانَه مُطَّلِعٌ على ما يُخفونَ ويَكنِزون، ويعلمُ إنْ كانوا قد أدَّوا حقَّ الله تعالى فيه أمْ لا، وإِنْ خَفِيَ ذلك على غيرِه. "لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ" 181. الآية تثبت صفة السمع لله تعالى ، واسم الله السميع ثابت لقوله تعال" َليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" الشورى: 11. معنى الاسم في حق الله تعالى: قال الخطابي رحمه الله "السميع: هو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت، والنطق والسكوت"، والسماع قد يكون بمعنى القبول والإجابة.. فمن معاني السميع: المُستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء وتضرعوا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشعومن دعاء لا يُسمع.." صحيح الجامع:1297. أي: من دعاء لا يُستجاب رابط المادةg3p قالَ أبو بَكْرٍ لفِنْحاصَ -وكانَ مِن عُلَماءِ اليَهودِ وأحْبارِهم: اتَّقِ اللهِ وأَسلِمْ، فوَاللهِ إنَّك لتَعلَمُ أنَّ مُحمَّدًا رَسولٌ مِن عِنْدِ اللهِ، قد جاءَكم بالحَقِّ مِن عِنْدِه تَجِدونَه مَكْتوبًا عِنْدَكم في التَّوْراةِ والإنْجيلِ، قالَ فِنْحاصُ: واللهِ يا أبا بَكْرٍ ما سَأَلْنا اللهَ مِن فَقْرٍ وإنَّه لإلَيْنا فَقيرٌ، وما نَتَضَرَّعُ إليه كما يَتَضَرَّعُ إلينا، وإنَّا لأَغْنياءُ، ولو كانَ عنَّا غَنِيًّا ما اسْتَقْرَضْنا أمْوالَنا كما يَزعُمُ صاحِبُكم! يَنْهانا عن الرِّبا ويُعْطيناه، ولو كانَ غَنِيًّا عنَّا ما أَعْطانا الرِّبا ، فغَضِبَ أبو بَكْرٍ فضَرَبَ وَجْهَ فِنْحاصَ، فأَخبَرَ فِنْحاصُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأبي بَكْرٍ: ما حَمَلَك على ما صَنَعْتَ بفِنْحاصَ؟ فأَخبَرَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما قالَ، فقامَ فجَحَدَ فِنْحاصُ، وقالَ: ما قُلْتُ لك، فأَنزَلَ اللهُ"لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ" إلى قَوْلِه"عَذَابَ الْحَرِيقِ"، نَزَلَتْ في أبي بَكْرٍ وما فَعَلَه في ذلك مِن غَضَبِه". الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الضياء المقدسي - المصدر : الأحاديث المختارة-الصفحة أو الرقم : 12 / 256 - خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال :هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم. حسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ،وقال أحمد شاكر أن إسناده جيد أوصحيح. والمعنى : لقد سمع الله - تعالى - قول أولئك اليهود الذين نطقوا بالزور والفحش فزعموا أن الله - تعالى - فقير وهم أغنياء، وهو تطاول على ذات الله ، وكذب عليه ، ووصف له بما لا يليق به - سبحانه . وهذا السمع لازمه العلم والإحاطة بما يقولون من قبائح ، ثم محاسبتهم على ما تفوهوا به من أقوال ، وما ارتكبوه من أعمال ، ومعاقبتهم على جرائمهم بالعقاب المهين الذين يستحقونه . هذا قولهم في الله ، وهذه معاملتهم لرسل الله ، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. وقوله"سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأنبياء بِغَيْرِ حَقٍّ"أي سنسجل عليهم فى صحائف أعمالهم قولهم هذا، أي نأمر الحفظة بإثبات قولهم حتى يقرءوه يوم القيامة في كتبهم التي يؤتونها ; حتى يكون أوكد للحجة عليهم ، كما سنسجل عليهم قتلهم أنبياء الله بغير حق. .وقتل الأنبياء دوما بغير حق ولكن سيقت هذه العبارة كقيدٍ كاشفٍ وليس قيدًا احترازيًا. وقد قرن - سبحانه - قولهم المنكر هذا ، بفعل شنيع من أفعال أسلافهم ، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق؛ وذلك لإثبات أصالتهم فى الشر ، وإستهانتهم بالحقوق الدينية ، وللتنبيه على أن قولهم هذا ليس أول جريمة ارتكبوها ، ومعصية استباحوها ، فقد سبق لأسلافهم أن قتلوا الأنبياء بغير حق ، وللإشعار بأن هاتين الجريمتين من نوع واحد ، وهو التجرؤ على الله - تعالى ،وبهذا كله يكونون قد عتوا عتوًا كبيرًا ، وضلوا ضلالا بعيدا . وأضاف - سبحانه - القتل إلى المعاصرين للعهد النبوي من اليهود ، مع أنه حدث من اسلافهم؛ لأن هؤلاء المعاصرين كانوا راضين بفعل أسلافهم ولم ينكروه وإن لم يكونوا قد باشروه ، ومن رضى بجريمة قد فعلها غيره فكأنما قد فعلها هو . وفى الحديث الشريف " إذا عُمِلت الخطيئةُ في الأرضِ كان من شهِدها فكرِهها – وقال مرَّةً : أنكرها – كمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضِيها، كان كمن شهِدها"الراوي : العرس بن عميرة الكندي -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم:4345 - خلاصة حكم المحدث : حسن.كانَ مَن شَهِدَها"، أي: كانَ الذي حضَرَها وفُعِلَت أمامَه، أو عَلِمَ بها "فكَرِهَهاوقالَ مرَّةً: أنكرَها"، أي: أنكرَها بيدِه ولِسانِه، أو أنَّه كرِهَها بقَلبِه ولم يرضَ بها، "كمَنْ غابَ عَنها"، أي: كانَ مِن جَزائهِ أنَّه يكونُ في حُكمِ مَن لم يحضُرْها فلَم يقعْ علَيهِ إثمٌ. "ومَن غابَ عَنها فرَضِيَها"، أي: ومَن لم يَقعْ أمامَه مُنكَرٌ أو مَعصيةٌ، ولكنَّه سمِعَ بها ثم أَعجَبتْه ولم يُنكِرْها بقَلبِه. "كانَ كمَنْ شَهِدَها"، أي: كانَ مِن جَزائِه أن يقعَ عليهِ إثمُ مَن شَهِدَ المنكرَ ورَضِيَه ولم يُغيِّرْه معَ قُدرتِه على ذلكَ لأن سكوته عن النكر بمثابة إقرا لهذا القول القبيح . ووصف - سبحانه - قتلهم الأنبياء بأنه"بِغَيْرِ حَقٍّ"مع أن هذا الإجرام لا يكون بحق أبدًا ، للإشارة إلى شناعة أفعالهم ، وضخامة شرورهم ، وأنهم لخبث نفوسهم ، وقسوة قلوبهم لا يبالون أكان فعلهم في موضعه أم في غير موضعه . وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ :أي : سنجازيهم بما فعلوا ، ونلقي بهم في جهنم ، مخاطبين إياهم بقولنا : ذوقوا عذاب تلك النار المحرقة التي كنتم بها تكذبون . والذوق حقيقته إدراك المطعومات ، والأصل فيه أن يكون فى أمر مرغوب في ذوقه وطلبه ، والتعبير به هنا عن ذوق العذاب هو لون من التهكم عليهم ، والاستهزاء بهم كما فى قوله - تعالى– "فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"الانشقاق: 24."إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا""النساء: 56. ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ.نسأل الله العافية . ثم صرح - سبحانه - بأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بوقوعهم فى العذاب المحرق فقال : "ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ" 182.ذَلِكَ: إشارة إلى عذاب الحريق. والحق سبحانه لم يظلمهم، لكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. "بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ" والمراد بالأيدي الأنفس، والتعبير بالأيدي عن الأنفس من قبيل التعبير بالجزء عن الكل. وخصت الأيدي بالذكر، للدلالة على التمكن من الفعل وإرادته، ولأن أكثر الأفعال يكون عن طريق البطش بالأيدي، ولأن نسبة الفعل إلى اليد تفيد الالتصاق به والاتصال بذاته. فاليد هي الجارحة التي نفعل بها أكثر أمورنا، وعلى ذلك يكون قول الحق"بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ"مقصود به: بما قدمتم بأي جارحة من الجوارح. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ: فالله لا يظلم كافرًا، ولا يظلم مؤمنًا، بل يجازي كل إنسان بعمله . نفى سبحانه عن نفسه صفة الظلم مع ملاحظة أن الصفات المنفيةعن الله عز وجل لا يراد بها مجرد النفي، بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد، فإذا نفى أن يكون ظلامًا للعبيد فذلك لكمال عدله، وإذا نفى أن تأخذه سنة ولا نوم فذلك لكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكمال قوته، وهكذا، ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي مجرد فصفات النفي تتضمن كمال الضد، وهذه قاعدة " لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال"والدليل قوله تعالى" "وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " النحل: 60.والنفي المجرد ليس مثلا أعلى، المثل الأعلى أي:الوصف الأعلى والأكمل، والنفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون وصفًا أعلى. "الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ"183. بِقُرْبَانٍ:والقربان هو ما يتقرب به إلى الله من نعم أو غير ذلك من القربات. يقول تعالى تكذيبًا أيضًا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أنه يتصدق بصدقة فيتقبلها الله منه وعلامة قبولها نزول نار من السماء تأكل هذه الصدقة. وأن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه تنزل نار من السماء تأكلها . قاله ابن عباس والحسن وغيرهما . وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أُحلت الغنائمُ لأمةِ محمد صلى الله عليه وسلم. فجمعوا بين الكذب على الله، وحصر آيات الرسل بما قالوه، من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم -في ذلك- مطيعون لربهم بزعمهم الباطل ، ملتزمون عهده، وقد عُلِمَ أنَّ كلَّ رسولٍ يرسلُه اللهُ، يؤيده من الآيات والبراهين ، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه، وباطلا لم يعملوا به، والمعنى: أن عذابنا الأليم سيصيب أولئك اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا إن الله أمرنا في التوراة وأوصانا بأن لا نصدق ونعترف لرسول يدَّعي الرسالة إلينا من قِبَلِ الله-تبارك وتعالى- حتى يأتينا بقربان يتقرب به إلى الله، فتنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان. ثم أمر الله رسوله أن يقول لهم ردًا على زعمهم الباطل "قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ: أي جاءكم الرسل من قبلي بالدالات وبالآيات البينات التي تبين صدق رسالتهم. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ:أي جاؤوا أيضًا بالذي ذكرتم من القُربان الذي تحرقه نار من السماء، فلِمَ كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون!؟. يعني زكريا ويحيى ... ، وسائر من قُتلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم .أراد بذلك أسلافهم، وذلك لأن أسلافهم طلبوا هذه المعجزة من الأنبياء المتقدمين فلما أظهروا لهم هذا المعجزة سعوا في قتلهم بعد أن قابلوهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة. ومتأخرو اليهود راضون بفعل متقدميهم. لذا الله تعالى سمى اليهود قتلة لرضاهم بفعل أسلافهم ، وإن كان بينهم نحو من سبعمائة سنة . "فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ "184. أَيْ: إنْ كَذَّبَك- يا مُحمَّدُ- سواء قريش أوأهل الكتاب أوكل من كذب الرسل ، فلا يُوهِنك ولا يَحزُنك ذلك ولا تبتئس ، ولك أُسْوَة بمَن قبلَك؛ فأنتَ لستَ بأوَّلِ مَن يُكذَّب، بل كُذِّب عددٌ من الرُّسُل عليهم السَّلام مع أنَّهم أتَوا أقوامَهمبِالْبَيِّنَاتِ :والبينات هي: الحُجَج القاطِعة والمعجِزات الباهِرة السَّاطعة.وَالزُّبُرِ: جمع زبور، والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر، ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر.وَالْكِتَابِ: بمعنى المكتوب. الْمُنِيرِ: بمعنى المنير للظلمات. المضيئةِ لطريق الحقِّ بذكْرِ الأحكامِ العادِلة والأخبارِ الصَّادِقة. وهذا العطف الذي في قوله" وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ"هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى؛ لأن الزبر تتضمن الكتاب المنير. فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات. الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم، ولهذا كان مهيمنا على ما سبق من الكتب، فكل الكتب التي سبقت منسوخة به. فالمعنى الإجمالي: لا تحزن فقد كُذِّب رسل من قبلك جاؤوا بمثل ما جئت به من باهر المعجزات و هَزُّوا القلوب بالزواجر و العظات و أناروا بالكتاب سبيل النجاة فلم يُغْنِ ذلك عنهم شيئا فصبروا على ما نالهم من أذى و ما نالهم من سخرية و استهزاء. و في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لأن طباع البشر في كل الأزمنة سواء فمنهم من يتقبل الحق و يُقْبِل عليه بصدر رحب و نفس مطمئنة و منهم من يقاوم الحق و الداعي إليه و يسفه أحلام معتنقيه. من فوائد الآية الكريمة:تسليةُ الرسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام، ويتفرَّع عليها أنْ يَتسلَّى الإنسان ويهون عليه في كلِّ ما أصاب غيرَه. "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ "185. بعد أن سلَّى نبيه فيما سلف عن تكذيب قومه له بأن كثيرََا من الرسل قبلك قد كُذِّبوا كما كُذِّبت و لاقَوْا من أقوامهم من الشدائد مثل ما لاقيت بل أشد مما لاقيت فقد قَتلوا كثيرا منهم كيحيى و زكرياء عليهما السلام- زاده هنا تسلية و تعزية أخرى فأبان أن كل ما تراه من عنادهم فهو مُنته إلى غاية و كل آت قريب فلا تضجر و لا تحزن على ما ترى منهم فإنَّ مصيرَهم ومصيرَ غيرِهم إليه سبحانه ، وعُبر عن حدوث الموت لكل نفس بذوقه ، للإشارة إلى أنه عند ذوق المذاق إما مُرًّا لما يستتبعه من عذاب ، وإما حلوًا هنيئا بسبب ما يكون بعده من أجر وثواب . أن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قالَ"إنَّ المَيِّتَ تَحضُرُه المَلائِكةُ، فإذا كانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قالوا: اخْرُجي أيَّتُها النَّفْسُ الطَّيِّبةُ كانَتْ في الجَسَدِ الطَّيِّبِ، واخْرُجي حَميدةً، وأَبْشِري برَوْحٍ ورَيْحانٍ، ورَبٍّ غَيْرِ غَضْبانَ، فلا يَزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّى تَخرُجَ، ثُمَّ يُعرَجُ بِها إلى السَّماءِ، فيُسْتَفتَحُ له، فيُقالُ: مَن هذا؟ فيُقالُ: فُلانٌ، فيُقالُ: مَرْحبًا بالنَّفْسِ الطَّيِّبةِ كانَت في الجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلي حَميدةً، وأَبشِري، ويُقالُ: برَوْحٍ ورَيْحانٍ، ورَبٍّ غَيْرِ غَضْبانَ، فلا يَزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّى يُنْتَهى بها إلى السَّماءِ الَّتي فيها اللهُ عَزَّ وجَلَّ، فإذا كانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قالوا: اخْرُجي أيَّتُها النَّفْسُ الخَبيثةُ كانَت في الجَسَدِ الخَبيثِ ، اخْرُجي مِنه ذَميمةً، وأَبشِري بحَميمٍ وغَسَّاقٍ ، وآخَرَ مِن شَكْلِه أزْواجٍ، فما يَزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّى تَخرُجَ، ثُمَّ يُعرَجُ بها إلى السَّماءِ، فيُسْتَفتَحُ لها، فيُقالُ: مَن هذا؟ فيُقالُ: فُلانٌ، فيُقالُ: لا مَرْحبًا بالنَّفْسِ الخَبيثةِ كانَت في الجَسَدِ الخَبيثِ ، ارْجِعي ذَميمةً؛ فإنَّه لا يُفتَحُ لكِ أبْوابُ السَّماءِ، فتُرسَلُ مِن السَّماءِ، ثُمَّ تَصيرُ إلى القَبْرِ، فيَجلِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فيُقالُ له ويَرُدُّ "الراوي : أبو هريرة- المحدث : الوادعي- المصدر : الصحيح المسند-الصفحة أو الرقم- 2/342خلاصة حكم المحدث : صحيح. فالموت حتم على جميعِهم و أنهم سيجازون على أعمالهم في دار الجزاء كما تجازى و حسبُك ما تصيب من حسن الجزاء و حسبهم ما أصيبوا به و ما يصابون به من سوء الجزاء في الدنيا و سيوفون الجزاء كاملا يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها، وتخدع بغرورها، وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة، ومنتقل عنها إلى دار القرار، التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار، من خير وشر. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يعني:توفون أجور أعمالكم، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشر، والتوفية تقتضي أن هناك شيئًا سابقا يزاد، وهو كذلك، فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله، ولاسيما الإحسان إلى الخلق، وقضاء حوائجهم؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ. "الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم- المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم : 2699 . فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ: وجمع - سبحانه - بين زُحْزِحَ عَنِ النار وَأُدْخِلَ الجنة مع أن في الثاني غُنية عن الأول ، للإشعار بأن دخول الجنة يشتمل على نعمتين عظيمتين وهما : النجاة من النار "زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ" ، والتلذذ بنعيم الجنة " وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ" . قال صلى الله عليه وسلم "إنَّ موضعَ سوطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها واقرؤوا إن شئتُم"فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغُرُور"الراوي : أبو هريرة- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الترغيب- الصفحة أو الرقم - 3767خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح. إنَّ موضعَ سوطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها :ليست دنياك التي أنت فيها، وليست دنياك الخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دانية، من الدنو وهو الانحطاط.تفسير العثيمين. أي: إنَّ مَن رأى هولَ القِيامةِ والحِسابِ والصِّراطِ والموقفِ بين يَديِ اللهِ وغيرِ ذلك من أهوالِ الموقِفِ، ثمَّ يُنَجِّيه اللهُ من ذلك كلِّه، ومن عَذابِ النَّارِ، ويُدْخِلُه الجنَّةَ؛ ويُفوزُ فِيها وَلْو بِموضِعِ قَدمٍ، أو مَوْضِعِ سَوطٍ، يعلَمُ عندَ ذلك أنَّ نَعيمَ الدُّنيا وزِينتَها كان غُرورًا، ولا قِيمةَ له، ولأنَّ زِينةَ الحياةِ الدُّنيا إنْ فَتَنتْ أحدًا ورَكَنَ إليها، ورأى أنَّه لا شَيءَ غيرُها، أو تعجَّلَها؛ فقدِ اغتَرَّ بترْكِ الأعْلى إلى الأدنى، واستبدَلَ الباقِيَ بالفاني.الدرر السنية. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ : يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصعة ثم تزول ولا تبقى .تصغيرا لشأن الدنيا ، وتحقيرًا لأمرِها ، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة . فالغرور إذن أن تلهيك متعة قصيرة الأجل عن متعة عالية لا أمد لانتهائها ،الحياة الدنيا متاع غرور ممن غر بالتافه القليل عن العظيم الجليل..فالدنيا ليست إلا متاعًا من شأنه أن يغرّ الإنسانَ ويشغله عن تكميل نفسه بالمعارف والأخلاق التي ترقى بروحه إلى سعادة الآخرة. فينبغي له أن يحذر من الإسراف في الاشتغال بمتاعها عن نفسه وإنفاق الوقت فيما لا يفيد، إذ ليس للذاتها غاية تنتهَى إليها فلا يبلغ حاجة منها إلا طلب أخرى. " لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" 186. لَتُبْلَوُنَّ :والابتلاء: الاختبار، والله سبحانه أحيانًا يختبر بخير وأحيانًا يختبر بشر كما قال تعالى " وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً"الأنبياء:35. وكما قال تعالى عن سليمان "قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ" النمل: ٤٠. وذلك أن الإنسان دائر بين حالين إما شيء يُسَر به ويفرح به، فهذا وظيفته الشكر، وإما شيء يسوؤه ويحزنه فهذا وظيفته الصبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام "عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له."الراوي : صهيب بن سنان الرومي - صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم : 2999 . والمعنى : لتبلون - أيها المؤمنون - ولتختبرن في أَمْوَالِكُمْ بما يصيبها من الآفات ، وبما تطالبون به من إنفاق في سبيل إعلاء كلمة الله ، ولتختبرن أيضًا فيأَنْفُسِكُمْ بسبب ما يصيبكم من جراح وآلام من قبل أعدائكم ، وبسبب ما تتعرضون له من حروب ومتاعب وشدائد ، وفضلا عن ذلك فإنكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وهم اليهود والنصارى وَمِنَ الذين أشركوا وهم كفار العرب ، لتسمعن من هؤلاء جميعًا أَذًى كَثِيرًا كالطعن فى دينكم ، والاستهزاء بعقيدتكم ، والسخرية من شريعتكم والاستخفاف بالتعاليم التي أتاكم بها نبيكم ، والتفنن فيما يضركم . وقد رتب - سبحانه - ما يصيب المؤمنين ترتيبًا تدريجيًا ، فابتدأ بأدنى ألوان البلاء وهو الإصابة في المال ، فإنها مع شدتها وقسوتها على الإنسان إلا أنها أهون من الإصابة في النفس لأنها أغلى من المال ، ثم ختم ألوان الابتلاء ببيان الدرجة العليا منه وهي التي تختص بالإصابة في الدين ، وقد عبر عنها بقوله: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذين أشركوا أَذًى كَثِيرًا. وإنما كانت الإصابة في الدين أعلى أنواع البلاء ، لأن المؤمن الصادق يهون عليه ماله ، وتهون عليه نفسه ، ولكنه لا يهون عليه دينه ، ويسهل عليه أن يتحمل الأذى في ماله ونفسه ولكن ليس من السهل عليه أن يؤذى في دينه ...ولقد كان أبو بكر الصديق مشهورًا بلينه ورفقه . ولكنه مع ذلك - لقوة إيمانه - لم يحتمل من " فنحاص " اليهودي أن يصف الخالق - عز وجل - بأنه فقير ، فما كان من الصديق إلا أن شجَّ وجه فنحاص عندما قال ذلك القول الباطل" ، فغَضِبَ أبو بَكْرٍ فضَرَبَ وَجْهَ فِنْحاصَ"حسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ،وقال أحمد شاكر أن إسناده جيد أوصحيح. وقد جمع - سبحانه - بين أهل الكتاب وبين المشركين فى عداوتهم وإيذائهم للمؤمنين ، للإشعار بأن الكفر ملة واحدة ، وأن العالم بالكتاب والجاهل به يستويان فى معاداتهم للحق ، لأن العناد إذا استولى على القلوب زاد الجاهلين جهلًا وحمقًا ، وزاد العالمين حقدًا وحسدًا ثم أرشد - سبحانه - المؤمنين إلى العلاج الذي يعين على التغلب على هذا البلاء فقال: وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذلك مِنْ عَزْمِ الأمور : أي : وإن تصبروا على تلك الشدائد ، وتقابلوها بضبط النفس ، وقوة الاحتمال. والصبر هو حبس القلب واللسان والجوارح عما يغضب الله عز وجل. قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام:١ - صبر على طاعة الله، وهو أعلى الأقسام.٢ - صبر عن معصية الله، وهو دونه.٣ - وصبر على أقدار الله المؤلمة،وهو دون الإثنين الأوليين؛ لأن الإثنين الأوليين: صبر على شرع الله، والثالث صبر على قدر الله، والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر، ومن الناطق والبهيم، لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من المؤمن، ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور؛ لأن الصبر عن المحظور كف فقط، والصبر على المأمور فعل؛ فهو إيجاد وعمل، ففيه نوع من الكلفة بخلاف الصبر عن فعل المحظور، فإنه ليس إلا مجرد كف، على أنه قد يكون أحيانا بالنسبة للنفس أشد من الصبر على فعل المأمور، فيسهل على بعض الناس مثلا أن يصلي، لكن يصعب عليه أن يدع ما حرم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثا.صبر الصائم على الصيام، من الأول، وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش، من الثالث، وصبره عما حرم عليه بالصوم من الثاني، ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر؛ لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم، ففيه -أي في الصيام- صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار.ومن الأمثلة: صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه في البئر من الثالث، وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثاني، صبر عن المعصية، وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول.وَتَتَّقُواْ: أي وتتقوا الله في كل ما أمركم به ونهاكم عنه ، تنالوا رضاه - سبحانه - وتنجوا من كيد أعدائكم . والإشارة في قوله فَإِنَّ ذلك مِنْ عَزْمِ الأمورِ: أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة لأنها شاقة على النفس، والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكُمَّل من الخلق، قال تعالى " فَاصبِر كَما صَبَرَ أُولُو العَزمِ مِنَ الرُّسُلِ " الأحقاف: 35. فَإِنَّ ذلك مِنْ عَزْمِ الأمورِ:تعود إلى المذكور ضمنًا من الصبر والتقوى ، أي فإن صبركم ابتغاء وجه الله وتقواكم هذا من عزم الأمور أي مِن الأمورِ التي تَحتاج إلى هِمَّة عالية، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية. من الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل أحد لما فيه من كمال المزية و الشرف. فالآية الكريمة استئناف مسوق لإيقاظ المؤمنين ، وتنبيههم إلى سنة من سنن الحياة ، وهي أن أهل الحق لا بد من أن يتعرضوا للابتلاء والامتحان ، فعليهم أن يوطنوا أنفسهم على تحمل كل ذلك ، لأن ضعفاء العزيمة ليسوا أهلا للفوز . "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ"187. الميثاق : هو العهد الموثق المؤكد . ثم حكى - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائل أهل الكتاب ، فقد أخذ - سبحانه - العهد على الذين أوتو الكتاب بأمرين :أولهما : بيان ما في الكتاب من أحكام وأخبار . وثانيهما : عدم كتمان كل شىء مما فى هذا الكتاب . والمعنى : واذكر أيها المخاطب وقت أن أخذ اللهُ العهدَ المؤكدَ على أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن يبينوا جميع ما فى الكتاب من أحكام وأخبار وبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وألا يكتموا شيئًا من ذلك ، لأن كتمانهم للحق سيؤدي إلى سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة . والضمير فى قوله "لَتُبَيِّنُنَّهُ " يعود إلى الكتاب المشتمل على الأخبار والشرائع والأحكام والبشارات الخاصة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل الضمير يعود إلى الميثاق ، ويكون المراد من العهد الذي وثقه الله عليهم هو تعاليمه وشرعه ونوره . وقوله وَلاَ تَكْتُمُونَهُعطف على " لَتُبَيِّنُنَّهُ" وإنما لم يؤكد بالنون لكونه منفيًا . وجمع - سبحانه - بين أمرهم المؤكد بالبيان وبين نهيهم عن الكتمان مبالغة فى إيجاب ما أمروا به حتى لا يقصروا في إظهار ما في الكتاب من حقائق وحتى لا يلجأوا إلى كتمان هذه الحقائق أو تحريفها . ولكن أهل الكتاب - ولا سيما العلماء منهم - نقضوا عهودهم مع الله - تعالى - ، وقد حكى - سبحانه - ذلك فى قوله: فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ . النبذ : الطرح والترك والإهمال . أي أن أهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهود الموثقة بأن يبينوا ما في الكتاب ولا يكتموا شيئا منه ، لم يكونوا أوفياء بعهودهم ، بل إنهم نبذوا ما عاهدهم الله عليه ، وطرحوه وراء ظهورهم باستهانة وعدم اعتداد . وأخذوا في مقابل هذا النبذ والطرح والإهمال شيئا حقيرًا من متاع الدنيا وحطامها ، فبئس الفعل فعلهم . والتعبير عنهم بقوله فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كناية عن استهانتهم بالمنبوذ ، وإعراضهم الشديد عنه بالكلية ، وإهمالهم له إهمالًا تامًا ، لأن من شأن الشىء المنبوذ أن يهمل ويترك ، كما أن من شأن الشىء الذي هو محل اهتمام أن يحرس ويجعل نصب العين . والضمير فى قولهفَنَبَذُوهُيعود على الميثاق باعتبار أنه موضع الحديث ابتداء .ويصح أن يعود إلى الكتاب ، لأن الميثاق هو الشرائع والأحكام ، والكتاب وعاؤها ، فنبذ الكتاب نبذ للعهد . واشتروا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً:والمراد " بالثمن القليل " أي: استبدلوا به ثمنا قليلا، أي بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا، وما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ هو إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم؛ لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدًا زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا: نكذب محمدًا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم، إذن ما هو المبيع، وما هو الثمن؟المبيع: العهد. والثمن: الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ووصف الله هذا بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا قليل . تفسير الشيح محمد صالح العثيمين. والثمن قليل مهما كثر زهيد لا يدوم للإنسان، ولا يدوم الإنسان له، بل لابد من زواله، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه وإن بلغ ما بلغ من أعراض الدنيا بجانب ومقابل رضا الله – تعالى. قوله فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ:بئس كلمة ذم . أى بئس شراؤهم هذا الشراء لاستحقاقهم به العذاب الأليم . وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، وجوب إظهار الحق ، وتحريم كتمانه .قال الشيخ العثيمين رحمه الله:يؤخذ منها - وجوب بيان العلم على أهل العلم فيبينوا العلم الذي آتاهم الله، ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال، قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون في المجالس العامة، وقد يكون في المجالس الخاصة، على حسب الحال؛ لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين.ا.هـ. وعن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال "مَن سُئلَ عَن علمٍ علمَهُ، ثمَّ كتمَهُ، أُلجِمَ يومَ القِيامةِ بلِجامٍ مِن نارٍ"الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم : 2649 - خلاصة حكم المحدث : صحيح .
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
تفسير سورة آل عمران من آية 188إلى آية 200 " لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "188. كان الكلام قبل هذا مع أهل الكتاب و أنه قد أخذ عليهم الميثاق بتبيين كتابهم للناس فقصروا في ذلك و تركوا العمل به و اشتروا به ثمنًا قليلا فاستحقوا العقاب من ربهم. وهنا ذكر حالا أخرى من أحوالهم ليحذر المؤمنين منها و هو أنهم كانوا يفرحون بما أتوا من التأويل و التحريف للكتاب والأعمال التي يتقربون بها إلى الله على زعمهم و يرون لأنفسهم شرفا فيه و فضلا بأنهم أئمة يُقتدَى بهم و كانوا يحبون أن يحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب و مفسروه و هم لم يفعلوا شيئًا من ذلك و إنما فعلوا نقيضه إذ حولوه من الهداية إلى ما يوافق أهواء الحكام و أهواء العامة. "أنَّ رِجَالًا مِنَ المُنَافِقِينَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الغَزْوِ تَخَلَّفُوا عنْه، وفَرِحُوا بمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَإِذَا قَدِمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اعْتَذَرُوا إلَيْهِ، وحَلَفُوا وأَحَبُّوا أنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ"لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بما أتَوْا ويُحِبُّونَ أنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا" الآيَةَ.الراوي : أبو سعيد الخدري -صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم:4567. عمومُ المعنى: أنه تعالَى يُخاطِبُ نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ لا يَظُنَّ هو، ولا يَظُنَّ الذين يَفرحون بما فَعَلوه من أعمالٍ -ككِتْمان العِلم لمَن سَأَلهم كاليهودِ، والتخلُّفِ عن الغزْوِ في سَبيلِ اللهِ تعالَى كالمنافِقين، وكأعمالِ المتزيِّنين للنَّاسِ المُرائين لهم بما لم يَشرَعْه اللهُ ورَسولُه- ويُحبُّون أنْ يُثنِيَ عليهم النَّاسُ بما لم يَعملوه؛ أنَّهم سيَنجُون مِن عَذابِ الله، بلْ لهم عَذابٌ أليمٌ! وقد دلَّ مفهومُ قَولِه تعالَى "وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا"آل عمران: 188. على أنَّ مَن أحبَّ أنْ يُحمَدَ ويُثنى عليه بما فعَلَه من الخيرِ واتِّباعِ الحقِّ، إذا لمْ يكُن قصْدُه بذلك الرِّياءَ والسُّمْعَةَ- أنَّه غيرُ مَذمومٍ، بلْ هذا مِن الأمورِ التي جازَى بها اللهُ تعالَى خَواصَّ خَلْقِه، وسَأَلوها مِنه، كما قال إبراهيمُ عليه السَّلامُ"وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "الشعراء: 84. والمراد ب " اللسان " القول . وفيه استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل . واجعل لي ثناء حسنًا وذكرًا جميلا في الذين يأتون بعدي إلى ما شاء الله . من فضل الله على العبد أن يجعل ألسنة الخلق تذكره بخير .. فقد تُمدح يومًا .. المهم أن يكون المدح صدقا فيك .. وليس شرطا أن تسمع ذكرك الحسن في حياتك ربما تثني عليك الأجيال القادمة..!! فـ أينما توقفت سفينة حياتك اترك أثرًا نافعًا .. وامض وشعارك "وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ." فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: -أنَّ مَرْوَانَ، قالَ: اذْهَبْ يا رَافِعُ، لِبَوَّابِهِ، إلى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كانَ كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا فَرِحَ بما أَتَى وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بما لَمْ يَفْعَلْ، مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ:ما لَكُمْ وَلِهذِه الآيَةِ؟ إنَّما أُنْزِلَتْ هذِه الآيَةُ في أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ تَلَا ابنُ عَبَّاسٍ"وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ" هذِه الآيَةَ، وَتَلَا ابنُ عَبَّاسٍ"لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا"، وَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: سَأَلَهُمُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن شيءٍ فَكَتَمُوهُ، إيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بغَيْرِهِ، فَخَرَجُوا قدْ أَرَوْهُ أَنْ قدْ أَخْبَرُوهُ بما سَأَلَهُمْ عنْه وَاسْتَحْمَدُوا بذلكَ إلَيْهِ، وَفَرِحُوا بما أَتَوْا مِن كِتْمَانِهِمْ إيَّاهُ، ما سَأَلَهُمْ عنْه."الراوي : عبدالله بن عباس -صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم :2778. فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : فلا يظنون أنهم بمحل نجوة من العذاب وسلامة، بل قد استحقوه، وسيصيرون إليه، بلْ لهم عَذابٌ أليمٌ! وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الجملة هذه استئنافية، لمَّا بيَّن أنهم ليسوا بناجين من العذاب أكد هذا بقوله:وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أليم بمعنى مؤلم موجع. فهم يظنون أن انتصارهم في معركة الدنيا لا هزيمة بعده، ولكنه سبحانه قال بعد هذه الآية : " وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"189. بعد قوله تعالى " فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : قال سبحانه : وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" فلا أحد يستطيع أن يخرج من ملكه، وما دام لله ملك السماوات والأرض، فهذا الوعيد سيتحقق، فالله حين يوعد فهو - سبحانه - قادر على إنفاذ ما أوعد به، ولن يفلت أحد منه أبدا. فإذا ما سر أعداء الدين في فورة توهم الفوز، فالمؤمن يفطن إلى النهاية وماذا ستكون؟ ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى قال "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ *مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ*سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ*وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ"المسد:1:5.وهذه السورة قد نزلت في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكانت هذه السورة دليلا من أدلة الإيمان بصدق الرسول في البلاغ عن الله، لأن أبا لهب كان كافرا، وكان هناك كفرة كثيرون سواه، ألم يكن عمر بن الخطاب منهم؟ ألم يكن خالد بن الوليد منهم؟ ألم يكن عكرمة بن أبي جهل منهم؟ ألم يكن صفوان منهم؟ كل هؤلاء كانوا كفارا وآمنوا، فمن الذي كان يُدري محمدًا صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يقول "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ *مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ*سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ*وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ"المسد:1:5. من كان يدري محمدا بعد أن يقول هذا ويكون قرآنا يتلى ويحفظه الكثير من المؤمنين، وبعد ذلك كله من كان يدريه أن أبا لهب يأتي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد يضيف: إن كان محمد يقول: إنني سأصلى نارا ذات لهب فهأنذا قد آمنت، من كان يدريه أنه لن يفعل، مثلما فعل ابن الخطاب، وكما فعل عمرو بن العاص. إن الذي أخبر محمدا يعلم أن أبا لهب لن يختار الإيمان أبدًا، فيسجلها القرآن على نفسه، وبعد ذلك يموت أبو لهب كافرا. إذن فقول الحق سبحانه بعد قوله" فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" قال سبحانه بعدها " وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" يوضح لنا أنه قد ضم هذا الوعيد إلى تلك الحقيقة الإيمانية الجديدة.وواقعة لا محالة.فجميع المخلوقات محصورة بين سماء تظل، وأرض تقل، فكل منا محصور بين مملوكين لله، وما دام كل منا محصورًا بين مملوكين لله، فأين تذهبون؟إن لله الملك وله القدرة المطلقة ، ولا يعجزه أحدٌ. بعد أن بيَّنَ- سبحانه - أن ملك السموات والأرض بقبضته، أشار- سبحانه - إلى ما فيهما من عبر وعظات فقال: " إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ "190. الخلق: هو الابتداع على غير مثال سبق. أي: إن في إيجاد السموات والأرض على هذا النحو البديع، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب وبحار وزروع وأشجار ...وفي إيجاد الليل والنهار على تلك الحالة المتعاقبة، وفي اختلافهما طولا وقِصَرًا.. وفي كل ذلك لأمارات واضحة، وأدلة ساطعة، لأصحاب العقول السليمة على وحدانية الله-تبارك وتعالى- وعظيم قدرته، وباهر حكمته. فالآية فيها حث للعباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها.وورد في هذه الآية : ويلٌ لمن قرأَها ولم يتفَكَّر فيها. يَقولُ التَّابعيُّ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: دَخَلتُ أنا وعُبَيدُ بنُ عُمَيرٍ وهو أحَدُ التَّابِعينَ، على عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. دَخَلوا عِندَها لزيارَتِها وسُؤالِها "دخلتُ أَنا وعُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ على عائشةَ فقالت لعُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ : قد آنَ لَكَ أن تزورَنا ؟ فقالَ : أقولُ يا أمَّه كما قالَ الأوَّلُ زُرْ غِبًّا تزدَدْ حبًّا قالَ فقالَت دَعونا من رطانَتِكم هذِهِ قالَ ابنُ عُمَيْرٍ أخبرينا بأعجَبِ شيءٍ رأيتِهِ من رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آله وسلَّمَ - قالَ فسَكَتَت ثمَّ قالت لمَّا كانَ ليلةٌ منَ اللَّيالي قالَ: يا عائشةُ ذريني أتعبَّدُ اللَّيلةَ لربِّي قلتُ واللَّهِ إنِّي لأحبُّ قربَكَ وأحبُّ ما سرَّكَ قالَت فقامَ فتطَهَّرَ ثمَّ قامَ يصلِّي قالَت فلَمْ يزَلْ يَبكي حتَّى بلَّ حِجرَهُ قالَت ثمَّ بَكى فلم يزَلْ يبكي حتَّى بلَّ لِحيتَهُ قالَت ثمَّ بَكَى فلم يزَل يَبكي حتَّى بلَّ الأرضَ فجاءَ بلالٌ يؤذنُهُ بالصَّلاةِ فلمَّا رآهُ يبكي قالَ: يا رسولَ اللَّهِ لِمَ تَبكي وقد غَفرَ اللَّهُ لَكَ ما تقدَّمَ وما تأخَّرَ قالَ: أفلا أَكونُ عبدًا شَكورًا لقد نَزَلَت عليَّ اللَّيلةَ آيةٌ ويلٌ لمن قرأَها ولم يتفَكَّر فيها" إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ..." آل عمران: 191. الآيةَ كلَّها".الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : الوادعي -المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم - 1627 : خلاصة حكم المحدث : حسن. يَرْوي ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما أنَّه باتَ عندَ خالتِهِ مَيْمُونةَ بنتِ الحارِثِ أُمِّ المُؤمنينَ رَضِي اللهُ عنها، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَبِيتُ عندها في لَيلتِها: "أنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهو يقولُ"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ"آل عمران: 190، فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ حتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فأطَالَ فِيهِما القِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذلكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذلكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بثَلَاثٍ، فأذَّنَ المُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إلى الصَّلَاةِ وَهو يقولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ في سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ في بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِن خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِن فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا."الراوي : عبدالله بن عباس- صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله :فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم " انتهى. قال ابن كثير- رحمه الله:وقد ثبت أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده .ا.هـ. لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ :هذا الخلق وتدبره آيات وعلاماتٍ لأصحابِ العقولِ السَّليمةِ - التي تُدرِكُ حَقائقَ الأشياء، فتدلُّهم على أنَّ خالقَ ذلك هو الربُّ المعبودُ وحْدَه سبحانه، كما تدلُّهم على صِفاتِ الله تبارَك وتعالَى - فَلُب الشيء هو خلاصته وصفوته. لَمَّا ذكَر اللهُ تعالى أنَّ الذين يَنتفعونَ بتلك الآياتِ هم أُولو الألبابِ، شرَعَ في وصْفِهم ، فقال: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ""191. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ:أي: إنَّ أُولي الألبابِ هم الذين يستحضرون عظمته في قلوبهم ويُديمون ذِكرَ اللهِ تعالى بقلوبِهم وألْسنتِهم، وفي جميعِ أحوالِهم، في حالِ وُقوفِهم، وحالِ جُلوسِهم، وحالِ اضطجاعِهم.وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ثم وصفهم سبحانه وتعالى بوصف آخر فقال :وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: يضيفون إلى هذا الذكر؛ التدبر والتفكر في هذا الكون وما فيه من بديع المخلوقات، وآيات بينات على توحيد الخالق، ليصلوا من وراء ذلك إلى الإيمان العميق، والإذعان التام، والاعتراف الكامل بوحدانية الله.وعظيم قدرته... فإن من شأن الأخيار من الناس أنهم يتفكرون في مخلوقات الله وما فيها من عجائب المصنوعات، وغرائب المبتدعات، ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع- سبحانه -، فيعلموا أن لهذا الكون قادرًا مدبرًا حكيمًا، لأن عظم آثاره وأفعاله، تدل على عظم خالقها.إذن فساعة يفكر الإنسان بعقله لابد أن يقول: إن وراء خلق الكون قوة خارقة. وقد عرفها العربي بفطرته فقال: البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟! وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل، حتى يكون عندك عقل غريزي وعقل مكتسب.تفسير العثيمين. ثم حكى- سبحانه - ثمرات ذكرهم لله وتفكرهم في خلقه فقال:رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا : أي: إنَّهم حين يَتفكَّرون في خَلْقِ السَّمواتِ والأرض، يقولون: إنَّك يا ربَّنا، لم تَخلقْ هذا الخَلْقَ عبثًا ولا لهوًا؛ فأنتَ مُنزَّهٌ عن ذلك، ولكنَّك خلقتَه لحِكمةٍ ولأمرٍ عظيمٍ، من تكليفٍ وبعْثٍ، وحسابٍ وجزاءٍ، فتُجزي كلَّ أحدٍ بما عمِله من خيرٍ أو شرٍّ. الثناء على ذوي العقول؛ لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لأولي العقول، وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل، حتى يكون عندك عقل غريزي وعقل مكتسب. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ:أي أنهم بعد أن أذعنت قلوبهم للحق، ونطقت ألسنتهم بالقول الحسن، وتفكرت عقولهم في بدائع صنع الله تفكيرًا سليمًا، استشعروا عظمة الله استشعارًا ملك عليهم جوارحهم، فتوسلوا بإيمانهم هذا وتفكرهم فرفعوا أكف الضراعة إلى الله بقولهم:يا ربنا إنك ما خلقت هذا الخلق البديع العظيم الشأن عبثا، أو عاريًا عن الحكمة، أو خاليًا من المصلحة، سُبْحانَكَ أي ننزهك تنزيها تامًّا عن كل مالا يليق بك ،قدّموا التنزيه المتضمّن لكل كمال قبل السؤال لشدّة رجائهم في الوقاية من هذا المهلك الرهيب،فَقِنا عَذابَ النَّارِ :أي أَجِرْنا من عذابِ النارفوفقنا للعمل بما يرضيك بأنْ تُوفِّقَنا للأعمالِ الصالحات، وتُجنِّبَنا بفضلِك الذُّنوبَ والسيِّئات، واصرف عنا عذاب النار برحمتك وفضلك. "رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار"ٍ192. والخزي: مصدر خزي يخزى بمعنى ذل وهوان بمرأى من الناس، أي مَن أدخلتَه النارَ يا رَبَّنا، فقدْ أَهنتَه وفَضحْتَه على رؤوس الأشهاد. لَمَّا سألوا ربَّهم أن يَقيَهم عذابَ النار، أتْبعوا ذلك بما يدلُّ على عِظَمِ ذلك العقابِ وشِدَّته وهو الخزي والفضيحة، ليكون موقع السؤال أعظم.وفي هذا .. مبالغة في تعظيم أمر العقاب بالنار، وإلحاح في طلب النجاة منها، قيل : قال أنس وقتادة معناه : إنك من تُخَلِّد في النارِ فقد أخزيته وقال سعيد بن المسيب هذه خاصة لمن لا يخرج منها. نسأل الله الستر والعفو والعافية في الدنيا والآخرة . وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار :أي: إنَّهم إنما دخلوا النارَ بظُلمِهم، وليس للظالمِ يَومَ القيامةِ أحدٌ يُنقذُه من عذابِ اللهِ تعالى ، فيوم القيامة لا مجير لهم منك، ولا محيد لهم عما أردت بهم، و " مِنْ " للدلالة على استغراق النفي، أي لا ناصر لهم أيا كان هذا الناصر، وفي ذلك إشارة إلى انفراد الله-تبارك وتعالى- بالسلطان ونفاذ الإرادة. "رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ" 193. . رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ :أي: إنَّهم قالوا: يا ربَّنا، إنَّنا قد سمِعْنا داعيًا يَدْعو إلى الإيمانِ، وهو الرسول محمد ، وقيل: المنادِي هو كتابُ اللَّهِ تعالى، وكلاهما صحيح ومتعيّن. قال أبو الدرداء: يرحم الله المؤمنين ما زالوا يقولون"ربنا ربنا"حتى استجيب لهم، واختلف المتأولون في المنادِي، فقال ابن جريج وابن زيد وغيرهما: المنادِي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن كعب القرظي: المنادِي كتاب الله وليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه، ولما كانت ينادي بمنزلة يدعو، حسن وصولها باللام بمعنى "إلى الإيمان.تكرار لفظ ربنا فيه استحباب الإلحاح في الدعاء، والإلحاح من أسباب إجابة الدعاء. وفيه إظهار الضراعة والخضوع لله رب العالمين .وفيه التوسل بالربوبية حال الدعاء وهو ورد كثيرا في القرآن في سياقات دعوات الأنبياء في القرآنفأكثر دعوات الأنبياء كانت بالتوسل بالربوبية ومثل ذلك قول إبراهيم عليه السلام "رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" الشعراء:83. "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ" آل عمران:38.وقول سليمان عليه السلام "قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي"ص: 35.وقول موسى عليه السلام"فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ"القصص: 24.وقول إبراهيم عليه السلام"رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ" إبراهيم:40. " قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ "المائدة: 114. عيسى عليه السلام توسل في دعائه بالأولوهية بقوله اللهم وكذلك بالربوبية بقوله ربنا. أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا :أي: يقولُ للنَّاسِ: آمِنوا بربِّكم، فَآمَنَّا:يلاحظ أن المتعلَق محذوف قالوا آمنا – آمنا بماذا!؟- المعنى هنا أننا آمنا بكل شيء يجب الإيمان به،من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به ومنه بقية الأصول الستة، لذلك الكلمات قد يُستغنى بمُجملِها عن تفصيلِها فتفيد العموم، فحذف المتعلَق هنا يفيد عموم الإيمان بما يجب الإيمان به.الإيمان بالله عز وجل: هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان وليس مجرد الإقرار، ولو كان الإيمان مجرد الإقرار لكان أبو طالب مؤمنًا لأنه مقر، ولكنه لا يكون إيمانا حتى يتضمن القبول والإذعان، يعني الانقياد. فَآمَنَّا:فاء التعقيب؛ للدَّلالةِ على المبادرةِ والسَّبقِ إلى الإيمان، أي فسارعنا إلى الاستجابةِ له، فأَقرَرْنا بالحقِّ وقبِلْناه، مُنقادِين إليه، ومُذعِنين له، وفي سرعة امتثالهم دلالة على سلامة فطرتهم، وبعدهم عن المكابرة والعناد. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا :أي: بإيمانِنا واتِّباعِنا نبيّك، استُرْ علينا ذُنوبَنا، وتجاوزْ عن مُؤاخذتِنا بها. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا : أي: بإيمانِنا واتِّباعِنا نبيّك، امحُ عنَّا خَطايانا؛ فالحسناتُ يُذهِبْنَ السيِّئاتِ.قال تعالى" أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ"هود: 114. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ : أي: اجعلْنا إذا قَبضتَ أرواحَنا إليك في عِدادِ الصَّالحين. ومعنى وفاتهم مع الأبرار: أن يموتوا على حالة البر والطاعة وأن تلازمهم تلك الحالة إلى الممات، وألا يحصل منهم ارتداد على أدبارهم، بل يستمروا على الطاعة استمرارا تامًا، وبذلك يكونون في صحبة الأبرار وفي جملتهم. "رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ "194. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ:أي: أعطِنا- يا ربَّنا- ما وعَدتَنا به على ألْسنةِ رُسلِك عليهم السَّلامُ، من النَّصرِ على الأعداء ، ومِن الثوابِ على الأعمالِ الصَّالحة. فائدة: قوله عَلى رُسُلِكَ فيه مضاف محذوف أي آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من ثواب.و "ما" موصولة أي آتنا الذي وعدتنا به أو وعدتنا إياه. فقد وعد سبحانه بسيادة الدنيا في قوله تعالى " وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ"النور: 55. وقال سبحانه "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ "محمد:7. ووعد بسعادة الآخرة فقال " وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ"التوبة:72. فالمؤمنون ذوو الألباب مستمرون في التوسل بالربوبية والضراعة لله وتَرَقُّوا فانتقلوا من طلب الغفران إلى طلب الثواب الجزيل، والعطاء الحسن في الدنيا والآخرة. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ :إشارة إلى قوله تعالى "يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" التحريم:8. أي: لا تَفْضَحْنا بذُنوبِنا على رُؤوسِ الخلائقِ، ولا تُذِلَّنا يومَ القيامةِ. إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ : أي نسألك يا ربنا إنجاز الوعد، فإن قلت: كيف دعوا الله بإنجاز ما وعد والله لا يخلف الميعاد؟وهو تعالى من لا يجوز عليه خلف الوعد. قلت: معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد، والتخوف إنما هو في جهتهم لا في جهة الله تعالى لأن هذا الدعاء إنما هو في الدنيا، فمعنى قول المرء: اللهم أنجز لي وعدك، إنما معناه: اجعلني ممن يستحق إنجاز الوعد. تلك هي الدعوات الخاشعات التي حكاها- سبحانه - عن أصحاب العقول السليمة، وهم ينضرعون بها إلى خالقهم- عز وجل -فماذا كانت نتيجتها؟ نتيجتها ما ورد في الآية التالي: "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ"195. فَاسْتَجَابَ : أي: أجاب الله دعاءهم، دعاء العبادة - الإيمان بالله عز وجل وهو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان- ، ودعاء الطلب .ولم يقل فأجاب ولكن قال فاستجاب فالسين والتاء تفيد معنى التأكيد، أجاب أخص من استجاب، لأن استجاب لا تُقال إلا لمن قَبِلَ ما دُعيَ إليه. أما أجاب تُقال لمن أجاب بالقَبول أو الرفض. عَنِ الْفَرَّاءِ ، وَعَلِيِّ بْنِ عِيسَى الرَّبَعِيِّ : أَنَّاسْتَجَابَ أَخَصُّ مِنْ أَجَابَ ، لِأَنَّ اسْتَجَابَ يُقَالُ لِمَنْ قَبِلَ مَا دُعِيَ إِلَيْهِ ، وَ أَجَابَ أَعَمُّ، فَيُقَالُ لِمَنْ أَجَابَ بِالْقَبُولِ ، وَبِالرَّدِّ. أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ: لا أضيع: يعني لا أهدره بل أحتسبه.وقوله" عَمَلَ عَامِلٍ " " عَمَلَ " هنا مضاف فيقتضي العموم يعني: أي عمل قل أو كثر فإن الله لا يضيعه، وهذا كقوله"فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ"7."وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍشَرًّا يَرَهُ"8.الزلزلة.عن أمِّ سلمةَ رضِيَ اللهُ عَنها "أنَّها قالت : يا رسولَ اللَّهِ، لا نسمعُ اللَّهَ ذَكَر النِّساءَ في الهجرةِ بشيءٍ ؟ فأنزلَ اللَّهُ تعالى :فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى إلى آخرِ الآيةِ. وقالتِ الأنصارُ : هيَ أوَّلُ ظعينةٍ قدمَتْ علَينا"خلاصة حكم المحدث :أشار في المقدمة إلى صحته -الراوي : أم سلمة أم المؤمنين- المحدث :أحمد شاكر- المصدر :عمدة التفسير- الصفحة أو الرقم1/451. "قالت يا رسولَ اللَّهِ لا أسمعُ اللَّهَ ذَكرَ النِّساءَ في الهجرَةِ فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ"الراوي : أم سلمة أم المؤمنين- المحدث :الألباني-المصدر : صحيح الترمذي- الصفحة أو الرقم: 3023 - خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره. شرح الحديث :لقد راعى الشَّرعُ الحكيمُ أحوالَ النَّاسِ مِن حيث النَّوعُ والقدرةُ على التَّحمُّلِ، وجعَل التَّكاليفَ أنواعًا؛ فمِنها ما يَشترِكُ فيه الجميعُ ذُكورًا وإناثًا، ومنها تكاليفُ خاصَّةً بكلِّ نوعٍ تتَناسَبُ مع طبيعةِ الخِلْقةِ، ومع ما يُناطُ بكلِّ نوعٍ مِن أعباءِ الحياةِ، دون حَيفٍ أو جَورٍ بأحَدِ النَّوعينِ، ورتَّب الأجرَ على الأعمالِ، والله يتفضَّلُ على مَن يَشاءُ مِن عبادِه. وفي هذا الحديثِ تَسأَلُأمُّ سلمةَ أمُّ المؤمنينَ رضِيَ اللهُ عَنها النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فتقولُ "يا رسولَ اللهِ، لا أسمَعُ اللهَ ذكَر النِّساءَ في الهجرةِ"، أي: ما تَكلَّم اللهُ في كتابِه في شأنِ النِّساءِ اللَّاتي هاجَرْن في سبيلِ اللهِ؟ فأنزل اللهُ تبارك وتعالى قولَه" أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ "آل عمران: 195، " أَنِّي لَا أُضِيعُ" أي: لا أُحبِطُ عمَلَكم أيُّها المؤمِنون، بل أُثيبكم عليه، ولا أَمحو ولا أُزيل ثوابَه وأجرَه " عَمَلَ عَامِلٍ" ، يريدُ وجهَ اللهِ وثوابَ الآخرةِ، " مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى" بل الكلُّ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ يُجازَى ويُكافَأُ بما وعَد اللهُ مِن الثَّوابِ والفضلِ، " بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" أي: لأنَّ الذَّكرَ مِن الأنثى، والأنثى مِن الرَّجلِ، وقيل: أي: مُتعاوِنون في النُّصرةِ وإخوةٌ في الدِّينِ. وقيل: كلُّكم مِن آدمَ وحوَّاءَ، وقيل: بمعنى بعضُكم كبَعضٍ في الثَّوابِ على الطَّاعةِ، والعِقابِ على المعصيةِ، وقيل: إنَّ الرِّجالَ والنِّساءَ في الطَّاعةِ على شكلٍ واحدٍ. وفي الحديثِ: بيانُ فضلِ وعدلِ اللهِ سبحانه وتعالى.الدرر السنية. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا :أي: فَالَّذِينَ هَاجَرُوا بأن تركوا أوطانهم التي أحبوها إلى أماكن أخرى من أجل إعلاء كلمة الله. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ: وأُخرجوا من بيوتهم فرارًا بدينهم من ظلم الظالمين، واعتداء المعتدين،أخرجوا إما مباشرة بأن طُردوا من البلاد، أو بالتضييق عليهم حتى يخرجوا؛ لأن الإخراج من البلاد، إما أن يكون مباشرة بالطرد، وإما أن يكون بالتضييق عليه حتى يخرج. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي أي تحملوا الأذى والاضطهاد في سبيل الحق الذي آمنوا به وَقَاتَلُوا أعداء الله وَقُتِلُوا وهم يجاهدون من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. هؤلاء الذين فعلوا كل ذلك، وعدهم الله-تبارك وتعالى- بالأجر العظيم فقال:لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ : أي لأمحون عنهم ما ارتكبوه من سيئات، ولأسترنها عليهم حتى تعتبر نسيًا منسيًا . وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ :أي تجري من تحت قصورها الأنهار التي فيها العسل المصفَى، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.والجنة درجات : "أُصِيبَ حَارِثَةُ يَومَ بَدْرٍ وهو غُلَامٌ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، قدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي، فإنْ يَكُنْ في الجَنَّةِ أصْبِرْ وأَحْتَسِبْ، وإنْ تَكُ الأُخْرَى تَرَى ما أصْنَعُ، فَقَالَ: ويْحَكِ ، أوَهَبِلْتِ، أوَجَنَّةٌ واحِدَةٌ هي، إنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وإنَّه في جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ" الراوي : أنس بن مالك- صحيح البخاري "مَن آمَنَ باللَّهِ وبِرَسولِهِ، وأَقامَ الصَّلاةَ، وصامَ رَمَضانَ؛ كانَ حَقًّا علَى اللَّهِ أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جاهَدَ في سَبيلِ اللَّهِ أوْ جَلَسَ في أرْضِهِ الَّتي وُلِدَ فيها، فقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، أفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قالَ: إنَّ في الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، أعَدَّها اللَّهُ لِلْمُجاهِدِينَ في سَبيلِ اللَّهِ، ما بيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كما بيْنَ السَّماءِ والأرْضِ، فإذا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ؛ فإنَّه أوْسَطُ الجَنَّةِ وأَعْلَى الجَنَّةِ -أُراهُ- فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، ومِنْهُ تَفَجَّرُ أنْهارُ الجَنَّةِ."الراوي : أبو هريرة- صحيح البخاري. وفي هذا الحديثِ يُبيِّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن آمَن باللهِ تعالَى وأنَّه وَحْدَه المستحِقُّ بالعبادةِ، ولم يُشرِكْ بعِبادةِ ربِّه أحَدًا، وآمَنَ برَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إيمانًا صادقًا مِن قلْبِه، وأنَّه خاتمُ المرسَلينَ، ورسَولُ اللهِ إلى الخلْقِ كافَّةً، وأقام الصَّلواتِ الخمْسَ ، فأدَّاها بشُروطِها وأركانِها كما يَنْبغي، وصام شَهرَ رَمَضانَ إيمًانا واحتسابًا؛ استحَقَّ دُخولَ الجنَّةِ بفَضْلِ اللهِ ورَحمتِه، سَواءٌ جاهَدَ في سَبيلِ اللَّهِ إنِ استطاعَ، أوْ جَلَسَ في أرْضِهِ الَّتي وُلِدَ فيها ولم يُشارِكْ في الجِهادِ؛ لأنَّ كلَّ مُسلمٍ يُعامَلُ بحَسْبِ عَمَلِه كثيرًا كان أو قَليلًا، فالتَّفاوُتُ حاصلٌ في عمَلِ الدُّنيا، وكذلك حاصلٌ في دَرَجاتِ الجنَّاتِ في الآخرةِ. ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ: الثواب لا يكون إلا من عنده-تبارك وتعالى-، لكنه صرح به- سبحانه - تعظيمًا للثواب وتفخيمًا لشأنه. فهو سبحانه الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ: أي: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ عنده الجزاءُ الحسن لِمَن عمِلَ صالحًا، ممَّا لا عَينٌ رأتْ، ولا أُذنٌ سمِعَتْ، ولا خَطَر على قلبِ بشَرٍ.وأضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم ، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا . "قالَ اللَّهُ: أعْدَدْتُ لِعِبادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ علَى قَلْبِ بَشَرٍ."الراوي : أبو هريرة-صحيح البخاري . "قالَ اللَّهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولَا خَطَرَ علَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ "فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لهمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ"السجدة: 17."الراوي : أبو هريرة - صحيح البخاري . وقد ختم- سبحانه - الآية بهذه الجملة الكريمة لبيان اختصاصه بالثواب الحسن كأن كل جزاء للأعمال في الدنيا لا يُعَدّ حسنًا بجوار ما أعده- سبحانه - في الآخرة لعباده المتقين. "لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ"196.. قيل : الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة . وقيل :للجميع.تفسير القرطبي. لَمَّا وعَد اللهُ تعالى وبشر- سبحانه - عباده المؤمنين الصادقين بالثَّوابِ العظيم، وكانوا في الدُّنيا في نهاية الفقرِ والشِّدَّة، والكفَّارُ كانوا في النِّعم، ذكَر اللهُ تعالى في هذه الآيةِ ما يُسلِّيهم ويُصبِّرُهم على تلك الشِّدَّة وألا ينخدعوا بظاهرِ ما عليه الكفَّارُ من قوة وسطوة ومتاع دنيوي من تردُّدٍ على البلاد، وتنقُّلٍ فيها بأنواعِ التِّجاراتِ والمكاسبِ، بِما يجعلُهم في بَحبوحةٍ في العيش، وترَفٍ في الحياةِ، وعِزٍّ وغلبةٍ في بعضِ الأوقات. لَا يَغُرَّنَّكَ : إظهار الأمر المضر في صورة الأمر النافع، وهو مشتق من الغِرة بكسر الغين- وهي الغَفْلَة- ويقال: رجل غِر إذا كان ينخدع لمن خادعه. والتقلب في البلاد: التصرف فيها على جهة السيطرة والغلبة ونفوذ الإرادة. "مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ"197. . مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ :أي: إنَّهم مُنتقِلون بعدَ مماتِهم وذَهابِ مُتعِهم، إلى الإقامةِ في نارِ جَهنَّم. وَبِئْسَ الْمِهَادُ: أي: وبئس الفراشُ والمقرُّ هي، أي: جهنَّم.والمهد هو المكان الذي ينام فيه الطفل. ومعنى ذلك أنه يُقَلَّب فيهم في جهنم كما يشاء الله ويقدر، لأنه لا قدرة لهم على أي شيء، شأنهم في ذلك شأن الطفل، لايزال ملازمًا لفراشه ومَهْدِهِ حتى يُقلبه ويُحركه غيرُهُ. أي: إنَّ هذا الذي عليه الكفَّارُ من قوة وسطوة ومتاع دنيوي متاع قليل مؤقت قليل كمًّا وكيفًًا زائل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا، ويعذبون عليه أبدًا عذاب لا نهاية له . "لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَار" 198.. أما المتقون لربهم، المؤمنون به الذين امتَثلوا ما أمَر الله تعالى به، واجتَنبوا ما نهى عنه، - فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها،، فإنَّهم يُمتَّعون في الدارِ الآخِرةِ في جَنَّاتٍ تَجري من خلالها أنواعٌ من الأنهار، وهم ماكثونَ في هذا النَّعيمِ على الدَّوام.فلو قدر أنهم في دار الدنيا، قد حصل لهم أي بؤس وشدة، وعناء ومشقة، لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم في الآخرة، والسرور والحبور، والبهجة نزرًا يسيرًا، ومنحة في صورة محنة. دخلَ عمرُ بنُ الخطابِ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلمَ:وإنَّه- صلى الله عليه وسلم - لَعَلَى حَصِيرٍ ما بيْنَهُ وبيْنَهُ شَيءٌ، وتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِن أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وإنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أثَرَ الحَصِيرِ في جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، فَقالَ: ما يُبْكِيكَ؟ فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ كِسْرَى وقَيْصَرَ فِيما هُما فِيهِ، وأَنْتَ رَسولُ اللَّهِ!فَقالَ: أَمَا تَرْضَى أنْ تَكُونَ لهمُ الدُّنْيَا ولَنَا الآخِرَةُ."الراوي : عمر بن الخطاب- صحيح البخاري. نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ:والنُّزل: ما يُعد للنزيلِ والضيفِ لإكرامِهِ والحفاوةِ به مِنْ طَعامٍ وشرابٍ وغيرِهِمَا. أي: إنَّ الله تعالى قدْ أعدَّ لهم تلك الجنَّاتِ مَنزلَ ضِيافةٍ دائمًا مِن كرامةِ اللهِ تعالى لهم . أي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حالة، قدْ أعدَّ لهم سبحانه تلك الجنَّاتِ مَنزلَ ضِيافةٍ دائمًا على سبيل الإكرام لهم، والتشريف لمنزلتهم. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَار: أي: إنَّ ما عندَ اللهِ تعالى من النَّعيمِ المقيم خيٌر للطَّائعين المتقين - الذين أحْسَنوا العملَ- من متاعِ الدُّنيا القليلِ الزَّائل "وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 199" . لَمَّا حكَى اللهُ تعالى بعضَ مخالفاتِ أهلِ الكتابِ، مِن نبْذِ الميثاق وتَحريفِ الكتابِ وغيرِ ذلك، سِيقتْ هذه الآيةُ؛ لبيانِ أنَّ أهلَ الكتابِ ليس كلُّهم كمَن حُكيتْ مخالفاتُهم، بل منهم مَن له مَناقبُ جليلةٌ، مثل: عبد الله بن سَلَام وأصحابه.وقد بيَّن- سبحانه - هنا صفات الأخيار منهم: أي: "وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وهم اليهود والنصارى لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أي منهم من يؤمن إيمانًا حقًا مُنَزهًا عنِ الإشراكِ بكل مظاهره ويؤمن بما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من القرآن الكريم على لسان نبيكم محمد صلّى الله عليه وسلّم ويؤمن بحقيقة ما أُنزل إليهم من التوراة والإنجيل ولا يزالون مع هذا الإيمان العميق خَاشِعِينَ لِلَّهِ : أي خاضعين له- سبحانه - خائفين من عقابه، طالبين لرضاه، فهؤلاء الذين يؤمنون بما أَنْزَلَ اللهُ على رسولِهِ عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيمًا لله وذلًا له، لا طلبًا للدنيا، أو المدح أو ما أشبه ذلك لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا: والمراد بآيات الله هنا: الآيات الشرعية؛ أي: لا يُحرِّفون ما في كُتُبِهم، ولا يُبدِّلونه، ولا يَكتمون ما فيها من العِلم- ومِن ذلك البشارةُ بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبيانُ صِفتِه للناس-؛ ليَحْصُلوا في مُقابلِ ذلك على متاعٍ دُنيويٍّ زائل، مِن منصبٍ، أو جاهٍ، أو مالٍ، وغير ذلك من أعراض الدنيا الفانية وهو قليل زائل حتى ولو بلغ قناطير مقنطرة من الذهب والفضة؛ لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم"أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ:رِبَاطُ يَومٍ في سَبيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما عَلَيْهَا، ومَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ في سَبيلِ اللَّهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما عَلَيْهَا."الراوي : سهل بن سعد الساعدي- صحيح البخاري. وفي الحَديثِ:فَضلُ الرِّباطِ في سَبيلِ اللهِ. وفيه:بيانُ حَقارةِ الدُّنيا بالنِّسبةِ إلى الآخِرةِ. وهذه الصفات توجد في اليهود ، ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس . كان عبدُ اللهِ بنُ سلَامٍ رَضيَ اللهُ عنه مِن يَهودِ المدينةِ، وذلك قبْلَ مَبْعثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكان حَبْرًا عالِمًا مِن عُلماءِ اليهودِ ويَعلَمُ مِن التَّوراةِ صِفاتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأسلَمَ بعْدَ قُدومِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى المَدينةِ مُهاجِرًا، وأقامَ الحُجَّةَ على اليَهودِ بأنَّهم قَومٌ بُهتٌ، وشَهِد عليهم بذلك. " بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ فأتَاهُ، فَقالَ: إنِّي سَائِلُكَ عن ثَلَاثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إلَّا نَبِيٌّ؛ قالَ: ما أوَّلُ أشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وما أوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أهْلُ الجَنَّةِ؟ ومِنْ أيِّ شَيءٍ يَنْزِعُ الوَلَدُ إلى أبِيهِ؟ ومِنْ أيِّ شَيءٍ يَنْزِعُ إلى أخْوَالِهِ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خَبَّرَنِي بهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ، قالَ: فَقالَ عبدُ اللَّهِ: ذَاكَ عَدُوُّ اليَهُودِ مِنَ المَلَائِكَةِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:أمَّا أوَّلُ أشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إلى المَغْرِبِ، وأَمَّا أوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ، وأَمَّا الشَّبَهُ في الوَلَدِ: فإنَّ الرَّجُلَ إذَا غَشِيَ المَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كانَ الشَّبَهُ له، وإذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كانَ الشَّبَهُ لَهَا. قالَ: أشْهَدُ أنَّكَ رَسولُ اللَّهِ، ثُمَّ قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ ، إنْ عَلِمُوا بإسْلَامِي قَبْلَ أنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ اليَهُودُ، ودَخَلَ عبدُ اللَّهِ البَيْتَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ؟ قالوا: أعْلَمُنَا وابنُ أعْلَمِنَا، وأَخْيَرُنَا وابنُ أخْيَرِنَا، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:أفَرَأَيْتُمْ إنْ أسْلَمَ عبدُ اللَّهِ؟ قالوا: أعَاذَهُ اللَّهُ مِن ذلكَ، فَخَرَجَ عبدُ اللَّهِ إليهِم، فَقالَ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، فَقالوا: شَرُّنَا وابنُ شَرِّنَا، ووَقَعُوا فِيهِ" الراوي : أنس بن مالك- صحيح البخاري. وفي الحَديثِ: مِن عَلاماتِ نُبوَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إخبارُه عَن بَعضِ الأُمورِ الغَيبيَّةِ. وفيه:فَضيلةٌ ومَنقَبةٌ لعبْدِ اللهِ بنِ سلَامِ رَضيَ اللهُ عنه. وفيه:أنَّ اليهودَ أهلُ كَذِبٍ وفُجورٍ، يَقولونَ ويفتَروَن على غيرِهم ما ليسَ فيه.الدرر السنية. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق مثل أصحمة – النجاشي - ملك الحبشة وغيره كثير ،كما قال تعالى "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ"المائدة : 82 . . قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ"مَاتَ اليومَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا علَى أخِيكُمْ أصْحَمَةَ."الراوي : جابر بن عبد الله- صحيح البخاري " عن أُمِّ سَلَمةَ -في شَأْنِ هِجرَتِهم إلى بِلادِ النَّجاشيِّ، وقد مَرَّ بَعضُ ذلك- قالتْ:فلمَّا رأتْ قُرَيشٌ ذلك اجتَمَعوا على أنْ يُرسِلوا إليه، فبعَثوا عَمرَو بنَ العاصِ، وعَبدَ اللهِ بنَ أبي رَبيعةَ، فجمَعوا هَدايا له، ولبَطارِقَتِه، فقدِموا على الملِكِ، وقالوا: إنَّ فِتْيةً منَّا سُفَهاءَ فارَقوا دِينَنا، ولم يَدخُلوا في دِينِكَ، وجاؤوا بدِينٍ مُبتدَعٍ لا نَعرِفُه، ولجَؤوا إلى بِلادِكَ، فبعَثْنا إليك لتَرُدَّهم.فقالتْ بَطارِقَتُه: صدَقوا أيُّها الملِكُ. فغضِبَ، ثُمَّ قال: لا لعَمرُ اللهِ، لا أرُدُّهم إليهم حتى أُكلِّمَهم؛ قَومٌ لجَؤوا إلى بِلادي، واختاروا جِواري. فلمْ يَكُنْ شيءٌ أبغَضَ إلى عَمرٍو وابنِ أبي رَبيعةَ مِن أنْ يَسمَعَ الملِكُ كَلامَهم، فلمَّا جاءهم رسولُ النَّجاشيِّ، اجتمَعَ القَومُ، وكان الذي يُكلِّمُه جَعفَرُ بنُ أبي طالبٍ، فقال النَّجاشيُّ: ما هذا الدِّينُ؟ قالوا:أيُّها الملِكُ، كنَّا قَومًا على الشِّركِ؛ نَعبُدُ الأوْثانَ، ونَأكُلُ المَيْتةَ، ونُسيءُ الجِوارَ، ونَستحِلُّ المَحارمَ والدِّماءَ، فبعَثَ اللهُ إلينا نَبيًّا مِن أنفُسِنا، نَعرِفُ وَفاءَه وصِدقَه وأمانَتَه، فدَعانا إلى أنْ نَعبُدَ اللهَ وَحدَه، ونَصِلَ الرَّحِمَ، ونُحسِنَ الجِوارَ، ونُصلِّيَ، ونَصومَ.قال: فهل معكم شيءٌ ممَّا جاء به؟ -وقد دَعا أساقِفَتَه، فأمَرَهم، فنشَروا المَصاحفَ حَولَه- فقال لهم جَعفَرٌ: نعمْ، فقرَأ عليهم صَدرًا مِن سورةِ "كهيعص".فبَكى -واللهِ- النَّجاشيُّ، حتى أخضَلَ لِحيَتَه، وبكَتْ أساقِفَتُه حتى أخضَلوا مَصاحفَهم، ثُمَّ قال: إنَّ هذا الكَلامَ ليَخرُجُ مِن المِشكاةِ التي جاء بها موسى، انطَلِقوا راشدينَ، لا واللهِ، لا أرُدُّهم عليكم، ولا أنعَمُكم عَينًا. فخرَجا مِن عندِه، فقال عَمرٌو: لآتيَنَّه غَدًا بما أستأصِلُ به خَضراءَهم، فذكَرَ له ما يقولونَ في عيسى."الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن - المحدث : شعيب الأرناؤوط - المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء -الصفحة أو الرقم : 1/216 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. فقال عمْرُو: لآتِيَنَّهُ غدًا بما أستأصِلُ به خَضْراءَهُم"، يَتوعَّدُهُم عمْرٌو أنْ يَتكلَّمَ مع النَّجاشيِّ مرَّةً أُخرى؛ لِيُساوِمَهُ فيهم، "فذكَرَ له ما يَقولونَ في عيسى"، فحاوَلَ أنْ يُوقِعَ بيْنَهم وبيْنَ النَّجاشيِّ في أمْرِ عيسى ابنِ مَريَمَ، وذلِكَ أنَّ النَّصارى يَعبُدونَ عيسى ابنَ مَريَمَ عليه السَّلامِ. وفي روايةِ أحمَدَ فسَأَلَهم النَّجاشيُّ "ما تَقولونَ في عيسى ابنِ مَريَمَ؟ فقالَ له جَعفَرٌ:نقولُ فيه الَّذي جاءَ به نبيُّنا، هو عبدُ اللهِ ورسولُهُ ورُوحُهُ وكَلِمَتُهُ ألْقاها إلى مَريَمَ العَذْراءِ البَتولِ، فصَدَّقَهم بما قالوا، وقالَ لهم "اذْهَبوا فأنتُم سُيومٌ بأرْضي" والسُّيوم بلُغةِ الحَبشةِ: الآمِنونَ، "مَن سبَّكَم غُرِّمَ"، بمَعْنى: مَن وقَعَ فيكم بالسِّبابِ حاكَمَهُ النَّجاشيُّ، فمِثلُ هذا باعِثٌ لهم على الاطمِئْنانِ؛ لأنَّ السِّبابَ هو أقَلُّ الأذَى الَّذي قد يقَعُ للغُرَباءِ، "فما أُحِبُّ أنَّ لي دَبْرًا ذَهَبًا، وإنِّي آذَيتُ رَجُلًا منكم"، والدَّبْرُ بلِسانِ الحَبَشةِ: الجَبَلُ، وقد رَدُّوا على قُرَيشٍ هَداياها كما جاءَ في الرِّواياتِ .الدرر السنية. أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ :أولئك التي هذه أوصافهم الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلًا عن طاعة الله والإيمان به ؛ لَهُمْ أَجْرُهُمْ: أي: ثواب، وإضافته إلى الله "عِندَ رَبِّهِمْ" يدل على عِظَمِهِ وأنه عظيم جدًا، فإن الشيء من العظيم عظيم، ومن الكريم كثير،و فيه إشارة أنه باق؛ لأن ما عند الله يبقى، "مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ "النحل : 96. ولهذا يخلد أهل الجنة فيها أبدًا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ: السرعة: عدم التباطؤ في الشيء، فالله تعالى سريع الحساب من وجهين: الوجه الأول: أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة، فاليوم الجمعة مثلا، أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيئًا قليلا حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت، فيجد الحساب أمامه، فهذه سرعة. والسرعة الثانية: يوم القيامة فإن الله تعالى يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم؛ لقوله تعالى "أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا "الفرقان: ٢٤.والقيلولة إنما تكون في نصف النهار، ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم حتى إن كل واحد منهم يقيل في منزله ومستقره.تفسير الشيخ العثيمين. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" 200. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : نستشهد بقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه"إذا سمعت الله يقول:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فأرعها سمعك -يعني استمع لها- فإما خيرًا تُؤمر به، وإما شرًا تُنهى عنه".وقلنا:إن الله تعالى إذا صدَّرَ الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به.ووجهه:أنه صدَّره النداءَ الذي يفيدُ تنبيه المخاطب. ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلا على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان؛ لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدر الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان. فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا وكذا، أو:لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا. تفسير الشيخ العثيمين. اصْبِرُوا: على كل ما يحتاج إلى صبر، ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس؛ فالذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر؛ لأنه يشق عليك تَحَمّله، فطاعة الله عز وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليها، والمعاصي ثقيل تركها على النفوس فاصبر على الترك، والآلام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس فاصبر عليها.فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب، إذا صبر الإنسان ظفر، ولاسيما إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عز وجل، إذا صبر الإنسان ظفر، ولاسيما إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عز وجل،كانت العاقبة الحميدة، كانت مع التكفير زيادة حسنات.وَصَابِرُوا:المصابرة أن يجاهد المسلم نفسه مجاهدة لا تنقطع، حتى يحقق المجاهد رضا ربه عنه، بفعل الطاعة وترك المعصية، ذاكرًا قول الله تعالى " وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ" الحجر: 99. وبمغالبة أَعداءَ الدِّين بالصبرِ ، حتى تَنتصِروا عليهم؛ فلا يكونوا أصْبرَ منكم. المصابرة تكون من اثنين،"الصبر الأول"لا أحد يضادك في الشيء إنما هو شيء بينك وبين نفسك تصبر. "الصبر الثاني" إنسان يضادك ويثيرك ويعتدي عليك فصابره .. بمعنى غالبه بالصبر، وهذا يكون في ملاقاة الأعداء. فالعدو يصابرك وأنت تصابره، ولكن الله تعالى قد سلى عباده المؤمنين في قوله تعالى" وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا "النساء – 104. أنت إذا جرحت تتألم وهو إذا جرح يتألم بلا شك، " وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ "النساء: ١٠٤.فرق عظيم، فالذي يرجو من الله عز وجل هذا الثواب على ما حصل له يهون عليه هذا الشيء، حتى إنه أحيانا لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عز وجل.تفسير العثيمين. وَرَابِطُوا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ : المرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لئلا يدخل منه الهوى والشيطان . فيزيله عن مملكته. فالمرابطة: أخص المصابرة، يعني رابطوا على الطاعات، ومن ذلك ما بيَّنَهُ النبيُّ عليه الصلاة والسلام حيثُ قالَ "أَلا أدُلُّكُمْ علَى ما يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا، ويَرْفَعُ به الدَّرَجاتِ؟ قالُوا بَلَى يا رَسولَ اللهِ، قالَ: إسْباغُ الوُضُوءِ علَى المَكارِهِ، وكَثْرَةُ الخُطا إلى المَساجِدِ، وانْتِظارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّباطُ"الراوي : أبو هريرة - صحيح مسلم. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني: في أيام البرودة، فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوء، يعني: أتمه وأكمله دل هذا على إيمانه بالله عز وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله. فالمرابطة، هي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة، فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى، فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها فقال: وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "آل عمران: 200. تم بفضل الله الانتهاء من تفسير سورة آل عمران اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا التفسير مجمع من كتب التفسير وأقوال العلماء وحاولنا قدر المستطاع الإحالة لكن لتصرفنا أحيانا بالتخريج أو الاختصار غير المخل فالإحالة إجمالية قدر الطوق وأستغفر الله من أي خطأ أو سهو
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
فهرس تفسير سورة آل عمران على مدونة منبر الدعوة 03- تفسير سورة آل عمران من آية93 إلى آية 132 04- تفسير سورة آل عمران من آية 133 إلى آية 170 05- تفسير سورة آل عمران 171 : 179 06= تفسير سورة آل عمرانمن آية 180 إلى187 07- تفسير آل عمران من آية 188 إلى آية 200 فوائد سورة آل عمران من ١ -٩ هنا _______________________ فوائد سورة آل عمران من ١٠ -١٧ هنا _________________ فوائد سورة آل عمران من ١٨ -٢٥ هنا _________________ فوائد سورة آل عمران من ٢٦ -٣٢ هنا ______________ فوائد سورة آل عمران من ٣٣ -٣٨ هنا ____________________ فوائد سورة آل عمران من ٣٩ -٤٧ هنا _______________ فوائد سورة آل عمران من ٤٨ -٥١ هنا ______________________ فوائد سورة آل عمران من ٥٢ -٥٨ هنا ____________________ فوائد سورة آل عمران من ٥٩ -٦٨ هنا _________________ فوائد سورة آل عمران من ٦٩ -٧٤ هنا _________________ فوائد سورة آل عمران من ٧٥ -٨٠ هنا ___________________ فوائد سورة آل عمران من ٨١ -٩١ هنا __________________ فوائد سورة آل عمران من ٩٢ -٩٥ هنا _______________________ فوائد سورة آل عمران من ٩٦ -١٠١ هنا ________________________ فوائد سورة آل عمران من ١٠٢ - ١١٠ هنا ____________________ علي الزهراني فوائد سورة آل عمران من ١١١ - ١١٧ _____________________ فوائد سورة آل عمران من ١١٨ - ١٢٩ هنا للدكتور علي الزهراني حفظه آلله. ______________________ فوائد سورة آل عمران من ١١١ - ١١٧ هنا __________________ فوائد سورة آل عمران من ١١٨ - ١٢٩ هنا ______________________ فوائد سورة آل عمران من ١٣٠ - ١٤٨ هنا ________________ فوائد سورة آل عمران من ١٤٩ - ١٥٥ هنا _______________ فوائد سورة آل عمران من ١٥٦ - ١٦٨ هنا ________________ فوائد سورة آل عمران من ١٦٩ - ١٨٠ هنا ___________________________ فوائد سورة آل عمران من ١٨١ - ١٨٨ هنا _____________________ فوائد سورة آل عمران من ١٨٩ - ١٩٥ هنا ____________ فوائد سورة آل عمران من ١٩٦ - ٢٠٠ هنا
__________________
|
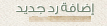 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 06:44 AM





 العرض المتطور
العرض المتطور
